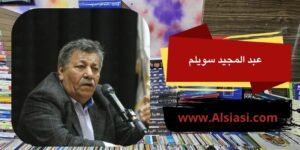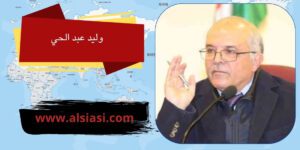بينما تُعد المياه موردًا أساسيًا لحياة الإنسان وتنميته، تحوّلت في الضفة الغربية المحتلة إلى أداة استعمارية في يد الاحتلال الإسرائيلي، يُحكم من خلالها الخناق على الفلسطينيين، ويُعزّز بها وجود المستوطنات، ويُدفع سكان القرى والهضاب نحو الرحيل القسري.
السيطرة على الأحواض والآبار
تضم الضفة الغربية ثلاثة أحواض مائية رئيسية: الحوض الشرقي، الحوض الغربي، والحوض الشمالي. رغم أن معظمها يقع ضمن الأراضي الفلسطينية، إلا أن إسرائيل تسيطر فعليًا على أكثر من 85% من المياه الجوفية فيها، وتفرض على الفلسطينيين استخدام كميات ضئيلة ضمن نظام تصاريح بيروقراطي ومعقّد.
وفي الوقت الذي تمنع فيه سلطات الاحتلال الفلسطينيين من حفر آبار جديدة أو ترميم القديمة، تقوم بتدمير ما تبقى من الآبار بحجة “عدم الترخيص”، كما في الأغوار الشمالية وقرى الخليل وبيت لحم، في حين يُسمح للمستوطنين بحفر آبار عميقة واستخدام المياه بلا قيود.
“ميكوروت”: تحكم في التوزيع والاحتكار
شركة “ميكوروت” الإسرائيلية، المزود الرئيسي للمياه، تهيمن على توزيع المياه في الضفة الغربية، وتفرض على الفلسطينيين شراء المياه التي يُفترض أن تكون لهم، فيما تُزوَّد المستوطنات بكميات تفوق الحاجة، تُستخدم لري الحدائق والمزارع، ويحصل المستوطن على ما يعادل 3 إلى 5 أضعاف كمية المياه التي تُمنح للفلسطيني في نفس المنطقة.
لماذا هذه السيطرة؟
خدمة المشروع الاستيطاني: لا يمكن للمستوطنات أن تزدهر دون مياه وفيرة، لذلك تُحوَّل مصادر المياه الأساسية من القرى الفلسطينية نحو هذه البؤر غير الشرعية.
أداة سياسية: تُستخدم المياه كوسيلة ضغط، ويمكن قطعها أو تقييدها لإجبار القرى على التعاون أو التنازل.
إفراغ الأرض: حرمان المجتمعات الريفية من المياه يخلق بيئة طاردة للسكان، وهو شكل من أشكال التهجير القسري غير المباشر.
النتائج على الفلسطينيين
1. أزمة إنسانية ومعيشية
العديد من القرى الفلسطينية تحصل على كميات أقل من الحد الأدنى العالمي للمياه (100 لتر يوميًا للفرد)، وتُضطر للعيش على 40-75 لترًا، ما يؤثر على النظافة والصحة والكرامة.
2. شلل الزراعة وتضييق سبل العيش
الزراعة الفلسطينية تضررت بشكل بالغ بسبب نقص المياه، ما أدى إلى فقدان آلاف الأسر مصادر رزقها، وتراجع الإنتاج الغذائي المحلي.
3. التهجير القسري “الصامت”
معظم المناطق المتضررة من شح المياه هي تلك المصنفة “ج”، التي تستهدف إسرائيل تفريغها لصالح التوسع الاستيطاني، مثل الأغوار وجنوب الخليل.
4. أضرار صحية وبيئية
غياب المياه الكافية والنظيفة أدى إلى انتشار الأمراض الجلدية والمعوية في بعض القرى، وخصوصًا بين الأطفال.
5. تبعية قسرية للاحتلال
الحرمان من بناء بنية تحتية فلسطينية مستقلة للمياه يجعل القرى والبلدات رهينة لشركة إسرائيلية احتكارية.
سُبل التصدي والسيادة المائية
1. التوثيق والملاحقة القانونية
يجب على المؤسسات الفلسطينية أن تُوثق هذه الانتهاكات وتُلاحق إسرائيل دوليًا باعتبارها تنهب موردًا مشتركًا تحت الاحتلال، في انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة.
2. المقاومة الشعبية والمقاطعة
تنظيم حملات لمقاطعة شركة “ميكوروت”، وفضح التمييز المائي في المحافل الدولية، وتفعيل المقاومة الشعبية في مواقع الآبار المصادرة.
3. الابتكار والاعتماد الذاتي
تشجيع المجتمعات على استخدام تقنيات تجميع مياه الأمطار، وإعادة تدوير المياه الرمادية، والزراعة منخفضة الاستهلاك المائي.
4. الدبلوماسية والإعلام
خلق ضغط دولي عبر حملات إعلامية وحقوقية تُبرز التمييز المائي كأحد أوجه الفصل العنصري الإسرائيلي.
5. دعم القرى وتعزيز الصمود
تمويل مشاريع المياه في القرى المهمشة، وتقديم الدعم القانوني والفني لها، يُسهم في منع التهجير وبقاء الناس على أرضهم.
خلاصة
المياه ليست فقط مادة حياة، بل أصبحت في الضفة الغربية أداة احتلال وسيطرة واستيطان. ما يحدث ليس نقصًا طبيعيًا، بل حصار مائي ممنهج، يعكس طبيعة المشروع الاستيطاني الإسرائيلي الذي لا يكتفي بالأرض، بل يطارد الفلسطيني حتى في شربة الماء. ومع أن المعركة تبدو غير متكافئة، فإن الصمود، والتوثيق، والعمل الشعبي والدولي، قادرة على كسر هذا الحصار وتحقيق السيادة المائية الفلسطينية.