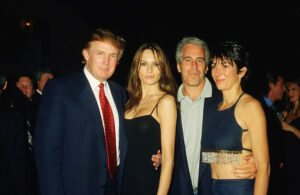حين يُدق ناقوس الخطر، وتتقد جمرات الغزو على تخوم الوطن، تنهض الشعوب من سباتها المزمن، وتُلملم أشلاءها المتناثرة، وتُعيد ترتيب أولوياتها في مشهد ملحمي نادر. فالغزو الخارجي، بما يمثله من تهديد وجودي، يمتلك تلك القدرة الغامضة على التوحيد؛ إذ يستفزّ أعمق مشاعر الانتماء، ويدفع المكونات الاجتماعية والسياسية المتباينة إلى التماهي في كيان وطني واحد. في لحظة الخطر، تُنسى الأيديولوجيات، وتخبو العصبيات، وتنهار حدود الهويات الفرعية لصالح الهوية الوطنية الكبرى، ويغدو الوطن هو “الأنا” العليا التي تذوب فيها كل “أنا” جزئية.
ذلك هو العنف الوطني التحرّري: عنفٌ له ملامح القداسة، وإن كان يحمل في طياته وجهاً دموياً. هو عنف يولد من رحم التحدي الوجودي، لا من عبثية المصالح الضيقة؛ عنف يجمع ولا يفرّق، يبني ولا يهدم، يؤسس ولا يفكك. إنه “العنف المُوَحِّد”، كما يمكن أن نطلق عليه، لأنه يستنفر الطاقات الكامنة، ويعيد تعريف العلاقة بين الشعب والدولة على أساس من التضامن والكرامة.
أما الوجه الآخر للعنف، ذاك الذي يُفجَّر من الداخل، لا من الخارج، فهو نقيض في الروح والوظيفة، وإن كان مشابهاً له في الأدوات والأسلحة. إنه العنف الأهلي الحزبي والطائفي، الذي يُحوّل الوطن إلى ساحة تصفية حسابات، ويُعيد تعريف “العدو” من الغريب إلى القريب. هنا لا تُوجّه البنادق إلى المستعمر، بل إلى الأخ والشريك في الجغرافيا والمصير. وهنا تنفرط عُرى الجماعة الوطنية، وتنقلب الخنادق من جبهات تحرر إلى مقابر جماعية، وتتحول الهويات الجزئية إلى وحوش مفترسة تنهش الجسد المشترك.
في الحالة الأولى، تُولد الأمم. في الثانية، تُولد المقابر.
في الحالة الأولى، تُضاء جذوة المعنى، وتُعاد صياغة التاريخ بهامات عالية ودماءٍ زكية تُعبّد طريق السيادة. أما في الحالة الثانية، فتمسي السيادة سُبة، وتغدو الوطنية غطاءً زائفاً يُخفي وحشية الغرائز القبلية والمذهبية الموروثة.
إنه الفرق الجوهري بين معركة تُخاض من أجل وطن، وحربٍ تُخاض ضده. بين عنفٍ يوقظ الحلم، وآخر يوقظ الوحش.
لقد أشار المفكر الفرنسي فرانز فانون إلى أن العنف قد يكون أحيانًا الطريق الوحيد لنيل الكرامة حين يكون الاستعمار قد صادر كل إمكانيات التعبير الإنساني السلمي. لكن فانون نفسه كان يُدرك أن هذا العنف لا يجوز أن يُمارَس داخلياً على الذات الجماعية، لأنّ عنف الداخل، خلافاً لعنف التحرر، لا يُعيد تشكيل الإنسان بل يُعيده إلى بدائيّته وغرائزيّته.
فالعنف في سياق التحرير هو فعل وجودي وتاريخي، بينما العنف في سياق الاحتراب الأهلي هو فعل نكوصي وانتحاري. في الأول تنفتح آفاق المستقبل، وفي الثاني ينغلق الحاضر على رعب مقيم لا مخرج منه.
ولعلّ التجربة اللبنانية، والعراقية، والسورية، وحتى الليبية، تقدم نماذج صارخة على كيف ينقلب الشعب الواحد إلى قبائل متناحرة إذا ما تمّت تعبئة الفضاء العام بالعصبيات الطائفية والمذهبية، لا بالمشروع الوطني الجامع. هنا يُستبدل منطق “نحن ضد العدو” بمنطق “كل طائفة ضد الأخرى”، فيصبح العنف حلاً أولاً لا اضطراراً، وتُستباح حياة البشر لمجرد اختلاف الاسم أو الانتماء.
ولذلك، فإن التمييز الفلسفي بين العنف المشروع والعنف المجنون لا بد أن يُعاد التأكيد عليه في الفكر السياسي العربي. لأن تحوُّل العنف إلى أداة دائمة للحسم الداخلي يُفقد الدولة مشروعيتها الأخلاقية، ويُفكك المجتمع من داخله، حتى ولو ظلت مظاهره الشكلية قائمة.
إن اللحظة التي يتوقف فيها العنف عن كونه دفاعاً عن الوطن ويصبح وسيلة للسيطرة على أبناء الوطن هي اللحظة التي يُعلن فيها العقل الجمعي إفلاسه، وتفقد الدولة معناها، ويبدأ الوطن بالاحتضار البطيء.
خاتمة
الوطن لا يُبنى بالدم فقط، بل بالمعنى الذي يُعطى لهذا الدم. فإن كان الدمُ مسفوكًا في سبيل الكرامة والتحرر، صار محرّكًا لتاريخ جديد، وأما إذا سُفك في مذابح الداخل وغرف الصراع الطائفي والحزبي، صار لعنة تاريخية تحلُّ بالأرض والذاكرة معاً.
فلنُحسن، إذاً، التفريق بين رصاصٍ يُطلق على العدو، وآخر يُصوَّب إلى الصدر المشترك… ففي هذا التمييز مصيرُ وطن.