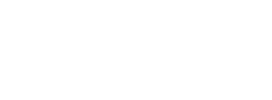يكاد المسْح القيمي العالمي، قروناً طويلة، يُجِمع على أنّ الحرم الجامعي أسّس حُرْمَتَه على مبدأ شامل يخترق كلّ الحقب وكلّ الأنظمة، مؤدّاه الحفاظ على استقلالية الجامعة عن السلطة، أمنية كانت أو سياسية أو حتّى دينية. ولعلّ قيمة القيم منع السلطة الزمنية، ممثّلة في الشرطة أساساً، عن تجاوز حدود هذا الحرم، والتزامها باحترام كيانه، باعتباره جزءاً من تطوّر الكائن العاقل، وتطوّر المجتمع الذي تكرّست عقلانيّته من خلال مبادئ الديمقراطية.
في السياق الأميركي الحالي، المتفاعل مع ما يجري في غزّة، يبدو الحرم الديمقراطي، وتفرّعاته الجامعية، عرضة للترنّح والتشكيك، ولا تجد معاينةٌ مثل هاته مبرّراتها في حجم الاعتقالات والتعامل العنيف مع الطلبة فقط، بل تتجاوزهما إلى محاولة تغيير وظيفة الجامعة وتحريف تمثّل وظيفتها الحضارية، إرضاءً لنزعة تأييد حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل.
فقد تداولت منابر الإعلام، بكلّ أصنافها (حتى الأحد الماضي)، أحداث اعتقال نحو مائتي متظاهر مؤيّد للفلسطينيين في ثلاث جامعات أميركية، خلال عملية إخلاء نفّذتها شرطة مكافحة الشغب، في أحدث حلقةٍ من حركة طلابية تتّسع رقعتها يوماً بعد يوم في أنحاء الولايات المتّحدة، وهي الحركة التي انطلقت قبل عشرة أيام من جامعة كولومبيا في نيويورك، وامتدّت لتشمل عدة مؤسّسات، من كاليفورنيا إلى نيو أنغلاند، مروراً بجنوب البلاد ووسطها. وقد شملت هذه الحركة المناهضة للحرب في غزّة جامعات ذات وزن دولي وأكاديمي رفيع، من هارفارد وييل إلى بوسطن، مروراً بجامعة برينستون. بل إنّ المعاينة الحقيقية هي في مغزى هاته الحركية التي جعلت الفضاءات الجامعية الغربية محطّ مقارباتٍ متنوّعةٍ وقراءاتٍ لا تخلو من بعد تاريخي. ففي وصف هاته الموجة، تشابهت التقديرات بخصوص عنفوانها، في حين اختلفت تقديرات أوصافها، فقد رأى أستاذ العلوم السياسية جيروم فيالا غودفراي، المتخصّص في الجامعة الأميركية، في احتجاجات الطلبة “حركة جد قوية مناهضة للاستعمار”، في حين رأى فيها الباحث المتخصّص في قضايا الإسلام السياسي في الشرق الأوسط جيل كيبل “مجالَ التعبير المفضّل لدى من يسعون إلى مواجهة بين الجنوب الشامل والشمال المُتّهم بكلّ الشرور”. في حين سعت الأوساط الصهيونية، والمؤيّدة لليمين الاستعماري، إلى تسويق أفكار نيّئة تضجّ عجزاً أخلاقياً، حين رمتها (الاحتجاجات) بالإرهاب والتطرّف ومعاداة السامية (!)
في الواقع، يغرينا ما يحصل في الجامعة، بوصفها واحدة من تفرّعات الحضارة الحديثة، للعودة إلى بداية تشكّل جوهرها، كما تحدّد في عقل أحد كبار الفلاسفة الإنسانيين؛ إيمانويل كانط، الذي شدّد في آخر كتاب نُشِرَ له وهو على قيد الحياة، على الهوية التأسيسيّة للجامعة “باعتبارها المكان الذي تقال فيه الحقيقة” (“دول الصدمة”، برنارد ستريغلر، 2012). إنّ الجامعة، بهذا المعنى الكانطي، هي المؤسّسة التي بمقدورها وحدها أنّ “تتحمّل مسؤولية الحقيقة”، وفي مقاربتها اليوم، في “عالم بلا خرائط” أخلاقية، تمثّل نوعاً من الإرث الميتافيزيقي الذي دفع باتجاه أن تكون مؤسّسةً للعقل إن لمْ ترقَ لأن تكون فكرة عن العقل نفسه. وقد اختلفت معارك الجامعات للدفاع عن هاته الهوية المتعالية النبيلة، وتحضر هنا من تاريخ الحركة الاحتجاجية الطلابية الأميركية، نزعتها الاحتجاجية ضدّ مصادر التمويل المشبوهة التي تُرخي بقوانينها على سير الجامعة منذ السبعينيات، كما رفع الطلاب راية العصيان ضدّ الحرب أو أيديولوجيا تمجيدها. وإذا كانوا في فترات الحرب على فيتنام ثوّاراً طلبة، أيّ أنّ انتقادهم اليساري سابق على وضعهم طلبةً، فإنّهم اليوم طلبةً ثوّاراً، أي أنّ وضعهم الاعتباري الطلابي سابق على وضعهم الثوريّ. ونجد أنّ أحد معاقل التمرّد الطلابي الحالي، جامعة كاليفورنيا، كانت الفضاء الأول لإرهاصات العصيان في الستينيات ضدّ الأخلاق البرجوازية، في حين تتأسّس هوية الطلبة اليوم من منطلق الأخلاق الإنسانية المناهضة للتقتيل المتوحّش، وما يسانده من خطابات متعالية وعنصرية.
ومنذ تصاعد النزعة المعارضة للحرب في فيتنام، لم تصل حرارة التمرّد لهاته الدرجة من العنفوان والمواجهة مع نظام الضبط الأمني، وكان تجنيد الشباب عنصراً مهمّاً في تحريك الغضب خلال حرب فيتنام (قيل إنّها “بلا راية ولا حماسة”)، والطلبة حالياً، كما كان حال أجدادهم في المدرّجات في ما مضى، يرون أنّ مساندة أميركا لحرب غزّة وتمويلاتها لـ”الحرب القذرة” لا تبررهما أيُّ ضرورة وطنية، كما لم يستسغ الطلبة المبرّرات التي قُدّمت في مساندة الحربيْن. لقد تابعنا في التاريخ الحديث محطّاتٍ عدّة من صمود الجامعة ومحاربتها للهيمنة عليها. ومن خلال ذلك، عشنا لحظات التوتّر والنزاع بين السلطة السياسية من جهة، والجامعة ورجالاتها، الذين ظلوا يطالبون بالاستقلالية والحرية في التعبير، من جهة أخرى، سواء كان الطرف المقابل لهم كنيسة أو دولة أو رأسمالاً.
وبالعودة إلى كانط، نجد أنّ هذا المَنْحى التكويني قد بدأ عنده في اللحظة التي كانت الجامعة تأخذ شكلها المعاصر، ولذلك خصّص رسالة شهيرة قدّم فيها كتابه “نزاع الكليات”، تضمّنت موقفه من الرقابة التي مورست ضدّ الجامعة من السلطة الملكية، ممثّلة في غليوم الثاني (1941)، ومنها نستشفّ أنّ هويّة الجامعة لا يمكن أن تتأسّس إلا إذا أدرجت علاقة السلطة بالمعرفة في تفكيرها النقدي المُتسائِل.
ما تشهده القيمُ انتكاسة، إذ تسعى الإرادة السياسية إلى تكييف الروح الجامعية مع السرديات القاتلة، ولعلّ التخوّفات التي سادت بخصوص ابتلاع السوق لروح المعرفة في الحرم الجامعي قد توارت، ليحلّ محلّها الخوف من أن تفقد الجامعة روحها كلياً. وتفقد قدسيّة حرمها الديمقراطي ونموذجيّته، من خلال تساؤل قطاعات الرأي العام العلمي: إذا كانت أميركا فعلت هذا، فماذا تركت للدول الثيوقراطية، ومنها بعض الدول العربية؟ والواضح المؤلم للغاية أن يُحرم شباب العالم، اليوم وغداً، من أفق علمي يمكن أن يكون لهم حلماً لصناعة نموذج مستقبلي، بعد أن شهدوا كيف أنّه لم يعد من اشتراطات العلم أن تفهم الجامعة والعالمَ، وتساعدنا على فهمهما، بل تتولّى مهام فهم العالم شبكاتُ دعم الكيانات القاتلة، دعمٌ قد يأتي من البنتاغون، كما قد يأتي من الشرطة الفدرالية.
في موازاة قتل الأطفال والعزّل في غزّة يجري قتل تلك الروح، التي لطالما مجّدتها الحضارة الغربية في طلابها، من ناحية تمثّلهم مهام الجامعة العالية والعليا؛ تطوير الروح النقدية والفضول والعمل الجماعي، وتطوير الحاسة الذاتية نحو التمرّد. ومن ذلك أيضاً، إزاحة الجامعة عن دورها المركزي، الذي شيّدته طوال القرون الثمانية الماضية، وهو واجب تعريف الإنسان نفسَه وتحديد مجالات وجودِه الحُرّ، والدفع به عُنوة، وباستعمال السلطة، نحو الانغلاق داخل مواقع توليتارية (شمولية)، دينية وأيديولوجية، تحثّ الطالب على استهلاك السردية التي تصنعها “فوكس نيوز” و”سي أن أن” أو تطوّرها مراكز الضغط، كما يجسّدها المُركّب العسكري الديني الصناعي في المؤسّسات الحاكمة.
ينمو خوف حقيقي داخل العقول النيّرة والمستقلة من أن تنسى أميركا المبادئ التي بنتها أمّةً حرّةً، ودافعت عنها، فتتحوّل بذلك الجامعة من فضاء له الأهلية العلمية والمهارة التاريخية في التقاط معنى الحدث الذي يطبع المرحلة التي تعيشها البشرية في الشرق الأوسط وفي العالم، إلى مُجمَّع مغلق وبرج من عاج. في زمنٍ ما، كنّا نتابع بغير قليل من الانبهار الدفاع الغربي المحموم عن “الوظيفة الطوباوية للجامعة”، على حدّ تعبير فرانسين دو ميشيل، تلك الطوباوية التي ”لا تسمح ببناء متعالٍ للمستقبل فقط، بل تتيح كذلك التفكير الفعلي في الحاضر، في تعلّقه القوي بالحياة الحقيقية” من جهة البحث عن المعنى الذي تقدّمه الجامعة لهذا العالم. واليوم صرنا، رغم أوضاعنا العربية المُخجلة، ننظر بتجهّم فكري وفزعٍ جسديٍ إلى تهمة “جريمة التفكير”، كما يحدّد صكوكَها بنيامين نتنياهو، وكما سبق للنظام الياباني الفاشي أن تعقّب بها من عارضوا حربه الانتحارية.
استهداف الحرم الجامعي، الذي شكّل معقلَ العقلِ والفِكْرِ، في تجلّياتهما الأكثر حُرّية وجُرأة، هو رديف لاستهداف آخر تدفع ثمَنَه الديمقراطيةُ، عندما تكون في غير مصالح الـ”لوبيات” التحريفيّة الجديدة.