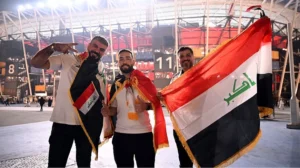في ظل ما يعيشه الشعب الفلسطيني من تحدياتٍ وجودية متواصلة، يبرز السؤال الجوهري: هل يكفي البقاء على الأرض لنقول إننا صامدون؟
في مواجهة الاحتلال الذي يمارس سياسات الابادة الجماعية والتطهير الغرقي والضمّ والتهويد والاستيطان والحصار وتقطيع أوصال الأرض والنسيج الاجتماعي، يقف الفلسطينيون أمام خيارين متناقضين: الصمود الواعي الذي يحافظ على الكرامة والهوية عبر مقاومة منظّمة، أو الخنوع والتكيّف الذي يقدّم البقاء المادي على حساب الحقوق والوعي التاريخي. فالبقاء دون مشروع وطني واضح وعمود سياسي واجتماعي متين لا يكفي، بل يتحوّل إلى استمرارٍ في حالة من التآكل الداخلي.
الحقيقة أن البقاء، رغم ضرورته، لا يشكّل صمودًا فعّالًا ما لم يكن مصحوبًا برؤية وطنية شاملة ومشروع متكامل يربط الكرامة بالعمل والتنظيم والقدرة على المواجهة. فالصمود لا يُقاس بالبقاء الجسدي فقط، بل بمدى الحفاظ على الهوية الوطنية والكرامة الإنسانية، وبالقدرة على تحويل المعاناة إلى فعل منظم ومثمر.
إن البقاء على الأرض يجب أن يشكّل قاعدةً لمشروع وطنيٍّ جامعٍ يقوم على قيادة موحّدة، وأدوات مقاومة متنوعة، وصمود اقتصادي واجتماعي متين، إلى جانب حماية الرواية الفلسطينية في مواجهة محاولات الطمس والتزييف. فالتاريخ يعلّمنا أن الشعوب التي نجحت في تحويل ألمها إلى وعي وتنظيم وسردية موحدة كانت الأقدر على انتزاع حقوقها أو تضييق مساحة الاحتلال والهيمنة عليها. أما الاكتفاء بالبقاء دون رؤية، فيحوّل الصمود إلى حالة من الجمود تُستنزف فيها الحقوق والموارد والوعي.
لقد أثبتت تجارب الشعوب عبر التاريخ أن الصمود الفعّال يحتاج إلى تنظيمٍ داخليٍّ وتحالفاتٍ متينةٍ واستراتيجية متكاملة، لا إلى ردود فعل عاطفية متفرقة. ففي بولندا، شكّلت حركة “التضامن” بداية تحوّل سياسي عميق عبر توحيد النقابات والعمال والمثقفين في حركة مدنية فرضت بدائل واقعية من خلال الإضرابات والتفاوض. وفي جنوب أفريقيا، مثّلت الحملة العالمية ضد نظام الفصل العنصري نموذجًا في الجمع بين المقاومة المحلية والضغط الدولي، حيث أسهمت المقاطعة الاقتصادية والثقافية والعزل الدبلوماسي في إسقاط النظام. أما في الجزائر، فقد شكّل التلازم بين الكفاح المسلح والتنظيم السياسي والسعي إلى الاعتراف الدولي طريقًا نحو التحرر، لكنه أظهر أيضًا أن أي نضال مسلح يجب أن يكون جزءًا من خطة سياسية واجتماعية تحمي النسيج الوطني بعد التحرير.
وفي التاريخ الفلسطيني ذاته دروس غنية لا تقل عمقًا. فالثورة الفلسطينية الكبرى (1936–1939) كانت نموذجًا مبكرًا لتحرك شعبي واسع ضد الاحتلال البريطاني والمشروع الصهيوني، لكنها كشفت في الوقت نفسه خطورة غياب القيادة الموحدة والمؤسسات القادرة على التعبئة المستمرة، ما مكّن الاحتلال من استثمار الانقسامات الداخلية لإضعاف الحركة الوطنية. أما الانتفاضة الأولى (1987–1993)، فقد جسّدت المقاومة الشعبية المنظمة عبر اللجان والإضرابات والمقاطعة والعصيان المدني، مما جعلها قادرة على التأثير في الوعي الدولي تجاه القضية الفلسطينية بفضل وجود قيادة وطنية موحدة تمتلك رؤية سياسية واضحة تتجه نحو تجسيد الحقوق المشروعة وفق القرارات والمواثيق الدولية، في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وحق عودة اللاجئين وفق القرار 194. غير أن الفشل في استثمار تلك التجربة والتضحيات العظيمة للشعب الفلسطيني أدى إلى فقدان الزخم وتراجع المشروع الوطني الجامع في حينه.
وما بعد حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي مارستها آلة الحرب الإسرائيلية على شعبنا منذ السابع من أكتوبر، وما تلاها من إجراءات فعلية لضمّ الضفة الغربية وتقطيع أوصالها، يضعنا أمام حتمية الوحدة، وضرورة صياغة استراتيجية وطنية جامعة ترتقي إلى مستوى التضحيات التي قدّمها شعبنا في ملحمة أسطورية شهد لها العالم بأسره. فهذه الحرب كشفت أن الشعب الفلسطيني، رغم الجراح الهائلة، لا يزال قادرًا على الصمود والمواجهة، شرط أن تُترجم تضحياته إلى مشروع وطني موحّد يعبّر عن إرادته الحرة وحقه المشروع في الحرية والكرامة والاستقلال.
إن تنوع أدوات المواجهة ضرورة وطنية، شرط أن تبقى ضمن رؤية موحّدة تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الكيان الجامع لكل القوى، لا ساحة للتنافس الفصائلي أو الاستقواء السياسي. فالمزج بين الضغط الشعبي والتنظيم المدني والعمل الدبلوماسي والحشد الدولي المنسق يشكّل قوة قادرة على تغيير الواقع. القيادة الموحدة والمؤسسات القوية ضرورية لتوجيه الطاقة الجماهيرية واستثمارها سياسيًا، فيما تبقى السردية الوطنية، التي ترسخت بفعل التضحيات والصمود الأسطوري لشعبنا، أداةً مركزية لترسيخ الشرعية الوطنية وصون الهوية.
فالصمود الحيّ لا يعني التكيّف السلبي، بل القدرة على الإبداع والمواجهة دون التفريط بالحقوق الأساسية، لأن الصمود الحقيقي هو كرامة واعية، لا انتظار سلبي لمصير يفرضه الآخر.
لكن الواقع الفلسطيني اليوم يكشف عن تشتتٍ مؤلم في الرؤية والمواقف، في وقتٍ تواصل فيه الحركة الصهيونية مشروعها الاستيطاني منذ أكثر من قرن، تحت شعارات استعمارية مثل “أرض بلا شعب لشعب بلا أرض”. وقد اعتمد المشروع الصهيوني منذ بدايته على الإبادة والتطهير العرقي والضمّ التدريجي والتقسيم الممنهج للأرض والناس، بينما ظلّ المشهد الفلسطيني متأرجحًا بين رؤى وأطروحات متناقضة، مما أضعف الموقف الوطني في التصدي للمشروع الامريكي الصهيوني .
إن المطلوب اليوم هو رؤية وطنية جامعة تتجاوز الانقسام وتعيد بناء البيت الفلسطيني على أساس الشراكة الحقيقية، تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية. وقد شكّل اتفاق بكين الأخير بين الفصائل خطوة يمكن البناء عليها إذا توفرت الارادة السياسية الفعلية نحو تُرجمته إلى فعل مؤسسي حقيقي، حيث نص الاتفاق على تحقيق وحدة وطنية شاملة تضم جميع الفصائل، والالتزام بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واعتماد انتخابات حرة تضمن مشاركة كل مكونات الشعب داخل الوطن وخارجه بعيدًا عن سياسة التعيين التي أضعفت شرعية المنظمة ووسّعت الفجوة مع الشارع الفلسطيني. كما أن الإصلاح الداخلي، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية في مؤسسات السلطة، باتت ضرورات وجودية لإعادة الثقة بين الشعب وقيادته، وبناء جبهة داخلية قوية قادرة على الصمود، إلى جانب ضرورة حماية الرواية الوطنية، وبناء صمود اقتصادي واجتماعي يقلّل التبعية للاحتلال.
إن الصمود ليس شعارًا يُرفع في المناسبات، بل مشروع وطني واعٍ يُبنى بالإرادة والرؤية الموحدة والعمل الجماعي. فالبقاء وحده لا يصنع المستقبل، أما الصمود القائم على الكرامة والمشاركة والوحدة، فهو الطريق الوحيد للحفاظ على الوجود والهوية والحق.
ولْتكن رسالتنا واضحة: لا نريد فقط أن نبقى، بل نريد أن نحيا بكرامة على أرضنا، أحرارًا، أصحاب مشروع وطني قادر على تحويل الصمود إلى انتصار وتجسيد للحقوق المشروعة.