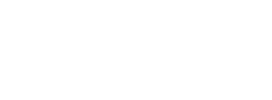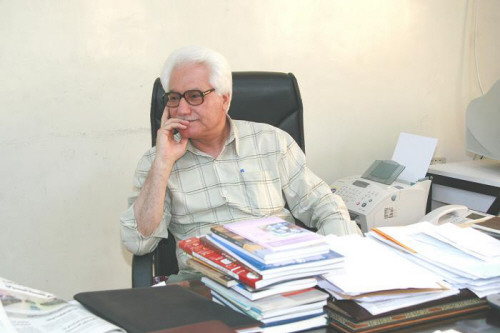تتلخص “السلفية” في أنها دعوة للعودة لأخذ الإسلام من أصوله الصافية المتمثلة في الكتاب والسنة مشترطة “فهم سلف الأمة”.
أو تعبير آخر, يقصد بالمنهج السلفي المنهج القائم على اتباع سبيل المؤمنين من السلف الصالح، وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وهم في كل عصر الفئة التي قال عنها رسول الله صلى عليه وسلم: (لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك.). رواه مسلم.
والمنهج السلفي من حيث البنية الفكريّة أو العقديّة, يعني أن من انتسب إليه وسلك سبيله (ليس بخارجي يستحل دم المسلم بالمعصية، ولا ممن يكفر الصحابة، ولا محرف متأول بالباطل ممن ينفي صفات الله وينفي معانيها، وليس مشبها لله بخلقه، ولا حلوليّاً ممن يقول بوحدة الوجود, أو أن الله قد حل في خلقه، أو صوفياً ممن يعبدون القبور ويقدمون لها النذور.). (1). إنه الطريق والنهج الذي سار فيه الصحابة والخلفاء الراشدون.
إن مسألة تأصيل الفكر السلفي الوثوقي الجبري وقوننته فقهيّاً وفلسفيّاً, بدأت إرهاصاتها الأولى في نهايات القرن الأول للهجرة مع المالكي والشافعي وابن حنبل, مرورا بتلامذتهم مثل, أبو حسن الأشعري وأبو حامد الغزالي, البيهقي والباقلاني والقشيري والجويني والفخر الرازي والنووي والسيوطي والعز بن عبد السلام والتقي السبكي وابن عساكر وغيرهم الكثير. فكل هؤلاء التلاميذ آمنوا إيماناً مطلقا بدور النقل على حساب العقل, وقياس الشاهد على الغائب, وأن صريح العقل لا يخالف صحيح النقل, وأن الحسن والقبيح هو ما حسنه الشرع أو قبحه, كما نظروا في أصول الدين كالصفات والقدم والمحدث وكل ما بيناه أعلاه في البنية الفكريّة او العقديّة لهذا التيار. وإذا اضطروا لاستخدام العقل كما استخدمه الشافعي وغيره فيما بعد في القياس, أو كما استخدمه الأشاعرة في نظرية الكسب, فيأتي استخدام العقل هنا للاستدلال والاستقراء أو البحث عن دليل في النص أو الأثر ليشير عن ما هو محدث او مستجد من أمور الحياة. أو بتعبير آخر, يأتي استخدام العقل في هذا المنهج لتثبيت النص والأثر وليس للحكم عليهما, لأن ما تم في الزمن الذي حدد أصحاب هذا التيار (القرون الهجرية الثلاثة الأولى), صحته وضرورة الالتزام به, وهو زمن مقدس ولا نقاش أو رأي في ما ورد فيه من فكر وسلوكيات. كما أن التقديس راح يشمل فيما بعد أقوال فقهاء هذا المنهج السلفي أنفسهم.
لنعود وننظر في آراء من أصل لهذا التيار السلفي الجبري, حيث يعتبر الشافعي /150- 205/ للهجرة, هو أول من أصل قواعد الفقه السلفي في صيغته الوثوقية التي جئنا عليها, عندما حدد المراجع الأساسيّة للتشريع الإسلامي بالقرآن والحديث والإجماع والقياس, وإذا كان القرآن وما اتفق عليه من الحديث الصحيح هي مسائل ثابتة, فإن الإجماع جاء عنده مقتصراً على إجماع علماء الدين من أهل السنة, أو إجماع أهل المدينة, أما القياس فهو البحث عن دليل شرعي لكل محدث أو مستجد لم يرد فيه نص أو أثر, ودور العقل في القياس (الجزئي) – أي قياس الجزء على الجزء – هنا هو البحث عن دليل في هذه المصادر الأساسيّة وليس لابتداع دليل.
يقول الشافعي حول ضرورة التمسك بالنص المقدس والأثر: (لم يجعل الله لأحد بعد رسول الله أن يقول إلا من جهة علم مضى.).(2). وعلى هذا يأتي قياس الجزء على الجزء, أو الشاهد على الغائب فاعلاً وحيويّاً في إصدار الفتوى, وكل جديد لا يوجد سند صريح له أو شبيه به, فهو بدعة.
إن الماضي عند الشافعي يأتي هنا بصريح لفظه متمسكاً بالعلم الوحيد في الإسلام, فلا يحل أو يحق لجيل لاحق أن يحكم أو يفتي أو يفكر لنفسه, إلا ويكون مستنداً إلى حكم أو فتوى أو فكر الأجيال السابقة. وبالتالي فكل المحدثات من الأمور هي بدعة كما بينا اعلاه, وهذ ا ما أورد ابن القيم الجوزي عن الشافعي قوله: (المحدثات من الأمور ضربان أحدهما, ما أحدث يخالف كتاباً أو سنة أو إجماعاً أو أثراً, فهذه البدعة الضلالة). (3).
أما بالنسبة لأحمد بن حنبل المتوفى سنة /284/ هـ, فهو الممثل الرئيس لمدرسة الرواية أو الحديث, وهي المدرسة التي تأخذ بالحديث حتى المرسل والضعيف منه وترجحه على الأخذ بالرأي والقياس. فالحديث الضعيف عند ابن حنبل (أهم من الرأي), وكذلك الخبر الضعيف). فابن حنبل يحارب الأخذ بالرأي ويلتمس الخبر ولو كان ضعيفاً, هذا وقد روي عن ابنه “عبد الله” قوله: ( سمعت أبي يقول: لا تكاد ترى أحداً نظر في الرأي إلا وفي قلبه دغل.).(4). والدغل هو فساد الرأي.
هذا ويعتبر ابن حنبل من أكثر الفقهاء تشدداً بالنسبة للتيار السلفي, وأن معظم من اشتغل على هذا التيار وأخذ به يعتبر ابن حنبل أستاذه, وفي مقدمة هؤلاء ” أبو حسن الأشعري”.
أما أبو حسن الأشعري المتوفى سنة /324/ هـ, وهو المعتزلي أصلاً, ثم تخلى عن فكره القدري المعتزلي الذي اعتنقه أربعين عاما, ليلتحق بالفكر السلفي بعد أن راح أصحاب الفكر السلفي يُلاحقون من يقول بالقدر, وشُكلت لهم محاكم التفتيش منذ مرسوم المتوكل عام 232 للهجرة الذي أصدره لمعاقبة كل من يقول بالرأي, واعتماد العقل مرجعاً للحكم على مستجدات الحياه.
لقد انبرى “الأشعري” مدافعاً عن مقولات ابن حنبل بعد أن تبنى آراءه وهو القائل في ذلك: ( قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها هي التمسك بكتاب الله وسنة نبينا محمد (ص) وما روي عن السادة الصحابة والتابعين, وأئمة الحديث, ونحن بذلك معتصمون بما كان يقول به “أبو عبد الله أحمد بن حنبل” نضر الله وجهه وأجزل مثوبته قائلون, ولما خالف قوله مخالفون.).(5). وبهذا الموقف السلفي أصبح تياره فيما بعد الممثل الأكثر حضوراً للتيار السلفي الوثوقي الجبري في صيغته الحنبليّة الضيقة, وبالرغم من إشكاليّة الأشعري الواقعة بين رغبته في مدرسة الحديث من جهة, وبين انشقاقه عن المعتزلة وتأثره بدور العقل من جهة ثانية, وللخروج من هذه الإشكاليّة راح يستخدم العقل لتثبيت النص وليس للحكم عليه, أي استخدام العقل لنفي العقل. هذا وقد اعتبر الأشاعرة كتيار ديني سلفي من التيارات الأساسيّة التي توافق الخط العام السياسي للسلطات الحاكمة سابقاً ولاحقاً, أو ما يسمى بـ (التيار المدخلي).
والأشعري من الوجهة السياسيّة بإيمانه أو قوله بالإجماع في زمن وجوده هو, كان يلتمس الشرعيّة في فعل السلف وما ينسب إليهم من الإجماع على اختيار أبي بكر وعمر وعثمان, وذلك لنفي مقولة المعارضة الشيعيّة بالوصيّة لعلي وأبنائه من بعده.
على العموم, إن أبي حسن الأشعري في المحصلة أصل للسلفيّة من حيث العقيدة, في الوقت الذي أصل لها الشافعي فقهيّاً. أي هو من ولج باب الأصول أكثر من الفروع, في مسألة القضاء والقدر, وطرحه لنظرية (الكسب) التي جاءت أساساً لتبرير الجبر على حد قول ابن تيمية (حاول الأشعري في نظرية الكسب أن يخرج من الجبر فوقع فيه.). وهو من تحدث أيضاً بالصفات العقلية (العلم. الحياة. القدرة. الإرادة. الكلام. السمع. البصر.), واعتبرها من ذات الله, وتكلم بمفهوم العدل والحسن والقبيح الشرعيين, وأنكر السببيّة, وقال ليس من قديم سوى الله أما العالم المادي فمحدث.
أما الغزالي المتوفى سنة /505/ هـ, وهو تلميذ أبي حسن الأشعري فقد تمسك بفكر أستاذه, في الوقت الذي فتح فيه الحدود بشكل (تلفيقي) بين الفلسفة والمنهج السلفي, بالرغم من بقائه محاربا للفكر العقلاني برده على الفلاسفة في كتابه المشهور (التهافت). فالغزالي واجه الفلاسفة الذين قالوا إن الله لا يعلم إلا بالكليات, أما الجزئيات فلا, والغزالي يقول: (بأن الله خلق العالم بإرادة حرّة قديمة وهو قادر على الإحاطة الكليّة والجزئيّة بهذا العالم. كما يقول: إن حقائق الأمور الإلهيّة لا تنال بنظر العقل وليس بقوة البشر الاطلاع عليها.). (6). كما حاول إقحام التصوف في الفكر السلفي حيث اشتغل على هذا الفكر والتقى مع المتصوفة في الكثير من أفكارهم, واختلف معهم في قضية (وحدة الوجود) حتى ولو على أساس روحي, كون هذا المبدأ يرمي في النهاية إلى إنكار الواحد الأحد المفارق والعلوي.
ملاك القول:
لا يمكن الحديث عن السلفية بوصفها تيارا دينيا – أو سياسيًا – واحدًا، فالحق أن هناك العديد من ” السلفيات ” التي تتباين رؤاها الدينية ومواقفها السياسيّة ، بدءًا بالتيارات التي تحرم – قطعيًّا – الخروج على الحاكم و” إن أخذ مالك وضرب ظهرك ” وانتهاءً بالسلفيّة القتاليّة التي تبيح الخروج على الحاكم ومواجهته بالسلاح إذا لم يطبق ما أنزله الله ،وتراه طاغوتًا يحكم بهواه رافضًا حكم الله الذي لا حكم إلا له .
وعلى الرغم من الموقف المبدئي الذي يكاد تجمع عليه أغلبية التيارات السلفية وهو (رفض المشاركة السياسيّة للمختلف)، باعتبار الديمقراطيّة نظامًا علمانيًّا مستعارًا من الغرب الكافر, وهذا ما يجعلها تتفرد بالسلطة, وتنظر بعين عدم الرضا للمختلف, وتعمل على إقصائه فكريا وسياسياً. إضافة لرفضها مفاهيم الدولة المدنيّة القائمة على المواطنة.
كاتب وباحث من سورية
d.owaid333d@gmail.com
الهوامش:
1- ( موقع إسلام ويب – حقيقة المنهج السلفي). بتصرف
2- عبد الجواد ياسين- السلطة في الإسلام – المركز الثقافي
العربي –ط1- 1998- ص69
3- المرجع نفسه- ص 69.
4- المرجع نفسه- ص 72.
5- المرجع نفسه. ص- 55 .
6- الطيب تيزيني- من اللاهوت إلى الفلسفة العربية الوسيطة – القسم الثاني- دمشق – وزارة الثقافة- 2005– ص 253.