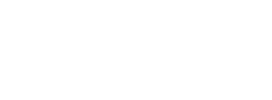أتى الانفجار السوري، المتمثّل بالهجوم العاصف والمفاجئ لفصائل المعارضة العسكرية السورية على المناطق التي يسيطر عليها النظام، وضمنها أخذ ثاني أكبر مدينة في البلد، كمحصّلة لتغيّر الظروف الدولية والإقليمية المؤثّرة على سوريا، وفي المقدمة منها ضعف الطرفين الأساسيين، أي إيران وروسيا، اللذين شكّلا قوة إسناد للنظام الحاكم إبان الانفجار السوري الأول (آذار/ مارس 2011)، بنتيجة انشغال، أو استنزاف، روسيا بالحرب الأوكرانية، وانكسار قوة «حزب الله» في لبنان، الذي شكل العمود الفقري للميلشيات التي تعمل كأذرع إقليمية لإيران، و«الحرس الثوري الإيراني» في المشرق العربي، مثل زينبيون وفاطميون وعصائب الحق والنجباء وفصائل الحشد الشعبي في العراق، التي كانت أخذت على عاتقها الدفاع عن النظام السوري والمحافظة عليه طوال العقد الماضي.
قوة الدفع الثاني للهجوم الحاصل أتت بتوفّر إرادة دولية (أمريكية أساسا) وإقليمية وعربية باتجاه إنهاء، أو تحجيم، نفوذ إيران وميلشياتها في المشرق العربي (واليمن)، بنتيجة التداعيات الناجمة عن عملية طوفان الأقصى، التي اعتبرت في بعض أوجهها، وفقا لأوساط دولية وإقليمية، كمداخلة إيرانية، بحكم دعم نظام إيران لـ حماس، وانخراط حزب الله في ما أسماه معركة إسناد غزة، بالرغم من أنها لم تخفّف من حرب الإبادة التي شنّتها إسرائيل على فلسطينيي غزة طوال عام كامل، ويندرج في ذلك، أيضا، هجمات الحوثيين في اليمن المؤثّرة على الملاحة، والتجارة، الدولية في الخليج العربي والبحر الأحمر.
التفسير الآخر، يتعلق باستنفاذ استراتيجية الاستثمار الأمريكي (وتاليا الإسرائيلي) في سياسات إيران الإقليمية، وهذا أعلى من نهج الاحتواء، والتي خدمت، بشكل غير مباشر، بتخريب بني الدولة والمجتمع في المشرق العربي، وكفزاعة ضد أنظمة الخليج العربي (عبر اليمن)، وهي استراتيجية بدأت بتقديم الولايات المتحدة العراق على طبق من فضة إلى إيران، عبر ميلشياتها الطائفية المسلحة، بعد إسقاط نظام صدام (2003)، واستمرت باللا مبالاة، والسكوت، عن صعود نفوذها في لبنان وسوريا واليمن. والفكرة الآن، أن إيران تجاوزت حدودها، وأساءت فهم طبيعة ومغزى وحدود السماح الأمريكي، تبعا لما حصل في طوفان الأقصى، رغم نأيها بنفسها عنها، من دون طائل، وتبعا لما حصل من حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن.
قوة الدفع الثالثة تمثلت بوجود تركيا كقوة إقليمية تصارع على حصتها ومكانتها في الشرق الأوسط، بإزاء طرفين إقليميين، هما إسرائيل وإيران، فهذه القوة تحملت موجات اللجوء السوري، واحتضنت ملايين اللاجئين السوريين، على أرضها أو على حدودها، في مخيمات بائسة داخل الأراضي السورية، وهي لديها هاجس من إمكان ازدياد نفوذ قوات (قسد) الكردية في سوريا ما يشكل خطرا على أمنها القومي، وفقا لرؤيتها.
في المحصلة فإن تركيا رأت أن الظرف الدولي والإقليمي موات هذه المرة للتحرك في الجوار السوري، عبر فصائل المعارضة العسكرية، سيما إنها تقدمت بعدة مبادرات تجاه النظام لإيجاد حل سياسي للصراع السوري، دون أن تلقى استجابة من النظام، تماما مثلما أن النظام ذاته لم يستجب لأي من المبادرات العربية، التي تتطلب فك علاقته بالنظام الإيراني مقابل التطبيع معه.
أما قوة الدفع الرابعة للانفجار فأتت من النظام نفسه، الذي ظلّ في الحكم قرابة ستة عقود (بشار الأسد له في الحكم 25 عاما)، فهو لا يبدي أي استعداد لنزع عوامل الانفجار الداخلية، أي أن الأمر لا يقتصر على اللامبالاة إزاء المبادرات الخارجية. والحقيقة فإن القطبة المخفية تتمثل في أن النظام الحاكم في سوريا يعتبر البلد بمثابة ملكية، أو مزرعة، خاصة ووراثية للعائلة، ولا يسمح البتة بالإخلال بهذا المبدأ، ما يفسّر رفضه لأية تسوية، ولأي إصلاح حقيقي في النظام السياسي، وانتهاجه الحل العسكري فقط في مواجهة شعبه أو نصف شعبه، إلى درجة تشريد ملايين السوريين داخل وخارج سوريا، وتدمير عمران مدن السوري.
ولنلاحظ أن النظام الحاكم ليس فقط رفض أي مبادرة للإصلاح السياسي، وأي مبادرة للاستجابة للمطالب الإقليمية والعربية بفك علاقته بإيران وميلشياتها، بل إنه لم يقدم أية مبادرة للسوريين المشردين الذي يعانون البؤس في مخيمات على الحدود في الشمال والشمال الغربي، بالسماح لهم بعودة آمنة إلى بيوتهم في حلب وحمص وحماه ودرعا ودمشق، وبالإفراج عن عشرات ألوف المعتقلين في سجونه، كنظام صلب يعمل ككتلة صماء مغلقة على ذاتها، بل إنه لم يقم بأي شيء لتحسين إدارته لشعبه في المناطق التي يسيطر عليها، فثمة انهيار مريع في الداخل السوري، في قيمة العملة، ومستوى المعيشة، والخدمات، والبني التحتية.
القصد أن الانفجار السوري الثاني ليس مفاجئا، إذ أتى محصلة لتوفر عدة ظروف، أما المفاجأة فتتمثل بالتمدد الكبير لفصائل المعارضة من حلب وربما إلى حماة قرب حمص، وهذا لم يحصل إبان الانفجار الأول. في مقابل ذلك ثمة مفاجأة أخرى تمثلت بانهيار قوات النظام السوري في حلب وريفها، إذ لم يحصل أي قتال، كأن ماحصل تسليم واستلام، وهذا ناتج عن ترهّل الجيش السوري، أو عدم اقتناع بجدوى المواجهة، بعد ضعف روسيا، وانسحاب مقاتلي حزب الله من سوريا إلى لبنان، كما هو ناتج عن الحياة البائسة التي يعاني منها أفراد الجيش السوري.
ربما يمكن الحديث عن مفاجأة أخرى، أيضا، تتمثل بانضباطية الفصائل العسكرية بالقياس للفوضى التي كانت إبان الانفجار الأول بعد طغيان العسكرة على الثورة السورية، رغم وجود خروقات، وهذه الانضباطية تجلت، أيضا، بطريقة التعامل مع المدنيين ومنتسبي الجيش والشرطة، وهذا يعود إلى الاستفادة من سلبيات التجربة السابقة، كما يعود إلى سيطرة الفاعلين الدوليين والإقليميين على الفصائل العسكرية.
بيد أن المفاجأة الأكبر، ربما، تتمثل بتحولات الطرف الأقوى في الفصائل العسكرية المهاجمة وهي هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا)، بتغير خطابها من الإسلاموية المتطرفة، إلى خطاب مدني جامع، وبتأكيد حرصها على تطمين كل مكونات الشعب السوري، الدينية والإثنية، والأهم تأكيدها على حل الهيئة ذاتها، والاستعداد لتسليم السلطة في المناطق التي تمت السيطرة عليها للمدنيين، ما يجب مراقبته والتأكد من صدقيته وديمومته على أرض الواقع؛ بعيدا عن أي أوهام.
هذا يتطلب، أيضا، تأكيد أن الانفجار السوري الثاني أكبر من هيئة تحرير الشام، أو أي من الفصائل العسكرية، سواء في شقه السوري، بتقبل معظم السوريين له، إن كوسيلة ضغط على النظام لدفعه نحو الحل السياسي، أو كمرحلة على طريق التغيير السياسي المنشود، والذي طال أمده، بنتيجة إغلاق النظام لأي فرصة للتغيير. أما فيما يخص الشق الإقليمي من المعادلة فهذا الهجوم يأتي في سياق محاولة دولية وإقليمية لإعادة ترتيب الخريطة السياسية والأمنية والجغرافية في بلدان المشرق العربي، وفي المركز منها تحجيم نفوذ إيران وميلشياتها، أو انهاء هذا النفوذ وإعادتها كدولة عادية داخل حدودها.
في المقارنة، فإن الانفجار السوري الأول، يختلف عن الثاني، بكونه انفجارا شعبيا، أو انتفاضة شعبية وعفوية، بمعنى الكلمة، ووجهت بقمع شديد وغير مسبوق، ما أسهم في تحويلها، كردة فعل، إلى مجرد صراع عسكري، وأيضا، نتيجة المداخلات والتلاعبات الخارجية المخاتلة والمضرة أيضا، في حين في الانفجار الثاني نحن إزاء صراع عسكري، كجيش لجيش، بعد أن توفر للفصائل المسلحة ذلك، وبعد أن تأمن لها المواءمة مع الإرادة الدولية والإقليمية.
في الغضون لا أحد يستطيع التكهّن بالكيفية التي ستتشكّل عليها سوريا في القادم من الأيام، لأن ذلك يتوقف على الإجابة على عدة أسئلة، ومثلا: هل ستتوقف هذه العملية الهجومية عند حدود حماة أم ستستمر إلى ما بعدها؟ وهل هذه الهجمة مجرد وسيلة للضغط على النظام لإيجاد حل سياسي أم هي أكبر وأبعد وأعمق من ذلك؟ وهل استنفذت روسيا وإيران إمكانيات الدفاع عن النظام؟
طبعا هذه الإجابة تتطلب ملاحظة حركات الفاعلين الدوليين والإقليميين، لكنها تتطلب، أيضا، ملاحظة مدى استجابة الشعب السوري، المتأثر، والغائب، الأكبر، من كل ما يجري، على ضفتي السلطة والمعارضة، مع افتقاده لإطار سياسي وطني جامع. فهل ستسنح الظروف الجديدة للسوريين بالتوافق على إطار يعبر عنهم ويمثلهم، بكل تكويناتهم، ويقود مسيرتهم نحو التغيير باتجاه نظام سياسي ديمقراطي لمواطنين أحرار ومتساوين؟
هذا هو الاستحقاق السوري الأساسي سواء في الانفجار الأول أو الثاني.