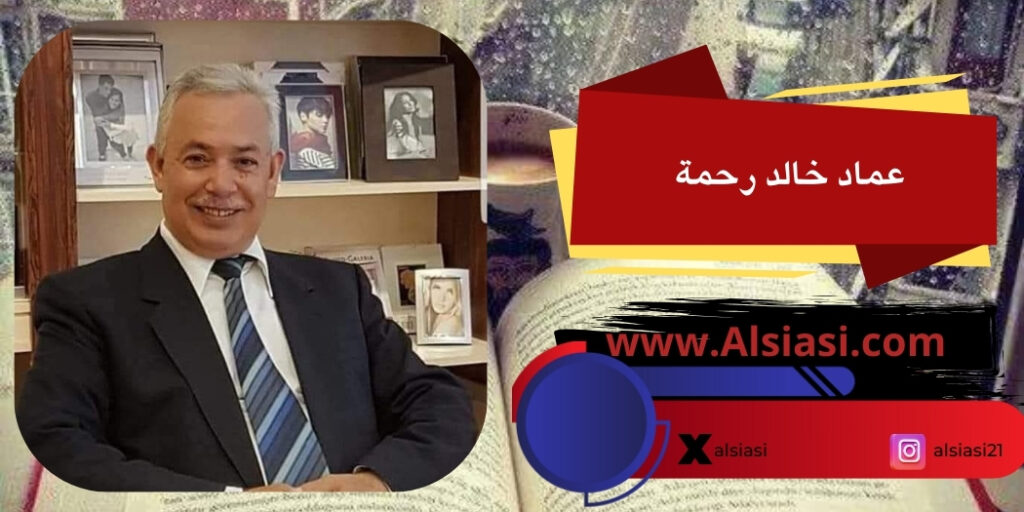تخضع المجتمعات الحديثة، رغم اختلاف أنظمتها وقوانينها وتشريعاتها، لمنظومات قيمية وسلطوية متباينة تمزج بين النظام والانفلات، وبين الضبط والعنف، وبين الحرية والتعصّب. فالقانون الذي يُفترض أن يكون حارسًا للعدالة، قد يتحوّل أحيانًا إلى أداةٍ للقهر حين تتغلغل في داخله البنى غير الأخلاقية المتوارثة من تربة العنف والفوضى والانغلاق الديني أو العرقي أو العشائري.
تُراوح المجتمعات إذًا بين التناغم والتناقض، بين العقلانية والجنون، بين البناء والهدم، بين الحب والكراهية. إنها حركة دائمة بين قطبي النور والظلمة، حيث يتجلى وعي الإنسان الحر في مقابل وعيه المقهور.
من هنا تنبثق ظاهرة التنمّر بوصفها أحد أكثر تجليات العنف الاجتماعي والنفسي انتشارًا. إنها ليست مجرد سلوك فردي عدواني، بل بنية ثقافية تتجسد في اللغة، في التربية، في السياسة، وفي العلاقات اليومية بين الأفراد والجماعات. فالمتنمّر – سواء كان فردًا أو سلطة أو جماعة – لا يعتدي لمجرد اللذة في الإيذاء، بل لتوكيد ذاته المهددة، ولإثبات تفوّق زائف على الآخر المختلف.
يرى سيغموند فرويد أن التنمّر ليس سوى تعبير عن غريزة الموت الكامنة في الإنسان؛ تلك القوة التي تدفعه إلى الإفناء والتدمير كوسيلة للاتزان الداخلي. فالعنف – في جوهره – محاولة للشفاء من توتر داخلي عميق. وما لم يُوجَّه هذا الدافع نحو غايات بنّاءة، فإنه يتحول إلى طاقة هدم تُعيد إنتاج القبح في الفرد والمجتمع.
أما ألفرد أدلر فقد رأى في العنف استجابةً تعويضية عن الإحساس بالنقص والدونية، فالمتنمّر، في وعيه الباطن، ضحية هشاشته الداخلية التي يحاول سترها بالقسوة والتسلّط.
لكنّ التنمّر لا يُختزل في بعده النفسي؛ إنه أيضًا مرآة تعكس هشاشة البنى السياسية والاجتماعية. فالحياة السياسية – كما يرى أنتوني غيدنز – ليست منفصلة عن الحياة اليومية للناس، بل تتغلغل في تفاصيلها الدقيقة. ومن هنا فإن التسلّط الاجتماعي، والعنف الديني، والإقصاء الثقافي، ليست سوى أشكال مختلفة من التنمّر المؤسّسي الذي يمارسه النظام على الأفراد والمجتمع.
فالسلطة حين تكمّم الأفواه وتحوّل الاختلاف إلى جريمة، تمارس تنمّرًا باسم القانون. والمثقف الذي يُقصي المرأة من دائرة الفعل بدعوى الحفاظ على “القيم”، يمارس تنمّرًا ذكوريًا موازياً للسلطة السياسية أو الدينية. بل إن الخطاب الإيديولوجي الذي يتغنّى بالديمقراطية والحرية بينما يرفض الآخر المختلف، لا يخرج عن كونه قناعًا جديدًا للعنف المقنّع.
إنّ ما يجعل المجتمعات المتخلفة أكثر قابلية للتنمّر هو ذلك الإرث الثقافي المشوّه الذي رسّخ في العقل الجمعي قيم الفوقية والتبعية والخضوع. فقد استبدلت هذه المجتمعات مفهوم الهوية الثقافية الحرة بهوية جمعية قطيعية تُعيد إنتاج الاستبداد وتبرّره.
وهكذا يتحوّل التنمّر من سلوك فردي إلى منظومة متكاملة للعنف الرمزي والمادي، يتوارثها الأبناء عن الآباء، وتغذيها السلطة السياسية والدينية والإعلامية والتربوية.
إنّ مقاومة التنمّر لا تبدأ من المدرسة أو من القانون فحسب، بل من إعادة بناء الوعي الإنساني على أسس الحرية والاحترام والاعتراف المتبادل. فحين يتعلّم الإنسان أن يواجه نقصه بدل أن يُخفيه، وأن يتصالح مع ذاته بدل أن يُسقط ألمَه على غيره، يبدأ عندها فقط بالتحرر من دورة القهر التي صنعها بيديه.