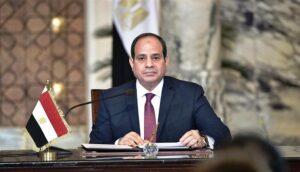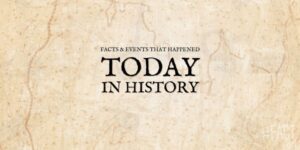تطرقنا في المقال السابق إلى بعض الحقائق التي تضغط على مؤسسة الدولة كجهة حاكمة، أو كشكل حديث للحكم في العالم، وما يتسبب به هذا الضغط من تآكل لهذا الشكل من الحكم، لصالح أشكال أخرى لم تتضح صورتها النهائية حتى الآن، لكنها تتفاعل في طريقها للظهور على السطح عاجلاً أو آجلاً.
في وسط هذا التفاعل يأتي مؤتمر حل الدولتين في نيويورك، والذي حظي بمشاركة أوروبية وعربية مهمة، وأصدر قرارات نظرية لا تقل أهمية، من ناحية الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني ببناء دولته إلى جانب دولة إسرائيل، كما تؤكد على ذلك قرارات الشرعية الدولية منذ زمن طويل.
من جانب آخر يمكننا رصد العجز الكامل للدول المشاركة في المؤتمر، مضافاً إليها الشرعية الدولية بما تمثله من مؤسسات وأطر، عن القدرة على إيقاف حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، أي على جزء مهم وأساسي من أراضي الدولة المنشودة. فهل يعقل أن هذه المنظومة العاجزة عن إيقاف حرب بهذه البشاعة وانعدام المشروعية، والعاجزة أيضاً عن الوقوف في وجه نتنياهو وقراره الأخير باحتلال غزة، تستطيع أن تفرض رؤيتها لحل ينصف الفلسطينيين بدولة تكون تجسيداً لحقوقهم المشروعة.
للإجابة عن هذه التساؤلات علينا فحص عدة مفاهيم أصبحت من المسلّمات في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، لكنها لم تعد كذلك في عالم اليوم، أو على الأقل فقدت جزءاً كبيراً من صلاحيتها وقدرتها على التأثير.
أول هذه المفاهيم هو مفهوم الشرعية الدولية، وإطاره القانوني المتمثل بالأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة.
لا أحد ينكر أن هذه المؤسسة الدولية كانت تحت رحمة الأقوياء، وخصوصاً الولايات المتحدة، وأن آلية الفيتو المعتمدة فيها حرمت الشعب الفلسطيني من قرارات دولية كثيرة لصالحه، لكن ما نتحدث عنه هنا يتجاوز هذه السيطرة الأميركية إلى العداء الصريح، والمتمثل بتقليص التمويل لبعض المؤسسات، أو قطعه كلياً كما حصل مع «الأونروا»، والانسحاب من مؤسسات أخرى كمجلس حقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية، تحت مبررات واهية كالاتهام بالفشل أو معاداة مصالح الولايات المتحدة.
في المقابل فإن وضع روسيا والصين ليس أفضل حالاً بما يخص دورهما في هذه المؤسسة، فكل المؤشرات تدل على أن الدولتين تلتفتان إلى مصالحهما الخاصة أكثر بكثير من رغبة الاندماج في منظومة قد تحجّم هذه المصالح.
هل في كل ذلك مؤشر يمكن الاعتماد عليه إذا حاولنا تحليل المشاركة الأوروبية حصراً في مؤتمر حل الدولتين؟ ربما.
المفهوم الثاني هو «العنف» والقدرة الدولية على تقبله والتطبيع معه في السنوات العشر الأخيرة.
فقد ارتفع منسوب العنف المؤدي إلى قتلى بالجملة وجرحى بالجملة، سواء بسبب الحروب الأهلية كما حصل ويحصل في سورية والسودان، أو بسبب الظواهر الطبيعية كالزلازل والفيضانات، دون أن يحرك العالم ساكناً، ودون أن «تهبّ» المنظومة الدولية للمساعدة، إلا بإصدار البيانات وتدبيج الإدانة والاستنكار أو التعاطف.
المفهوم الثالث هو السيادة، أي سيادة دولة ما على أراضيها وحدودها ومواردها، وكيف تغير هذا المفهوم على نطاق واسع في العالم تحت عناوين اقتصادية وتنموية، وتم الابتعاد من خلال تطبيقاته المستجدة عن مفاهيم التبعية، والاستعمار غير المباشر، وما إلى ذلك من مفاهيم ومصطلحات تفسر حقيقة واحدة وهي الإلحاق.
لفهم ذلك دعونا نأخذ مثالاً متداولاً بشدة، وهو الاستثمار الإماراتي في العقار والمدن السكنية في «رأس الحكمة» في جمهورية مصر العربية، وهذا المثال نأخذه لكثرة الحديث فيه أولاً، ولأنه مادة جيدة لتوضيح الفكرة ثانياً.
يتم استخدام هذا الاستثمار ليلاً نهاراً، من قِبل الكلاسيكيين الاقتصاديين، ومن قِبل الأيديولوجيين، ومن قِبل هواة رمي الكلام على عواهنه، بأن الحكومة المصرية باعت البلد، ولنقل تجاوزاً إن معهم حقاً، لكن كيف يفسر هؤلاء قيمة الاستثمار الصيني في بريطانيا العظمى، وهي بلد من العالم الأول، وهل سمعوا بالمليارات التي أنفقتها الصين لشراء الأصول العقارية، ومحطات توليد الطاقة النووية، وحتى شركات توزيع الماء وشبكات توصيله إلى البيوت في لندن ومانشستر.
لقد بلغ حجم هذا الاستثمار الصيني في بريطانيا العام 2021 حوالى 185 مليار دولار حسب الصنداي تايمز، دون أن تشكو بريطانيا من فقدان سيادتها من قِبل التنين الصيني.
وإذا علمنا أن بريطانيا هي ثالث وجهة للاستثمارات الخارجية الصينية بعد الولايات المتحدة وأستراليا، أي أنها تأتي في المرتبة الثالثة بعد هاتين الدولتين في قيمة حجم الاستثمار، فعلينا أن نشفق على الولايات المتحدة من أن سيادتها قد انتهكت تماماً من الصينيين.
المفهوم الرابع هو العدو وطبيعته المتحركة، وكما نقول دوماً بأنه لا عداوات دائمة ولا صداقات دائمة.
واستناداً إلى هذا المنطق علينا أن نضع تحت المجهر العلاقة الأميركية الأوروبية، وهل فعلاً ما زالت هذه العلاقة توصف بالتحالف، أم أن السنوات الأخيرة والمصالح المتباينة، بل والمتضاربة في كثير من الحالات، أزاحت هذه العلاقة من مربع التحالف إلى مربع التنافس، وهي الآن في طريقها إلى مربع العداء الصريح.
لا أنكر بأن هذا الادعاء بحاجة لبراهين جدية، ولا يمكن الاكتفاء، لإثبات صحته، بالمؤشرات وإن كانت كثيرة، لكن ما يعنيني هو أن مصطلح «الغرب» صار بحاجة لإعادة نظر من طرفنا.
خلاصة الكلام، وبعد حرب هي الأطول في المنطقة، وبعد الدمار الذي لحق بجزء أساسي من الدولة الفلسطينية المنشودة، وبعد الضم الإسرائيلي لمعظم أراضي الجزء الآخر من هذه الدولة، وبعد دوس الاتفاقيات السابقة وعلى رأسها اتفاق أوسلو من قبل الدبابات الإسرائيلية، وتخفيض سقف توقعات الفلسطينيين، بهدف القبول ولو بوقف إطلاق النار وانتهاء الإبادة التي يتعرض لها هذا الشعب، توازياً مع سحب البساط من تحت أقدام ممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير.
إذا أضفنا إلى كل ما سبق الشروط التي وضعها ديفيد لامي، وزير خارجية بريطانيا، وهي شروط تغيّر تماماً من الصيغة الحالية للحكم، والمنبثقة عن أوسلو، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما قلناه عن تراجع مؤسسة الدولة عموماً كجهة حاكمة، فإن المطروح على الفلسطينيين سيكون دولة تدير ولا تحكم.
أي دولة تدير شؤون السكان، وتدير علاقات التجمعات السكانية بعضها ببعض، ومع المحيط والعالم.
دولة لديها رعايا في مدن متفرقة، وليس مواطنون في بقعة جغرافية بحدود مرسومة ومعترف بها.
وستتم الاستعاضة عن السيادة المنقوصة بعلاقات دولية جيدة وتنمية ممولة بسخاء. هذه وجهة نظر في المطروح والقادم، وليست دعوة لا للقبول ولا للرفض، بل للفحص لا أكثر.