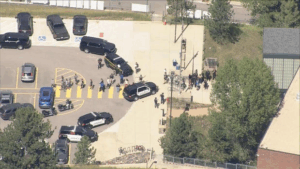يُعَدّ الفكر السياسي العربي مرآةً مأزومة لواقعٍ متشابك، تتداخل فيه الطوباويات الحالمة مع البُنى السلطوية المتصلّبة، بحيث ينقلب الخيال من مساحة لإبداع البدائل إلى أداة لتبرير العجز وإعادة إنتاج الخضوع. وفي قلب هذا التناقض، تتجلّى الحاجة إلى تفكيك العلاقة الملتبسة بين السياسة كفنٍّ لتدبير الشأن العام، وبين الأيديولوجيا كآلة لفرض الحقيقة المطلقة وتدجين العقول. فكلّما حاولت الأنظمة العربية إضفاء قداسةٍ على تصوّراتها السياسية، كلّما انكشفت هشاشة منطلقاتها وافتقارها إلى عقلانية واقعية. ومن هنا تأتي أهمية مساءلة هذا الفكر، لا بوصفه نتاجًا ثقافيًا منعزلاً، بل باعتباره ممارسة حيّة تُعيد صياغة المجتمع والدولة، بين إرثٍ فقهيٍّ مؤدلج، وواقعٍ عصيّ على الاختزال، ومستقبلٍ يتأرجح بين الانغلاق والانفتاح على الممكنات.
يمكن لخطابات النقد السياسي، في أحيان كثيرة، أن تكشف أساليب المذاهب التنظيرية في التعامل مع بنية التفكير اللاعقلاني المتخيَّل للأنظمة العربية، حيث تملك القدرة والإمكانات على قياس درجته وشدّته وكيفيته، وطريقة انبنائه، ومنهجه، وأيديولوجيته. وهنا يأتي الفكر ليسترد المبادرة، ويُنهِض الجدل العام فوق تضاريس التأويلات الأحادية لعلاقات المجتمع المدني بذاته أولاً، وبأشكال السلطة التي تحكمه تالياً.
لا سيّما أن مصطلح “الفكر السياسي” قد تجاوز في استعماله اللغوي بنيته الأصلية، إلى مجالات توظيفه المتعدّدة، وانزياحاته المفهومية المتتالية. فعلى سبيل المثال، ارتبط مصطلح “الفتنة” في الذهنية العربية الإسلامية بالقتل والهرج والابتلاء والاختبار والكفر… وغيرها من المعاني التي تصل إلى إحدى عشرة دلالة متسلسلة وفق نسق منهجي. وقد تطوّر هذا المصطلح سياسيًا من كونه تعبيرًا عن الاحتجاج والرفض في الدورة السياسية الأولى، إلى اقترانه بالخلافة والفرقة الناجية؛ حيث استخدمته المعارضة لتبرير خروجها عن الأيديولوجيات إلى العقائد، بحثًا عن النبوّة أو الأصل المفقود، بينما وظفته السلطة – بما تملك من قوة عسكرية وأجهزة أمنية – لتبرير قمع المعارضين بطرق لا إنسانية. أي أنّ المصطلح قد تحوّل إلى أداة أيديولوجية تعبّر عن ثراء المفهوم من جهة، وعن تفاعل الحركة السياسية والذاكرة الجماعية من جهة أخرى.
لقد انبثقت الجذور الرئيسية للفكر السياسي العربي من تربةٍ أنجبت ضروبًا من التفكير الفقهي، والأدبي، والإبداعي، والتاريخي، والكلامي، فأنشأت أحزابًا وفرقًا وجماعات تحمل أفكارًا ظلامية، وأنتجت عقولًا متحجّرة. ثم ارتبط الفكر السياسي العربي ذو الصبغة الإسلامية بمفهوم “الشورى” بهدف وأد الفتنة، فتلحّف بنظرية “الطاعة” وتغطّى بها. فإذا كانت الفتنة صورة مشوّهة عن الحياة السياسية، فإن مبدأ الطاعة هو صورتها الصحيحة – بحسب التصوّر التقليدي – وهكذا تحوّل المصطلح من وظيفته الدينية (الثيوقراطية) إلى وظيفة سياسية، ليغدو أداة تبريرية لاستمرار السلطة واستقرار الخلافة والحفاظ عليها بالقوة.
مع أنّ عالم الاجتماع العربي ابن خلدون نبّه إلى أن وظيفة السياسة كانت، في جوهرها، تثبيت السلطة أو وسيلة للوصول إليها، وأن مصطلح “السياسة” لا يدخل في دائرة النبوة على الإطلاق. وقد أشار ابن خلدون أيضًا إلى أهمية التمييز بين “الشرع” و”السياسة”، بما يعني أن السياسة تستدعي دلالة أخلاقية ونصيحة دائمة لدوام “السياسة الشرعية” في مقابل “سياسة الهوى” وعدم الاتزان والفوضى، وغيرها من الثنائيات التي حفلت بها كتب الأدب السلطاني والعلم المدني.
كلّ ذلك يدفعنا إلى استجلاء الطوباويات الحديثة، خصوصًا بعد سقوط جدار برلين وانهيار الشيوعية عمليًا، والذي اعتُبر – في نظر الكثيرين – انتصارًا للرأسمالية. لقد فتح هذا الحدث الباب أمام طوباويات جديدة. فمنذ ابتكار توماس مور لمصطلح “يوتوبيا” عام 1516، وتطور إرهاصات الحداثة وصولًا إلى كارل ماركس، بقيت الطوباوية محصورة في أهداف محددة: خلخلة الوعي السائد، وتحفيز الخيال، وفتح حقل الإمكانات على أوسع مدى. أما الطوباويات الواقعية – أي تلك التي طُبقت فعليًا – فقد انتهت إلى فشل كلّي أو جزئي، ولعلّ أبرز مثال على ذلك هو الشيوعية، التي اصطدمت بأنظمة حكم شمولية، إضافة إلى انتشار قيم التحرّر والمساواة وحقوق الإنسان في أماكن أخرى.
وقد ساد الاعتقاد بأنّ الطوباويات السياسية قد اندثرت مع سقوط جدار برلين، وأنّ “التاريخ” أعلن نهايته، وأنّ العالم سيعيش حالةً من الاستقرار غير المسبوق. إلا أنّ هذا الاعتقاد خاب، وخاب معه رهان المفكّر الأميركي فرانسيس فوكوياما، حين أعلن عن “نهاية التاريخ”. فما لبثت أن اشتعلت الصراعات، وتزايدت بؤر التوتّر، وهيمنت على الكوكب عولمةٌ لم يستفد منها سوى الكبار من الأثرياء؛ أولئك الذين يمتلكون القوة العسكرية والاقتصادية والثقافية، ويديرون الدول والمنظمات الدولية، وحتى الرؤساء والملوك، عن بُعد.
لم يَعُد الناس يحلمون بحلول جماعية لأوضاعهم القاسية، بل صار كلُّ فردٍ يفكّر في نجاته الخاصة، وكأنّ كلّ واحد يبحث عن طوق نجاة له وحده. لم يَعُد يهمّه ما يواجهه الآخرون، لأنّ الكوارث والنزاعات باتت في ذروتها، فعادت القوميات إلى الظهور، واشتدّت الدعوات الشعبوية إلى الانكفاء داخل الحدود، دفاعًا عن الهويات الصغرى والكبرى والمقوّمات الحضارية. وهكذا برزت الطائفية، والمذهبية، والإثنية، بأبشع صورها.
وفي خضم هذا المشهد، ظهرت طوباويات جديدة، لا سيما في المجتمعات المتطوّرة، تُعارض النزعة الإنسانية المطلقة التي توحّد البشر، وتجعل “الأنا” مَثلَها الأعلى. وهي – بحسب وصف بعض المفكرين – مرض اجتماعي استشرى بطريقة خطيرة.
بعد انتشار “طوباوية الردّة” التي تحدث عنها السوسيولوجي والفيلسوف البولندي زيغمونت باومان، صاحب نظرية الانتقال من “الحداثة الصلبة” إلى “الحداثة السائلة”، أتى المفكر الفرنسي فرنسيس وولف في كتابه “ثلاث طوباويات معاصرة” ليحصي ثلاث طوباويات حديثة تدير ظهرها للسياسة، وتحمل في طياتها نوازع قومية وهوياتية، وتدعو صراحة إلى ضمان الحقوق الفردية ضمن فضاء ضيق يجتمع فيه أتباعها حول مفاهيم وغايات محددة:
_ الأولى: ما “بعد الأنسنة”، وتتجاوز الإنسان كمركز للكون.
_ الثانية: “النزعة الحيوانية”، وتعود إلى ما قبل الأنسنة.
_ الثالثة: “الكوسموبوليتية”، وهي الأيديولوجيا التي ترى أن جميع البشر ينتمون إلى مجتمع أخلاقي واحد، وتدعو إلى “مواطنة عالمية”، بل حتى إلى حكومة عالمية للبشرية بأسرها، وهي تقترب من مفهومي “العولمة” و”العالمية”.
_ أخيراً، يرى فرنسيس وولف أن “الفلسفة السياسية” – منذ أرسطو – هي التقاطع الفريد بين ناتجين أساسيين في التاريخ الإغريقي. ومنذ ذلك الحين، بات الفكر السياسي كلّه، من مكيافيللي إلى ماركس، ومن مونتسكيو إلى حنّة آرندت، يتغذّى من فكر أرسطو، ويعيد إنتاج إشكالياته ضمن سياقات متجددة ومتغيّرة.
إنّ الفكر السياسي العربي، بما يحمله من أثقال الماضي ورواسب الطوباويات، لا يزال يتأرجح بين البحث عن شرعية مفقودة وترديد شعارات متكلّسة تُخدّر الوعي أكثر مما توقظه. لقد آن الأوان للانتقال من اليوتوبيا الموهومة إلى واقعية نقدية خلاّقة، تُعيد الاعتبار للعقل العملي، وتؤسّس لفهمٍ جديد للسياسة بوصفها فنّ الممكن لا حراسة المطلق. فالمجتمعات التي تُسجن في أوهام الطاعة العمياء أو تُساق خلف خيالات الفردوس السياسي الموعود، إنما تُعيد إنتاج عجزها وتُسلّط على نفسها استبدادها الخاص. وما لم يتحرّر العقل العربي من أسر “الفتنة والطاعة” ومن لعنة الطوباوية العقيمة، فلن يخرج من حلقة الدوران في الفراغ، ولن يبني أفقًا تتوازن فيه الحرية مع العدالة، والواقعية مع الحلم.