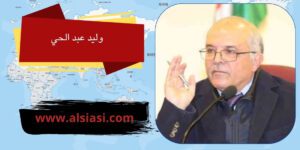تمثّل الليبرالية، باعتبارها فلسفة سياسية كبرى، منظومة من القيم والمبادئ مثل الحرية والمساواة، وحرية التعبير والصحافة، والحقوق المدنية، والحرية الدينية، والسوق الحر، والمجتمعات الديمقراطية، والحكومات العلمانية. وقد ركّزت الليبرالية الكلاسيكية على مبدأ الحرية، فيما برزت في الليبرالية الاجتماعية قيمة المساواة كركيزة أساسية.
حين تسرّبت هذه الأفكار إلى الوعي العربي في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، وجد الليبراليون العرب فيها أفقاً لمواجهة الدولة الاستبدادية القائمة في المنطقة: دولة الحاكم الفرد، المستبد الذي يحتكر السلطة والثروة ويعامل البلاد كملك خاص بعيداً عن أي مساءلة أو رقابة شعبية. وهكذا تلاقى خطاب الليبرالية مع الحاجة إلى إصلاح سياسي وفكري يفتح المجال أمام الحرية والديمقراطية.
لكن ينبغي القول إنّ إرهاصات هذه الأفكار لم تكن غريبة عن البيئة العربية؛ فقد سبق إليها بعض روّاد النهضة العربية مثل رفاعة الطهطاوي، وخير الدين التونسي، وعبد الرحمن الكواكبي الذي صاغ في كتابه الشهير طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد نقداً جريئاً للاستبداد السياسي، جعله واحداً من أوائل المبشرين بروح الحرية في الفكر العربي الحديث.
ومع بروز الليبرالية العربية في النصف الأول من القرن العشرين، برزت أسماء مثل أحمد لطفي السيد الذي عُدّ من رموز النهضة والتنوير في مصر، حتى وصفه العقاد بأنه “أفلاطون الأدب العربي”. ومع ذلك، بقيت الليبرالية العربية مسكونة بتناقضات عديدة. فظهورها الأول على يد أحمد فارس الشدياق وبطرس البستاني، كان أقرب إلى حركة ثقافية تستهدف الحدّ من سلطة رجال الدين، دون أن يتحول إلى مشروع سياسي متكامل.
أما في مرحلتها الأكثر وضوحاً، في مصر خلال العهد الملكي (1922 ـ 1952)، فقد ارتبطت الليبرالية بتحالفات مع الملكية والاستعمار البريطاني، الأمر الذي أثار تساؤلات حول صدقيتها. كما حمل خطاب بعض رموزها نزعة نخبوية واستعلائية تجاه العامة، معتبرين أن الجماهير غارقة في الجهل، وأن النخبة المتأثرة بالغرب وحدها مؤهلة لقيادة الإصلاح. وقد تأثر بعضهم بالمستشرقين، مثل طه حسين في أطروحاته عن الشعر الجاهلي، وعلي عبد الرازق في رؤيته السياسية، مما زاد الفجوة بين الفكر الليبرالي وواقع المجتمعات العربية.
وفي لبنان ومصر، تبلورت اتجاهات حاولت ربط الهوية العربية بجذور فرعونية أو فينيقية، واعتبارها امتداداً أوروبياً ضائعاً في الصحراء، وهو ما عزّز فكرة الاغتراب الثقافي والارتهان للغرب. ومع ذلك، ظلّ جوهر الليبرالية العربية في تمسكها بمطالب الدستور، وفصل السلطات، والتمثيل النيابي، متأثرة بتراث مفكرين غربيين مثل جون لوك ومونتسكيو وروسو. غير أنها لم تستوعب نسقهم الفكري كاملاً، بل سرعان ما تحوّل خطابها إلى التركيز على حرية الفرد في مواجهة الدولة، بتأثير أفكار جون ستيوارت مل، لتجد نفسها بين مطرقة الدولة الاستبدادية وسندان الفردانية غير الناضجة.
وفي المحصلة، يمكن القول إن الليبرالية العربية بقيت في مسار متعثر، لم تستطع أن تبني مشروعاً سياسياً راسخاً، وظل خطابها يتأرجح بين التبشير بالحرية والارتهان للاستعمار أو التحالف مع سلطات قائمة. ومع صعود التيارات الدينية وتوظيف الدين في السياسة منذ مطلع القرن العشرين، ازداد توجّس الليبراليين العرب من الدولة، التي لم تُبنَ على أسس حديثة بعد، مما جعل الليبرالية مشروعاً ناقصاً، عالقاً بين وعود النهضة وواقع الانكسار.
الليبرالية العربية بين النهضة والاستعمار: إشكالية الفكر والسياسة:

بقلم : عماد خالد رحمة _ برلين.