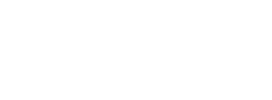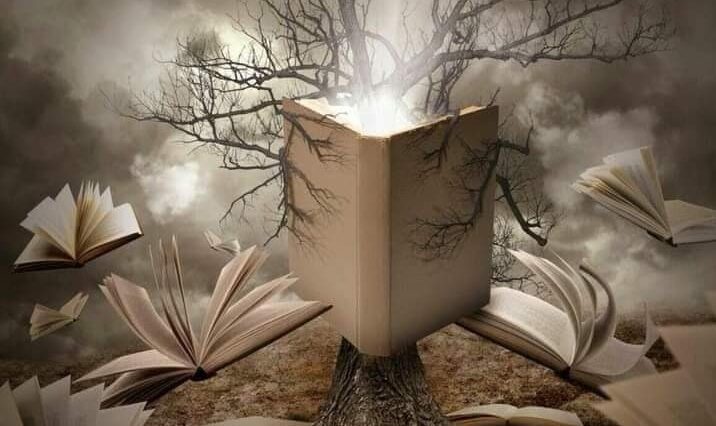ربما نخطئ، في أي مُحاججة، إذا ما اتكأنا على نصٍّ لكاتب إسرائيلي، فالواقع يكفي كشهادة دامغة للردّ عليه. ثم لا يوجد في “دولتهم” مَن يدعو إلى السلام أو إيقاف الحرب. كلهم يدعون للإبادة.. ولم يعد هناك سوى اليمين المتطرّف والحاخامي والتوراتي العنصري، فلا يسار ولا يحزنون. أما أولئك المعترضون فهم عشرات يعدّون على الأصابع لا تأثير لهم، وعلينا ألا نقع في حبائل بعضهم ممن يدّعون اليسارية، لأن الخطورة في خطاب اليسار الإسرائيلي أنه يظهر الإبادة وكأنها طارئة، وليست متأصّلة في بُنيتها. كل ما في دولة الاحتلال متكتّل بيمينه ويمينه الأكثر تطرّفا، وكيانهم قائم على فكرة الغوييم والتفوّق، و”اليسار” يعمل على تنفيسنا، ويلمّع صورة إسرائيل القاتلة، ويجمّل روايتهم بعد تخليصها من المبالغات، وفيها اعتراف جزئي، لا يدين دولة الاحتلال.. فجريدة هآرتس، مثلاً، ليست مصدر ثقة ولن تكون، بل هي جزء أساسي في البروباغندا الإسرائيلية. هي صورة الاحتلال “المتنوّر” بيساره ويمينه، الذي يستفيد من دمنا في القتل، وفي تلميع صورة القاتل. حتى عند الحديث عن ضحايا الإبادة، تُذكر هنا ككارثة طارئة، لا عن فعل قرار خالص من دولة استيطانية تأسست على اجتثاثنا. وأنا أميل إلى أن الكاتب “جدعون ليفي”، مثلاً، ليس من هؤلاء،مثله مثل “شلومو ساند” و”م. رابكن” و”ألان بابيه”، الذين تجاوزوا ظاهرة “المؤرّخين الجدد”، وأصّلوا لموقف نقدي إنساني ناضج وعميق، يعتبر مرافعة في وجه الصهيونية وخطابها المُلفّق الفاشيّ! لكنهم أفراد، ولا صوت أو تأثير لهم. ومن لسانهم نُدين جماعتهم.
وبعيداً عن البرود الذهني إزاء ما فجّره المؤرِّخون الجدد في إسرائيل، فإننا ننشىء هذا الحوار الهادىء حول ظاهرة تثير الجدل عندنا نحن الفلسطينيين، وعند المفكّرين السياسيين والمثقفين العرب، ناهيك عن أوساط إسرائيلية معنية.
ولإننا نعيش هنا، في فلسطين، نحن وعدد من المهتمين في هذا الشأن، ضمن جماهير وطنية مشتبكة اشتباكاً يومياً مع الإسرائيلي على تعدد مستوياتة، فإن الحوار أو الجدل حول ظاهرة المؤرخين الجدد، يجب أن يكون بعيداً عن التشنّج أو التهوّر أو الانبهار، أو التصفيق أو الشجب السريع، أو الرفض الجاهل الأعمى، أو الرضى المريض، أو السكوت الغبي، وخصوصاً بعدما اعترف رئيس وزراء الإحتلال السابق (باراك) بمعاناة الشعب الفلسطيني، وعبّر وزير ثقافته عن خجله من مجزرة (كفر قاسم)، ما شكّل بداية التفات دولة الإحتلال إلى الفصول المظلمة من ماضيهم، كما يقولون، وهو ما ينسجم مع بعض ما أثاره بعض المؤرخين في إسرائيل قبل أعوام، واعتبر على أهميته خطوة صغيرة وخجولة.. لا تكفي؟
لم يصدقوا بكاءنا
أولاً، وقبل كل شيء، تجب الإشارة إلى أنه لو لم يظهر المؤرخون الجدد في إسرائيل، ولو لم يكتبوا ما كتبوا، لعرفنا أيضاً المعلومات التي أدلوا بها، ولقرأنا ما أشاروا إليه من خلال الكمّ الهائل من الوثائق الرسمية التي مرّ عليها أكثر من ستين عاماً في أرشيفات المؤسسات الرسمية البريطانية والإسرائيلية، وسمحت قوانين الطرفين المشار إليهما بنشرهما، وهكذا فإن هؤلاء المؤرخين اعتمدوا على تلك الوثائق أولاً، أي أنهم لم يسألوا فلسطينياً واحداً كيف هُجّر من أرضه، ولم يصدق مؤرخ إسرائيلي واحد الكم الهائل من “البكاء الفلسطيني” طيلة ثمانية عقود تقريباً، يعني لم يصدق العالم روايتنا، ولكن هذا العالم صدق أكاذيبهم، والآن يصدّق روايتهم المجزوءة أيضاً. وقبل كل شيء، ما كان لهؤلاء المؤرخين أن يظهروا في إسرائيل لولا هذا المجتمع المأزوم دائماً، المحتقن بمعتقدات ونظريات وأيديولوجيات لم تعد تلبّي تغيرات الواقع أبداً، واكتشف الإسرائيلي العادي قبل غيره أزمة الصهيونية نفسها، وبالتالي أزمة المجتمع بكامله.
وقبل كل شيء أيضاً، فإن المؤرخين الجدد، لم يضيفوا إلى روايتنا التاريخية جديداً، بالعكس من ذلك، لقد أنقصوا منها، وقدّموها لنا وللعالم ولأنفسهم فتافيت وأجزاء وشذرات، لا رابط بينها في كثير من الأحيان، بمعنى آخر، ماذا قدم “بيني موريس” و”توم سيجف” أكثر من الدكتور وليد الخالدي أو إلياس صنبر؟ ولماذا علينا أن نحتفل هذا الاحتفال لمجرد أن باحثاً إسرائيلياً ما اعترف على استحياء أو بشجاعة بمجازر وفظائع جماعته بحقنا؟
علينا أن نفيد منهم
وبهدوء، وموضوعية، ومسؤولية، نقول: إن ما يقوم به المؤرخون الجدد جيد ومفيد، من حيث أنهم يؤكدون جزءاً من روايتنا، ويفككون الرواية الرسمية الصهيونية، ويخلخلون بشكل ما، الأوهام القومية والتاريخية وحتى الدينية التي تبني إسرائيل نفسها عليها – وإن كانوا لا ينسفون الأساس الأيديولوجي الصهيوني ذاته.
وبما أن هؤلاء يكتبون لأنفسهم وليس لنا، وبما أنهم يعيدون تقييم “تجربتهم” ومراجعتها ومحاسبتها، وليس حبّاً في “سواد عيوننا” أو لإرجاع حقوقنا أو للانسحاب من أراضينا وبيوتنا وشواطئنا “وخبزنا وملحنا”، فإن دورنا الآن – سياسيون ومثقفون وهيئات حكومية وغير حكومية – يتلخص بالاستفادة من هذا التغيير، ومن هذه الزحزحة في المواقف، وأن نستغلها جيداً في المواجهة اليومية على الأصعدة المختلفة. وهذا السؤال مطروح على الفلسطينيين، ويمكن التفكير بآليات جادة وواعية ومسؤولة للاستفادة من تيار “ما بعد الصهيونية” هذا، ونترك هذا السؤال للجهات المعنية لأن تجيب عليه. أي إدخال ما يعنينا من نتائج أبحاث المؤرخين الجدد في أيّ مفاوضات قادمة للوضع النهائي، وفيما يتعلق باللاجئين خاصة، عدا عن تعميم هذه النتائج على المنظمات الدولية للثقافة والعلوم والملتقيات ذات الشأن.
إنهم تعبير عن أزمة
المؤرخ الإسرائيلي الجديد – حقيقة – لم يفعل ولم يقدم لي شيئاً جديداً، وهو لم يكتب لي ليناقشني، ولم يكتب لي ليخفف عني آلامي، ولم يسألني فهو لم يصدقني أصلاً، هو – عملياً – ينقد مجتمعه، وينسف أكاذيبه وأوهامه لتصحيح أوضاعه ولتطهيره ولتقويته ولمعافاته، وهو يفعل ذلك من منطلق أن المجتمع الإسرائيلي يسمح لكل الأفكار والأيديولوجيات بالظهور والتعبير الحرّ – ضمن قوانين وشروط لا يستطيع معها العرب والفلسطينيون التعبير من خلالها، وهنا تكمن العنصرية.
ظهور المؤرخ الجديد تعبير عن أزمة وليس تعبيراً عن صحوة ضمير والمؤرخ الجديد ليس حزباً ولا حركة سياسية شعبية إنه قادم من نخبة أكاديمية أي أنه بلا تأثير شعبي كبير أصلاً ولن يصل أحد منهم إلى شعبية “يشعياهو ليفوفيتش” (نبي الغضب) كما أطلق عليه الإسرائيليون أنفسهم (وليفوفيتش هو بروفيسور يهودي مختص في الفيزياء والفلسفة وله مؤلفات عديدة ومن أهم أفكاره أنه ندّد باحتلال إسرائيل للأراضي العربية واعتبر ذلك خيانة للمشروع الصهيوني وتوسيخ للنظام الأخلاقي الإسرائيلي واعتبر أن احتلال شعب آخر هو خلخلة ديموغرافية وبداية النهاية للدولة اليهودية النقيّة. كما اعتبر أن المؤسسة الرسمية الصهيونية تتحوّل إلى خادمة لمشروع إمبريالي أكبر منها. ومن آرائه الطريفة أنه يعتقد أن اليهود الحاليين هم يهود أصليون لأنهم يحافظون على حرمة السبت فقط).
حشبون نيفش
والإسرائيليون معتادون على ما يسمونه بالعبرية “حشبون نيفش” أي “حساب النفس” باعتباره آلية دفاعية اكتسبوها منذ لعنات الربّ الأولى، فهل هذا المؤرخ الجديد يقوم بهذه العملية علناً، بعد أن شعر الجميع أن الصهيونية قوية بما يكفي لنقد ذاتها بهدف تجديد الشباب والنشاط والاندفاع إلى الأمام؟
أليس من حقي أن أحاسب نفسي أنا أيضاً، شاعراً في الوقت ذاته أن التعبير الحرّ والفكر الاستقلالي هو أفضل الطرق لمعرفة الخلل، ومؤمناً أيضاً أن النقد الذاتي مفيد للفرد والمجتمع والدولة، وأن المجتمع الديناميكي هو المجتمع الذي يستطيع أن يخلق أفراداً قادرين على الرؤية البعيدة والشاملة والحرة!
قوى السلام للمحافظة على “الدولة”
وقبل أن نتحدث عن ظاهرة المؤرخين الجدد، تجب الاشارة إلى ظاهرة شعبية سبقتها ألا وهي “حركات السلام” على اختلاف أسمائها ومضامينها وتوجهاتها، وهي على عكس ظاهرة المؤرخين الجدد، كانت شعبية، ولها تأثير لا يكاد يذكر على صانعي القرار السياسي – إلى حدٍ ما، وقامت بنشاطات معينة بمناسبات معينة، ونحن، الآن، ودون مزايدات أو عنتريّات أو أوهام، نعرف أن حركات السلام هذه لم تتجاوز الفكر الصهيوني قيد أنملة! وقد انطلقت جميعاً من مفهوم واحد ووحيد هو الحفاظ على “المجتمع والدولة” بأقل الخسائر الممكنة، وليس هناك من طريق لذلك إلا “فرض سلام مع العرب الذين يؤمنون بالوجود اليهودي والمشروع الصهيوني” .
وتميّز عمل حركات السلام هذه بالازدواجية والتناقض والتذبذب، الأمر الذي أفقدها كثيراً من أنصارها وتأثيرها،غير متناسين أن سبب نشوء مثل هذه الحركات هو المغامرات والأزمات والسياسات المجنونة التي تقوم بها المؤسسة الحاكمة في إسرائيل، والتي أدت وتؤدي وستؤدي دائماً إلى تلطيخ وجه إسرائيل. وحركات السلام على اختلافها – وخوفاً على هذه السمعة – تقوم بما تعتقد انه الأفضل لإسرائيل.
أما السؤال عن كيفية تعاملنا نحن الفلسطينيين مع مثل هذه الحركات، فهو أيضاً متروك للجهات المعنية لوضع الخطط وآليات التعامل الصحيح والواعي بعيداً عن المبالغة أو التهويل أو الاحتفال او التجاهل. وربما نعود إلى هذا الموضوع، إن لزم الأمر.غير أني أدعو زملائي المثقفين الذين يشكّلون جداراً أمام التطبيع، لأن يسبروا غور هذا الأمر، على قاعدة رفض النقيض والتطبيع معه أو التعاطي بأي صورة معه.
الظاهرة ما زالت نيّئة
والمؤرخون الجدد يجمعهم تقربياً أنهم من مواليد الأربعينيات، أي الذين لم يشهدوا المذابح والفظائع التي مورست ضدنا بأعينهم، وغالبيتهم درسوا في الخارج واكتسبوا آليات بحث مختلفة تتميز بالنقدية العالية، وقد انطلقوا من مرجعيات يسارية أو ماركسية حديثة، وبعضهم لم يتجاوز الطرح الصهيوني، فيما تجاوز البعض الآخر ذلك بكثير من الحذر، ورأوا أن الصهيونية أنهت مشروعها، ويجب على إسرائيل أن تتحوّل إلى دولة لجميع مواطنيها، الأمر الذي يحتّم عليها تغيير كثير من القوانين الخاصة باليهود فقط (هناك قرابة مليوني فلسطيني داخل إسرائيل هم خمس تعداد الدولة المذكورة، وهم مواطنون من الدرجة الثالثة أو الرابعة، وخاصة بعد قانون “يهودية الدولة”2018 ).
أما الظاهرة نفسها، ظاهرة المؤرخين الجدد فهي ظاهرة نيئة غضّة، ما زالت في الأطوار الأولى ولا يمكن إطلاق الحكم عليها بشكل نهائي ومحدد، ومجالها الرئيس في أوساط أكاديمية يسارية، ولا تملك تاثيراً على الجمهور الواسع المتعدد والمتنوع وخاصة الأوساط اليمينية ذات التأثير الملحوظ في الشارع الإسرائيلي، كما أن هذه الظاهرة تتفاعل داخل المجتمع الإسرائيلي ذاته وغير موجهة إلى الخارج، ضمن آليات وديناميكيات تعوّد عليها المجتمع الإسرائيلي بسبب طبيعة تركيبته وفلسفته، وبالتالي فإن ممثلي هذه الظاهرة لا يتعرضون للنبذ أو الملاحقة أو المطاردة، بل يعتبرون خيوطاً رئيسية طبيعية داخل النسيج الإسرائيلي وجزءاً لا يتجزأ منه.. هذا قبل الحرب على غزة وإبادتها، إذ أن المؤرخين هؤلاء تماهوا مع خطاب حكومتهم الفاشية، وانقلبوا على أعقابهم ، مبرّرين ومصفّقين للذبح والهدم والتشريد، واعتقد أن هذه الظاهرة ستتحوّل إلى أبواق نازيّة، وقد يفلتُ البعض من هذا الوباء، ويخرج إلى فضاء بابيه أو ساند.. ربما!
في روايتنا نواقص وعتمات
والأهم من هذا كله، أن تناولنا للمؤرخين الجدد الإسرائيلين هو تبخيس لروايتنا نحن! وربما يجدر القول هنا إن روايتنا نحن أيضاً عن النكبة فيها زوايا معتمة كثيرة، وإن لحمتها الأساسية لم تذكر حتى الآن، ولم نؤصّلها!
وربما يجدر القول إننا نحن بحاجة إلى مؤرخين جدد وليس هم، فالمحرقة في قطاع غزة والفظاعات في القدس والضفّة، والتهجير والمذابح والطرد والهروب وبيع الأراضي وتخاذل معظم القادة وتواطؤ المسؤولين، تم السكوت على معظمه حتى الآن. نحن لا نحتاج إلى مؤرخين جدد إسرائيليين ليؤكدوا ما نتعرّض إليه من فناء، وتهجير وطرد، وزيف الرواية الرسمية الصهيونية، فنحن نعرفها وهي مطبوعة بالنار والبساطير والسواطير على جلودنا وأرضنا، ولا نحتاج إلى قراءتها بالطرائق السابقة، ولكننا بالتأكيد بحاجة إلى مَن يكتب عنا، عن الهزيمة التي تطوي تحت جناحها عادة كمّاً هائلاً من الأخطاء والخطايا والخيانات. هذا ما نحن بحاجة إليه فعلاً. وبالتالي، فإن احتفالنا بباحث إسرائيلي يكتب عن جزء من عذاباتنا كأننا لا نصدق عذابنا إلا إذا جاء من عدوّنا، وكأننا نحتاج شهادة الجلاد حتى نصدق أننا ضحيّة؟