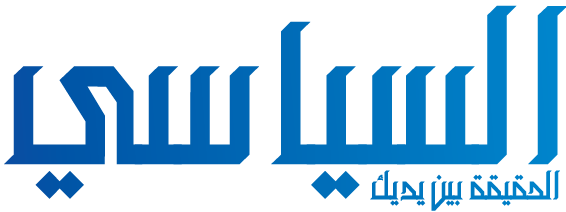على مدار العقود الماضية، بنى الفلسطينيون آمالهم على المؤسسات الدولية، ورأوا فيها ملاذاً للحق، ومرجعاً للعدالة، وملجأ لأصحاب الحقوق المهدورة، وأداة لإلزام الاحتلال بقرارات طالما تجاهلها.
وُضعت الملفات أمام الجمعية العامة ومجلس الأمن، رُفعت القضايا إلى محكمة العدل والمحاكم الدولية، استُصدرت قرارات لا تُعد ولا تُحصى، لكن ما الذي تحقق فعلاً؟ الجواب موجع، لكنه واضح، لا شيء يُذكر، ما زلنا تحت الاحتلال، وما زالت المستوطنات “تُفَرِّخ” وتتمدد، وما زالت النكبة مستمرة بأشكال متجددة.
الحقيقة التي باتت واضحة اليوم، والتي نرفض أحياناً الاعتراف بها، هي أننا صدقنا كذبة “الشرعية الدولية”، لنكتشف بعد عقود أن هذه المؤسسات، رغم هياكلها الضخمة، وأسمائها الكبيرة اللامعة، لا تملك القدرة، ولا الإرادة، لإقامة العدل، أو إحقاق الحقوق، في عالم القوة، حيث تتحكم واشنطن بمفاتيح الفيتو، وتوازن القرارات، ما جعل من هذه المؤسسات مرآة تعكس مواقف الدول المؤثرة، لا أكثر.
عشنا طويلاً مع هذا الوهم، ظننا أن تراكم القرارات والبيانات سيؤدي – يوماً ما – إلى تغيير جذري، لكنها لم تتجاوز كونها حبراً على ورق. شجب وتنديد، ودعوات لضبط النفس، أو أخرى بلا آلية تنفيذ، وحتى إن وُجدت، فلا تُنفّذ، فلا نية لذلك أصلاً، أو ربما توصيات لا تخرج من أروقة القاعات الفخمة.
ما دفعناه ثمنًا لهذا الوهم كان كبيراً؛ عقم سياسي، مراهنة مستمرة على السراب، وتأجيل لا نهائي لمواجهة الواقع، عُلقت قضيتنا بين “شرعية دولية” لا تتحرك، وميدان لا يرحم، وبينما كان العالم ينشغل بإصدار البيانات والتصريحات “المتوازنة”، مخافة اتهامه بمعاداة السامية، كان القطاع يُباد، والقدس تُبتلع، والضفة تُقطّع، ويُكرّس الاحتلال، ويتوسع الاستيطان.
خلال العدوان على غزة، وقفت الولايات المتحدة “سدّاً” منيعاً أمام إصدار أي قرار من مجلس الأمن، يدين الاحتلال أو يأمر بوقف الإبادة، وحتى عندما صدر، كان مُفرَّغًا من جوهره، تكرر المشهد – سابقاً – مرة تلو الأخرى، ومع كل مجزرة كان يرتكبها الاحتلال، كانت المنظومة الدولية تعبر عن قلقها وبدرجات متفاوتة، رغم ذلك، استمرت الجريمة دون رادع، وكأن أحداً لم “يقلق” مطلقاً.
مأساة الفلسطينيين لم تكن فقط في حجم الظلم الواقع عليهم، بل أيضًا في طبيعة الرهان، لقد اختُزل تاريخ نضالهم الطويل في استراتيجية كسب “المعركة” القانونية، في حين أن ميزان القوى على الأرض لم يكن يوما لصالحنا. تراكمت القرارات على رفوف النسيان، وأفرغت الشرعة الدولية من مضمونها يوم لم تُقرن بآلية تنفيذ، أو ضغوط فاعلة، والأخطر من ذلك كله، أن هذا الرهان جرّد الفلسطيني من أدوات الفعل، وخلق حالة انتظار عقيمة، كانتظار سراب في صحراء لا تُنبت عدالة.
المشكلة ليست في النصوص، بل في وهم السيادة، وغياب الإرادة لدى هذه المؤسسات، التي لا تملك سلطة مستقلة، ولا قدرة حقيقية على فرض العدالة، أو إحقاق الحقوق، تتحدث فقط حين يسمح لها، وتصمت حين يُطلب منها، وكثيراً ما تُستخدم كأداة تجميل لواقع قبيح، لا لتغييره.
ما من شك ان صدمتنا بالمؤسسات القضائية كانت أكبر، فهي لم تختلف كثيراً؛ رأينا سرعة غير مسبوقة في قضايا أخرى، أقل إلحاحاً، مقابل تأخير شديد ومقصود في اتخاذ الإجراءات عندما يُسفك دمنا، لتظهر ازدواجية المعايير وعجزها المطلق، بوضوح مفضوح.
هذا ليس دعوة للانسحاب من المؤسسات الدولية، بل دعوة لفهمها على حقيقتها، فهي ليست مُخَلِّصاً، ولا مستقلة، بل هي انعكاس لموازين القوى، لم تكذب علينا، بل نحن من صدق أنها قادرة، وبالتالي نحن بحاجة إلى أن نعيد بناء أدواتنا، ونتوقف عن انتظار عدالة لن تأتي من مجالس لا تجتمع إلا بعد فوات الأوان، آن الأوان لأن نفتح أعيننا، ونبني استراتيجيات وسياسات لا تعتمد على وهم العدالة، بل على قوة الحق.
مأساة الفلسطينيين لم تكن فقط في حجم الظلم الواقع عليهم، بل أيضًا في طبيعة الرهان، لقد اختُزل تاريخ نضالهم الطويل في استراتيجية كسب “المعركة” القانونية، في حين أن ميزان القوى على الأرض لم يكن يوما لصالحنا.