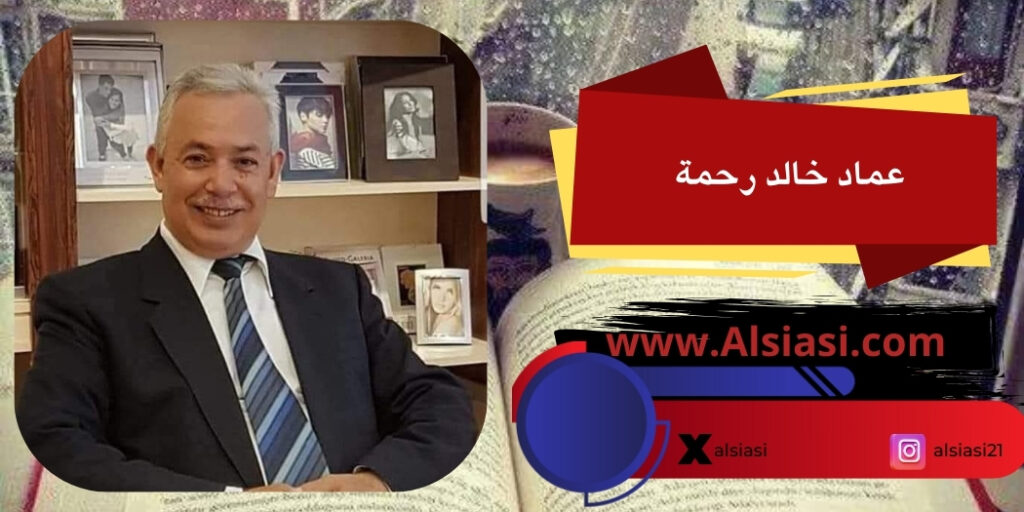بلغ الواقع العربي من التعقيد والتردّي ما لم يبلغه أي زمن سابق، حتى غدا مشهداً فوضوياً يختلط فيه العبث بالجدّ، والمأساة بالمهزلة، والعقل بالوهم. إنه واقع بلغ حدًّا من الانهيار جعل الإنسان العربي يفقد البوصلة، ويتيه في ركام الأيديولوجيات والشعارات، حتى لم يعد يفرّق بين الحقيقة والزيف، ولا بين تغريد البلابل ونعيق الغربان. ولسنا هنا أمام قراءة تشاؤمية بقدر ما نحن أمام توصيفٍ عيانيٍّ لمسرح سياسيٍّ عبثيٍّ تتقاطع فيه الأقنعة وتتبدّل فيه الأدوار.
لو طُلِب من كتّاب مسرح العبث في القرن العشرين، كـ«يوجين يونسكو» و«صموئيل بيكيت» و«ألبير كامو»، أن يكتبوا مسرحية تجسّد ما يحدث في العالم العربي اليوم، لاعتذروا جميعاً. فخيالهم مهما بلغ من الجرأة ما كان ليصل إلى هذا الحدّ من اللا معقول السياسي والاجتماعي. لقد تخيّل «بيكيت» في في انتظار غودو شخصيتين تنتظران الخلاص الذي لا يأتي أبداً؛ أما نحن العرب، فصرنا ننتظر الخلاص من أنفسنا، ولا نكفّ عن إعادة إنتاج الفوضى بوجوه مختلفة، حتى صار «المنقذ» جزءاً من المأساة، لا خلاصاً منها.
وما يعيشه العالم العربي اليوم لا يبتعد كثيراً عن منطق «العبث الوجودي» عند كامو، حيث يفقد الإنسان المعنى وسط نظامٍ يكرّس اللاجدوى والاغتراب. فالحروب التي سُمّيت زوراً بـ«حروب الإخوة الأعداء» جعلت من القاتل والقتيل وجهين لعملة واحدة، وألغت الحدود بين الحق والباطل، حتى صار الجميع ضحايا في مسرحيةٍ واحدة لا بطل لها.
لقد أشار «صلاح عبد الصبور» في مسرحيته مسافر ليل (1969م) إلى جوهر الشرّ الكامن في السلطة حين تتحوّل إلى قهرٍ وجوديٍّ للإنسان، فالحاكم عنده لا يقتل الجسد فحسب، بل يفتك بالروح أيضاً. وهذا ما يحدث في واقعنا العربي اليوم حيث تتجسّد علاقة الحاكم بالمحكوم في أقصى صورها ساديةً وعبثيةً في آنٍ واحد.
وإذا كان مسرح العبث الأوروبي قد نشأ كردّ فعل على دمار الحربين العالميتين وما خلّفتاه من فقدان للثقة بالإنسان والعقل، فإن المسرح السياسي العربي لم يحتج إلى حرب عالمية كي يغدو عبثاً؛ فقد صنع عبثه الذاتي بنفسه، وابتكر مسرحه اللامعقول على أرض الواقع، لا فوق الخشبة.
لقد استخدم العرب – كما قال أحد الكتّاب الفرنسيين – الدادائية والسوريالية والتجريدية في السياسة بدل الأدب والفن. فمشهد الإعلام العربي وحده كافٍ ليبرّر هذا القول: قنواتٌ تحوّلت إلى غرف عمليات، ومحلّلون صاروا جنرالات، ومذيعون أصبحوا ناطقين باسم السلطة أو المال أو الطائفة. إننا نعيش زمن «الإخراج السياسي» لا «الفعل السياسي»، حيث تُنتج المواقف كما تُنتج المسرحيات، وتُحرَّر البيانات كما تُحرَّر النصوص الهزلية في كواليس مجهولة.
ولعلّ المفكر الأميركي الياباني الأصل فرانسيس فوكوياما حين تحدّث عن نهاية التاريخ، لم يكن يقصد موت الأفكار بقدر ما تنبأ بجمودها؛ أما نحن، فقد بلغنا ما بعد الجمود نفسه، مرحلة «التحلّل الفكري»، حيث تغدو الأيديولوجيا سلعةً إعلامية، والديمقراطية لافتة تُعلَّق على بوابات الاستبداد.
إنّ العبث في السياسة العربية لم يعد تياراً عابراً، بل بنيةً قائمةً على تغييب العقل، وتشويه الوعي، وإفراغ المفاهيم من محتواها. فـ«الحرية» صارت شعاراً يُرفع لا قيمة تُمارس، و«العدالة» وعداً مؤجلاً إلى أجلٍ غير مسمّى، و«الوطن» حقل تجارب للولاءات المتنازعة.
إننا نعيش تراجيديا عربية يتداخل فيها الجدّ بالهزل، والمأساة بالملهاة، حتى صار القول القديم: «شرّ البلية ما يُضحك» وصفاً دقيقاً لحاضرٍ يثير المرارة والدهشة في آن. لقد بلغ سيل الدم الزُّبى، وبلغت المسرحية فصلها الأخير، ولم يبقَ سوى السؤال المؤلم:
هل ما زالت فينا بقايا «عنقاء» قادرة على أن تنهض من رماد هذا العبث؟