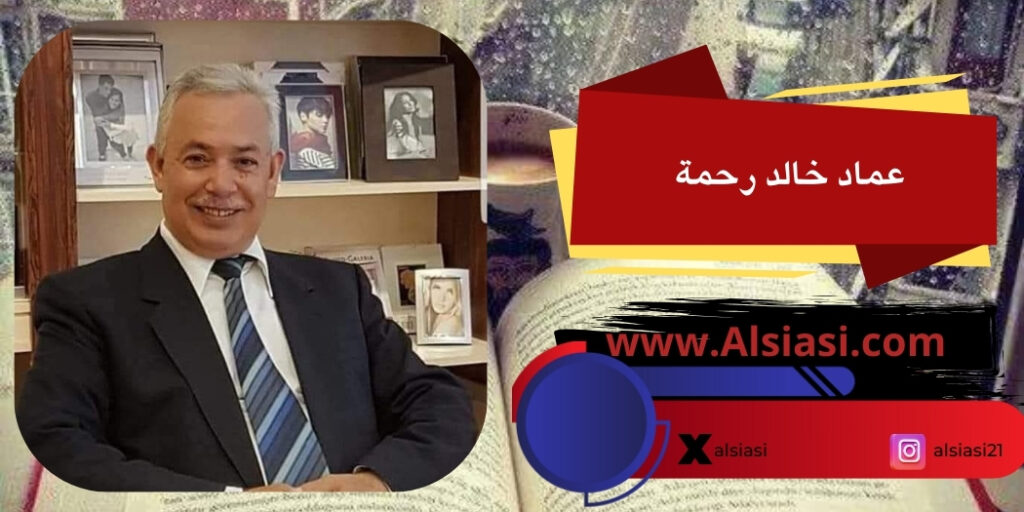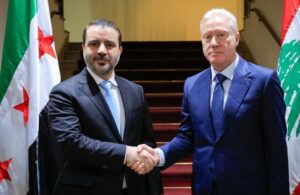تمثّل قصائد محيي الدين ابن عربي مشهداً خصباً للغموض النفسيّ والميتافيزيقيّ؛ فهي تطرح تجارب رؤيوية تخترق حدود اللغة وتستدعي أدوات تأويلية متعددة لفهمها. قصيدة «إني رأيتُ وجوداً لا أسميه» توفّر نموذجاً مركزياً لمسألة الإشارة إلى «الوجود» بوصفه تجربةٍ لا تُحتوَى باسمٍ واحد، ومن ثم تحتاج إلى منهج تراكبي يجمع الهيرمينوطيقا، التأويل الصوفي، الأسلوبية التحليلية، القراءة الرمزية والجمالية، والسيميائية لفكّ نسقها الدلالي والوظيفي. (النص الكامل للقصيدة متداول في دواوين ابن عربي).
١. الإطار التاريخي والفكري: ابن عربي ومقاربة الوجود.
_ محِيّي الدين بن عربي (1165–1240م) يشكل مرجعية محورية في التصوّف الإسلامي، لا سيما عبر مفاهيمه عن « وَحْدَةُ الوجود » وتجارب التجلّي واللمح الإلهيّ في الوجود والذات الإنسانية. فهم أبيات القصيدة داخل أفقه الفكري—الذي ركّز على علاقة الذات بالمطلق وعمق الإحاطة الإلهية—يساعد على إدراك لماذا تتكرّر في النص تيمة عدم التسمية، الإحاطة الشاملة، والذوبان في حالٍ لا تفصح عنها اللغة إلاّ بلباسٍ شعريٍّ جزئي.
٢. منهجية الدراسة:
أعتمد في هذه الدراسة مزيجاً متكاملاً من مناهج:
١ _ الهيرمينوطيقا التأويلية: لقراءة مقاصد النصّ في ضوء أفق المؤلِّف وأفق القارئ وتاريخ التعاليم الصوفية.
٢ _الأسلوبية: لتحليل بنى اللغة والصورة الشعرية والإيقاعية ومناورات المفردات.
٣ _ الرمزية والجمالية: لدراسة أثر الدلالة الإيحائية في إنتاج التأثير الوجداني.
٤ _ السيميائية: لإبراز شبكة العلامات داخل النص وكيف تنتج دلالات جديدة عبر تبدّلاتها.
٣. قراءة هيرمينوطيقية وتأويلية للنص:
العبارة الافتتاحية «إني رأيت وجوداً لا أسميه» تضع القارئ فوراً أمام تجربة رؤيوية تفلت من التسميات: إنها إقرارٌ بعجز اللغة التقليدية عن احتواء ما شهده الشاعر من «وجود» يتجاوز الأسماء المحدودة. في هيرمينوطيقا ابن عربي، هذه التجربة تُفهم كحالة توارد تجلّيّ—حيث تصير الموجودات مرآةً لحضورٍ واحدٍ شامل. لذلك، عندما يقول «فكلُّ شيء تراه فهو يحويهِ / له الإحاطة بالأشياء أجمعها» فهذا ليس مجرد كلام مبالغ بل شهادة على رؤيةٍ تصدّقها التجربة الصوفية، إذ إن الوجود المحكي هو إحاطة كلية لا تقسيم فيها بين حاكم ومحكوم: كلّ عَيْنٍ تراه ترى أنه في هذا الوجود.
٤. التحليل الأسلوبي واللغوي:
١ _ التركيب والنسق: القصيدة قصيرة لكن مركّبة بصريًا: جمل خبرية مختزلة تتراكم لتبني شعورًا بالإحاطة والتوهان (مثال: «حصلت من فكرتي فيه على تعب / ولم أجد حجة تبدو فأبديه»). الأسلوب يميل إلى الإيجاز الإيحائي.
٢_ المفردات الأساسية: «وجود»، «إحاطة»، «عمياءٌ مجهلة»، «تيه» — مفردات تحمل ثنائية المعرفة/الجهل، الحضور/الغياب. استعمال «التيه» و«العمياء» يؤكد حالة فقدان المعايير العقلية التقليدية أمام تجربة الأسرار.
٣_ التكرار والتوكيد: تكرار فكرة الشمول («كل شيء…»، «أجمعها»، «كل عين تراه») يعمل كتعزيز لسمة الكلِّية في الرؤية.
٤_ الضمائر والهوية: تحول بين «إني» القائل، والوجود «الذي ما زلت أَبْغيه»، ووصف الذات «إني أنا وصفه النفسيُّ» يشير إلى انصهار الذات بالمشهد؛ الذات هنا ليست راوية منفصلة بل وصفٌ لوجودٍ يجري فيه.
٥. البُعد الرمزي والجمالي: الصمت والاسم وعدم الاسم.
جمالياً، تختزل القصيدة مناخاً صوفياً اعتمد الصامت أكثر مما اعتمد القول: «لا أسميه» و«لم أجد حجة تبدو فأبديه». الجمال هنا ينشأ من «الإيماء» وليس التفصيل؛ فالأبيات تستدعي متعة إدراك «اللامحدود» التي تكون أعمق عندما تُلمَح أكثر مما تُقال. هذا ينسجم مع تقاليد التجربة الصوفية حيث يصبح الصمت أبلغ من الكلام، والرمز أقوى من التصريح.
٦. قراءة سيميائية: العلامة والمرموز
من زاوية سيميائية (سوسيرية-بيرسية)، «الوجود» في النص يعمل كعلامةٍ مركزيّة (Sign) يتجاوز وحدة الدال/المدلول الاعتيادية: الدال (الفظ «وجود») يتصدّع أمام تعدّد المدلولات الممكنة (إحاطة كل الأشياء، محو الهوية الفاصلة، تجربة التيه). بالتالي يعيد النص إنتاج علامةٍ فضفاضة تغذي مجالًا دلاليًّا يتَّسع لكل القراءات الصوفية والفلسفية؛ أي أن القارئ يصبح مشاركًا في توليد لحقل المعنى بدلًا من تقبّله جاهزًا.
٧. قراءة تفصيلية سطراً بسطر (إيجاز).
«فكلُّ شيء تراه فهو يحويهِ / له الإحاطة بالأشياء أجمعها»: رؤية إلهامية تُحوّل الكلّ إلى مظاهر لحضورٍ واحد.
«حصلت من فكرتي فيه على تعب / ولم أجد حجة تبدو فأبديه»: تجربة عقلانية/نفسانية اصطدمت بعجز الحجة العقلية؛ الشاعر يلجأ إلى الأبدية بوصفها مسارًا تأملياً.
«حصلتُ منه على عمياءَ مُجهلةٍ / بهماء خاليةٍ في مهمه التيه»: التيه ليس فوضى بَقاء بل حالة معرفة لا تبصرها العين/العقل.
«إني أنا وصفه النفسيُّ فاعتبروا / إن زلت زال بهذا النعت أدريه»: إعلانٌ أنّه في حدود التعبير النفسي يمكن أن يتحمل الخطأ—أي أن النعت النفسي الذي يصف الحالة ليس حقيقة ثابتة، وإذا زلّ الوصف زال الإدراك المصاحب له.
٨. البُعد النفسي-الروحي والاجتماعي:
النص يعكس مساراً روحانياً: لقاءٌ مع وجودٍ يفوق التصنيف يؤدي إلى اضطراب معرفي وانغماس وجداني. اجتماعياً، مثل هذا النص يضعه ابن عربي في موقفٍ مع قلةٍ من المتذوقين المهيّئين للتجربة الصوفية؛ لا يناسب القارئ السطحيّ الذي يبحث عن بلاغةٍ تقليديةٍ فحسب.
٩. قيود القراءة ونقاط النقد:
قد يتهم بعض النقّاد النص بالغموض المفرط الذي ينسحب على القارئ غير المتخصّص؛
كما أن الربط الحصريّ للنص بتشظٍّ من «وحدة الوجود» قد يتجاهل قراءات بديلة (وجودية/فلسفية لا دينية). لذا قراءة متناغمة يجب أن توازن بين الإطار الصوفي وفتوح النص لقراءاتٍ أخرى.
١٠. خاتمة:
تؤكد القراءة التراكمية أن قصيدة «إني رأيت وجوداً لا أسميه» هي بيان شعري عن وضعية الرؤيا الصوفية: تجربة وجودية تتجاوز الأسماء، تنتج إحاطة شاملة تؤدي إلى «تيه» معرفيّ وفناءٍّ ذي طابعٍ نفسي روحيّ. العمل التحليلي الهيرمينوطيقي والاسلوبِي والسيميائي يكشف كيف تُنتَج دلالاتٍ متعددة عبر شبكة علاماتٍ لغوية ورمزية، وكيف أن الجمالية في النص تقوم على الإيحاء والصمت واللامحدودية بدلاً من الوصف التفصيلي.
نص القصيدة:
إني رأيتُ وجوداً لا أسميه
فكلُّ شيء تراه فهو يحويهِ
له الإحاطة بالأشياء أجمعها
فكلُّ عين تراها أنها فيهِ
حصلت من فكرتي فيه على تعب
ولم أجد حجة تبدو فأبديه
حصلتُ منه على عمياءَ مُجهلةٍ
بهماء خاليةٍ في مهمه التيه
أرنو إليه ولا أدريه فانبهمت
عليَّ حالته وكلها هو هي
به خلوتُ وما بالدارِ من أحد
إذ الوجودُ الذي ما زلتُ أبغيه
إني أنا وصفه النفسيُّ فاعتبروا
إن زلت زال بهذا النعت أدريه
كظلِّ جسمي متى أن كنت ذا نظرا
في نشأتي وهو مجلى من مجاليه”