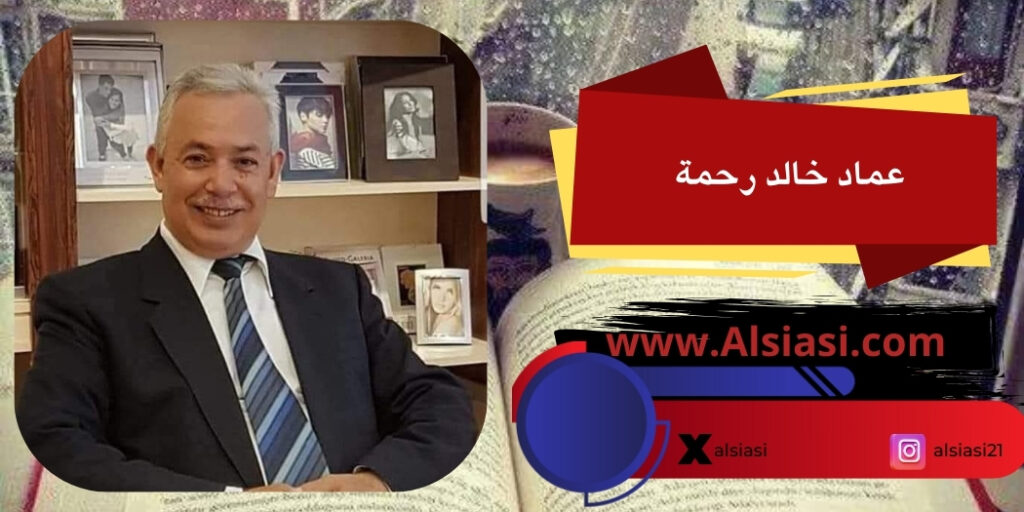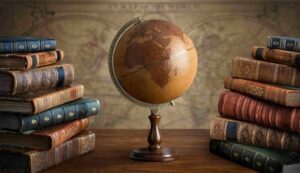منذ البدايات الأولى لتفاعل العقل الإسلامي مع الفلسفة الإغريقية، نشأ جدل متوتر بين اللاهوت بما هو إيمان وتسليم للنص المقدّس، والفلسفة بما هي سعي حر نحو الحقيقة عبر البرهان العقلي. غير أنّ هذا التوتر لم يكن قطيعة كاملة، بل أخذ صورة تداخل خصب ومركّب؛ إذ سرعان ما تشكّلت في المجال الإسلامي صيغة مخصوصة يمكن وصفها بـ الانطولوجيا التيولوجية، أي ذلك الخليط الذي يجمع بين البحث في الوجود بما هو وجود (الانطولوجيا)، وبين التفكير في العلة الأولى والغاية النهائية للوجود كما يطرحها الدين (التيولوجيا).
لقد كان الكندي، “فيلسوف العرب”، أول من مهّد لهذا اللقاء، حينما رأى أنّ الفلسفة ليست إلا “معرفة الإنسان لنفسه”، وهي معرفة لا تنفصل عن معرفة العلة الأولى. ومعه بدأ الوعي الإسلامي يكتشف أن الفلسفة لا تنقض النص القرآني، بل تضيء بعض معانيه بلغة البرهان. ثم جاء الفارابي، الذي حاول أن يبني مدينة العقل والفضيلة على صورة “المدينة الفاضلة”، رابطاً بين الوحي والعقل ضمن نظام هرمي يجعل النبوة تعبيراً رمزيّاً عن الحقائق العقلية العليا. أما ابن سينا فقد بلغ أقصى ما يمكن أن يبلغه المزج بين الانطولوجيا الأفلاطونية الجديدة والتيولوجيا الإسلامية، حينما ميّز بين الوجود الواجب (الله) والوجود الممكن (العالم)، مبيناً أنّ الكائنات تستمد وجودها لا من ذاتها، بل من الواجب المطلق.
وإذا انتقلنا إلى المعتزلة، وجدناهم قد سعوا إلى حماية فكرة التنزيه المطلق للإله عبر نظرية دقيقة في التفريق بين الجوهر والوجود. فالخلق عندهم لم يكن إلا “إكساب الجوهر الموجودية بعد العدم”، وهو طرح يلتقي في عمقه مع أسئلة الفلسفة الوجودية الحديثة حول العدم والكينونة، وإنْ بصياغة لاهوتية دفاعية. لقد أرادوا أن ينقذوا وحدة الله من أي شائبة تشبيه أو تجسيم، فجعلوا كل ما عدا الله “حادثاً” يستمد وجوده من فعل الخلق الإلهي.
ولم يكن التصوف بعيداً عن هذا المسار؛ فمع ابن عربي و”الوجودية الصوفية” إن صحّ التعبير، أصبح الله هو “الوجود الحق” وما العالم إلا تجلّياته وظلاله. هنا يتداخل الفلسفي بالميتافيزيقي بالروحي، لتتأسس رؤية تجعل من التجربة الروحية نوعاً من الأنطولوجيا الحيّة.
إن هذا المزج بين الفلسفة واللاهوت في المجال الإسلامي يذكّرنا بما قاله هيغل عن الدين والفلسفة: فالأول يقدّم الحقيقة في صورة تمثيل (Vorstellung)، والثانية تعرضها في صورة مفهومية (Begriff). وبالمثل، حاول فلاسفة الإسلام أن يثبتوا أنّ النص القرآني يمكن أن يُفهم في ضوء العقل، دون أن يفقد قداسته. لكنهم واجهوا مقاومة شديدة من التيارات التقليدية التي رأت في الفلسفة خطراً على العقيدة، حتى أنّ الغزالي، وهو المتكلم الأشعري الكبير، كتب تهافت الفلاسفة، لينقض فيه آراء ابن سينا والفارابي، خصوصاً في قضايا قدم العالم والمعاد. غير أن هذا النقض لم يُنهِ الحوار، بل دفع ابن رشد إلى كتابة تهافت التهافت، مؤكداً أنّ “الحكمة والشريعة أختان بالرضاع”، وأنّ النص الديني لا يناقض العقل بل يدعوه إلى التأمل.
إنّ ما نلمحه هنا هو أنّ المجال الإسلامي قد قدّم نموذجاً فريداً في تاريخ الفكر العالمي: فهو لم ينغلق في لاهوت محض كما في بعض المراحل المسيحية الوسيطة، ولم ينفصل عن الدين كما في بعض تجارب الحداثة الغربية، بل أنتج خليطاً مركّباً يمزج بين العقل والإيمان، بين الانطولوجيا والميتافيزيقا والتيولوجيا.
وقد لاحظ محمد عابد الجابري أنّ هذا المزج لم يكن دائماً متناغماً؛ إذ انقسم العقل الإسلامي إلى “برهاني” (ابن رشد)، و”بياني” (المتكلمون)، و”عرفاني” (المتصوفة). غير أنّ هذا التعدد في ذاته يعكس غنى التجربة الإسلامية، وقدرتها على استيعاب المختلف وإعادة صياغته ضمن أفقها الخاص.
وبهذا المعنى يمكن القول: إنّ الانطولوجيا التيولوجية الإسلامية ليست مجرد استيراد لمقولات يونانية، ولا مجرّد ترديد للنصوص المقدسة، بل هي عملية تركيب تاريخية وثقافية وفكرية، أنتجت خطاباً فلسفياً ذا طابع خاص. خطاب يواجه إشكالية أساسية: كيف يمكن للعقل أن يكون حرّاً دون أن يفقد الإيمان؟ وكيف يمكن للإيمان أن يكون خالصاً دون أن يتجاهل العقل؟
إنها أسئلة ما تزال راهنة اليوم، حيث نعيش في عالم يمزّقه صراع بين العقلانية المتطرفة والروحانية المغلقة. ولعلّ الدرس الذي يمكن أن نتعلمه من تجربة الفلاسفة المسلمين هو أنّ الحقيقة ليست ملكاً للعقل وحده ولا للوحي وحده، بل هي ثمرة حوار دائم بينهما.