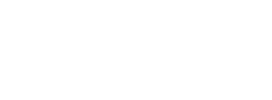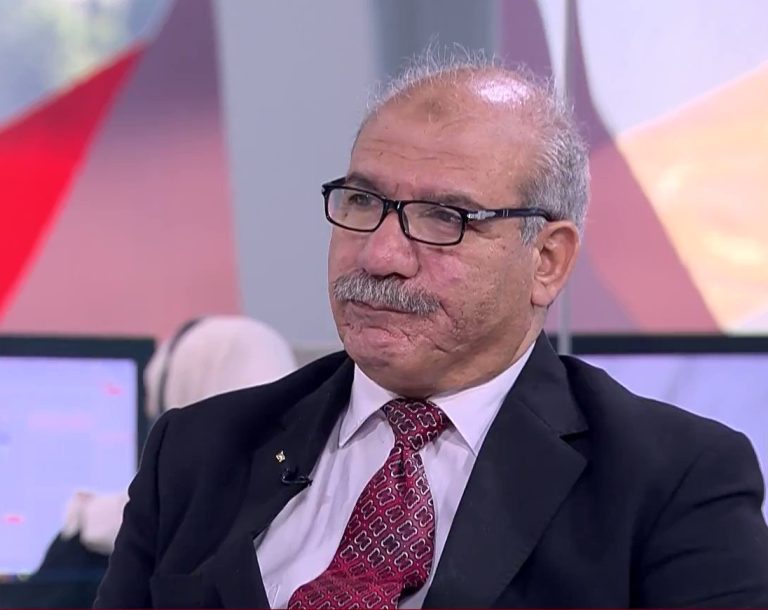في ساعة متأخرة من ليل باريس، أيقظني من نعاسي، صوت صديق إيراني عبر الهاتف يريد أن يعرف مَن أظنه سيكون الرئيس القادم للولايات المتحدة. وبينما أتمتم بحثاً عن إجابة، أسرع المتصل البعيد إلى استعجال الإجابة: إذن مَن سيفوز؟
قلت: «الفائز سيكون النظام الأميركي»، وأدركت على الفور أن هذا قد يبدو أقرب إلى المراوغة منه إلى الإجابة الصحيحة.
ومع ذلك، بقيت متمسكاً بإجابتي، وذلك لعلمي أن طرحي أياً من دونالد جيه ترمب أو كامالا هاريس على أنه الفائز المحتمل، سيُفضي إلى سيل من التكهنات حول ما سيحدث إذا انتهى به المطاف إلى البيت الأبيض.
في الواقع، هذا السيل الجارف من التوقعات مستمر بالفعل منذ أسابيع، مع طرح الخبراء دفقات ضخمة من التنبؤات المتناقضة. على سبيل المثال، تزعم صحيفة «واشنطن بوست»، التي تقف بقوة خلف هاريس، أن فوز ترمب سيدفع العالم إلى ثلاثينات القرن العشرين، عندما أسفر شعار «القوة هي الحق» عن اشتعال الحرب العالمية الثانية.
وفي الطرف الآخر من الطيف السياسي، يزعم أنصار ترمب في «ماكس نيوز»، أن فوز هاريس قد يحوِّل الولايات المتحدة إلى نسخة راقية قليلاً من دول العالم الثالث.
وشكَّل الاعتقاد بأن الولايات المتحدة في حالة انحدار، موضوع كثير من البرامج الحوارية التلفزيونية هنا في باريس، حيث أقضي بعض الوقت.
ويختلف المتحدثون في ما بينهم حول أيّ المرشحَين سيبطئ أو يسرع وتيرة هذا الانحدار في فترة ولايته، لكنهم جميعاً يتفقون على أن المستقبل ينتمي إلى الصين، بوصفها زعيمة نظام عالمي جديد، أقصى طموحات الولايات المتحدة فيه الاضطلاع بدور الوصيف.
في الواقع، فكرة أن الولايات المتحدة في طريقها إلى أن تصبح قوة عظمى «سابقة» ليست جديدة. مثلاً، في عشرينات القرن العشرين، اعتقد أشخاص مثل أرماند هامر أن المستقبل ينتمي إلى القوة السوفياتية الناشئة و«الرجل الاشتراكي الجديد» الذي كان يُخلق. وفي ثلاثينات القرن العشرين، تطلع أشخاص مثل تشارلز ليندبيرغ إلى ألمانيا، بوصفها القوة العالمية المستقبلية، والحكم على مصير البشرية. وفي ستينات القرن الماضي، كانت كل الرهانات على اليابان، وفي السبعينات راهن علماء المستقبل على فرنسا.
ويتحدث بعض الخبراء عن نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، حيث ستشكل الولايات المتحدة قطباً بين أقطاب عدة. إلا أن مثل هذا التحليل معيب في جوهره، ببساطة لأن الأقطاب من المفترض أن تكون نقطتين متعارضتين تتوازنان لمنح النظام العام الاستقرار.
بعبارة أخرى، لا يمكن أن يكون هناك كثير من الأقطاب هنا وهناك وفي كل مكان، بل في بعض الأحيان تكون متصلة بعضها ببعض مثل التوائم السيامية.
على أي حال، تظل الحقيقة أن الولايات المتحدة «الأمة التي لا غنى عنها»، كما كانت على الأقل على امتداد القرن الماضي أو نحو ذلك.
والحقيقة أن الحروب المستعرة في أوكرانيا والشرق الأوسط لن تنتهي، من دون أن تقدم واشنطن التوجيه والإلهام اللازمين، بدعم من القوة العسكرية والاقتصادية والقوة الناعمة، على نحو لا تستطيع أي دولة أخرى تقديمه، في الوقت الحاضر. وينطبق الأمر نفسه عندما يتعلق الأمر بالإصلاحات الكبرى المطلوبة في هيكل الأمم المتحدة ووكالاتها، إلى جانب المراجعة، التي طال انتظارها، لقواعد التجارة العالمية.
وفيما يتعلق بالانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني ) المقبل، يتركز السؤال حول ما الذي يمكن أن يقدمه المرشحان بشأن هذه القضايا… والجواب: ليس الكثير.
الواقع أن الانتخابات الرئاسية الأميركية، مثلما أشار الجنرال ديغول ذات يوم إلى الانتخابات الرئاسية في كل مكان، نادراً ما تدور حول سياسات ملموسة. وقد شدد الجنرال الفرنسي على اعتقاده بأن «الانتخابات الرئاسية أشبه بموعد لقاء بين رجل وأمة». (والآن، ربما أصبحت أشبه بموعد بين رجل وامرأة).
الملاحَظ أن الحملة الرئاسية الأميركية الحالية ركزت على شخصيات المرشحين لا على السياسات. من جهته، لطالما صوَّر المرشح الجمهوري ترمب نفسه بوصفه شخصية ذكية، وليس خبيراً محنكاً في السياسة. وكانت حملته الانتخابية أشبه بمونولوغ طويل يكشف فيه عن نفسه، بكل عيوبه، ويدعو الناخبين إلى الحكم عليه بصفته شخصاً. ومن المثير للاهتمام أن خصومه، بمن في ذلك هاريس، رقصوا على موسيقاه، من خلال جعله هدفاً لهجمات شخصية لم يسبق لها مثيل في تاريخ الانتخابات الأميركية.
ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أن ترمب تجنب تناول جميع القضايا. الحقيقة أنه فعل ذلك بطريقة غير مباشرة، عبر سرد قصة تلفت الانتباه إلى قضية ما، من دون إخضاعها للتحليل الكلاسيكي. وقد وصف خصومه هذه الطريقة بأنها مجرد كذب.
ومع ذلك، ساعد هذا الأسلوب ترمب على إقناع أنصاره بأنه «واحد منَّا»، أي مرشح مناهض للمؤسسة يتقاسم معاناتنا وتطلعاتنا.
في المقابل، وقعت هاريس في شرك التناقضات، فهي لم تكن راغبة في تحمل السجل الكامل للرئيس جو بايدن، وفي الوقت ذاته امتنعت عن رفضه. لقد راودتها فكرة تقديم نفسها بصفتها خبيرة بالسياسة، ولكنها اضطرت إلى التراجع لأنها تحاول تشكيل تحالف من الأقليات ذات المصالح والتطلعات المتنوعة، إن لم تكن المتناقضة.
وعبر مواصلة مونولوغه الذي لا ينتهي، يخبر ترمب الناخبين أكثر فأكثر عن نفسه. على النقيض من ذلك، تعمد هاريس إلى الحديث لإخفاء نفسها، فكلما استمعتَ إليها أكثر تضاءل ما تعرفه عنها.
وفي الوقت الذي ينتقد معارضو ترمب أنانيته ويشيدون بإيثار هاريس، نجد في حقيقة الأمر أن أنانية ترمب حقيقية، في حين أن إيثار هاريس مصطنَع. والمثير أن تدخل باراك أوباما في الحملة الانتخابية أضرَّ بهاريس، بدلاً من مساعدتها، من خلال خلق حالة من الارتباك حول الشخصية الجديدة التي حاولت بناءها.
إلى جانب ذلك، لم تفلت الانتخابات الحالية من الكليشيهات المعتادة عن «التاريخي» أو «صنع العصر». ومع ذلك، من غير المرجح أن يتغير موقف الولايات المتحدة الاستراتيجي واسع النطاق بشأن القضايا الرئيسية، بغضّ النظر عمّن يفوز. والمؤكد أنه في السادس من نوفمبر، سترتفع مؤشرات «وول ستريت»، ولن تخرَّ السماء على الأرض. وتتركز القضية الحقيقية في هذه الانتخابات في: أيٌّ من المرشحَين الاثنين سيشعر الأميركيون، أو على الأقل 50 في المائة من الناخبين، بأنه أقرب إليه. وهذا في حد ذاته سؤال ضخم لدرجة تكفي لجعل هذه الانتخابات تاريخية.