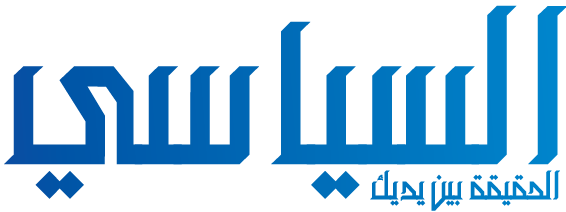في صباحٍ لم يُشبه ما قبله، انكسر ميزان الشرق، وارتجّ وجدان العالم. السابع من أكتوبر لم يكن تاريخًا عاديًّا يُضاف إلى تقويم المأساة الفلسطينية، بل لحظة انفجارٍ كثيف، تلاقى فيها الغضب المكبوت منذ سبعة عقود مع شهوة الحرية المستحيلة، فاصطدمت الأيديولوجيا بالدم، واصطدم الضمير العالمي بالجدار. في هذا اليوم، لم تكن غزة تقاتل كعادتها لتتجنب الموت، بل اندفعت بشراسة المظلومين لتصنع المعادلة المستحيلة بين الانتحار والانتصار.
لم يكن ما حدث صباح السابع من أكتوبر سوى صرخة مبحوحة من أعماق الذاكرة الجمعية الفلسطينية، تلك الذاكرة المنهكة بالمذابح، والمخيمات، والجثث المعلقة على مشانق الصمت العربي والتواطؤ الدولي. لم يكن يومًا نبت من فراغ، بل نتيجة حساب دموي طويل في دفتر الاحتلال، الحساب الذي سُطّر بطفل وُلد في حصار، وشاب نشأ في خيمة، وجدّة ماتت تنتظر تصريحًا للدواء، وأسير يُعدّ أيامه بلون القضبان.
العقل السياسي في المنطقة والعالم حاول أن يُقارب ما جرى بعين باردة، يضع الحدث في ميزان الربح والخسارة، يتساءل عن جدوى “المفاجأة”، وعن منطقية التصعيد، وعن حجم الخسائر في الجانب الفلسطيني، متغاضياً عن جذر الجريمة الأم: الاحتلال. هذا العقل الذي تجرّد من كل بعد أخلاقي وإنساني، يتحدث عن غزة وكأنها مُدانة أصلاً بوجودها، وكأن أهلها ليسوا بشراً من لحم ودم، بل فائض غضب يجب تدجينه أو حرقه.
أما العاطفة، فهي التي تسكن قلب كل فلسطيني وعربي حرّ، العاطفة التي انفجرت في شكل زغاريد وسط أنقاض البيوت، ودموع تُذرف لا من ألم الخسارة بل من فرط الاعتزاز، العاطفة التي رأت في هذه الهبّة استردادًا للكرامة، وخرقًا لجدار العجز. غزة لم تُعلن الحرب يومها، بل أعلنت أنها ما زالت حيّة، رغم حصار البحر، وقصف الليل، وخيانة القريب.
السابع من أكتوبر هو اليوم الذي شهدت فيه إسرائيل ما لم تشهده منذ تأسيسها، لحظة اختراقٍ لما كانت تعتبره أمنًا مقدسًا. هو أيضًا اليوم الذي أراد فيه الفلسطيني أن يُعيد طرح قضيته على الطاولة الدولية بأسلوب مغاير: ليس من موقع الضعف، ولا كضحية تستجدي التعاطف، بل كقوة قررت أن تقلب المعادلة حتى لو دفعت الثمن باهظًا. في هذا اليوم، تحررت فلسطين – ولو مؤقتًا – من دور الضحية، وتقمّصت دور الفاعل.
لكن، يبقى السؤال المؤلم: هل ما حدث انتصار أم انتحار؟ هل تحررت غزة حقًا أم أنها اقتربت أكثر من فوهة الجحيم؟ هنا بالضبط يتصارع العقل مع العاطفة، وتبدأ المعضلة الأخلاقية التي لا إجابة سهلة لها. منطق الدولة يقول بأن الدم لا يصنع مجدًا دائمًا، وأن أرواح الأطفال لا تُقايض في سوق السيادة. أما منطق الأرض، فمنقوش على جدران الكرامة: لا حرية بلا تضحية، ولا كرامة بلا مقاومة.
في زمن اختلطت فيه مفردات الشهادة بالإبادة، والمقاومة بالإرهاب، لم تعد الكلمات تفي بالغرض، ولم يعد العالم قادرًا على فهم مشهد طفل يخرج من تحت الأنقاض ليهتف “أنا فلسطيني”. في السابع من أكتوبر، أعاد الفلسطيني كتابة سرديته بدمه، لا بقلم موظف في الأمم المتحدة. انتصر على فكرة الغياب، وفرض حضوره كقضية لا تموت.
ربما كانت غزة تعرف منذ البداية أن الطريق لن يكون معبّدًا بالورود، وأن الانتفاض في وجه المستحيل لا يعني النصر الفوري، لكن يكفيها أنها أعادت للمنطقة كلّها السؤال المنسي: من نحن؟ وماذا نفعل هنا؟ وكيف نقبل أن نبقى عبيدًا لخرائط رسمها المستعمر، وأنظمة لا ترى في فلسطين سوى عبء على ميزانية الكلام؟
في السابع من أكتوبر، سقطت أقنعة كثيرة، وانكشفت عورات الدبلوماسية الكاذبة، واتضح من هو مع فلسطين بالفعل ومن يكتفي بحبّها في السر. وربما لهذا السبب تحديدًا، كان لا بد لغزة أن تفعل ما فعلت، أن تشتعل في لحظة يأس لتحرق معها صمت العالم، وتقول بأن الانتحار أحيانًا ليس نهاية الحياة، بل بداية حكاية جديدة.
غزة لم تنتصر بالسلاح، ولم تهزم بالدمار. انتصرت فقط لأنها أعادت تعريف الصراع: ليس بين قوتين غير متكافئتين، بل بين شعب لا يملك شيئًا إلا إرادته، وكيان يملك كل شيء إلا الشرعية. ومن هنا، تبدأ المعركة الحقيقية: بين ذاكرة الجلاد، ودم الضحية الذي يرفض أن يجف.
السابع من أكتوبر ليس تاريخًا عابرًا في رزنامة الحرب، بل لحظة فاصلة في رحلة وعي أمةٍ بأكملها. لحظة قالت فيها فلسطين، للمرة الألف، إن موتها كذبة، وإنها باقية ما دام فيها قلب ينبض بالحلم، ولو وسط الرماد.
فهل كان السابع من أكتوبر انتحارًا؟ أم انتصارًا؟
الجواب قد لا يكون في المقالات ولا التحليلات… بل في أعين طفلٍ خرج من تحت الأنقاض، ومسح التراب عن جبينه، وقال للعالم: “أنا حي… إذن فلسطين باقية.”