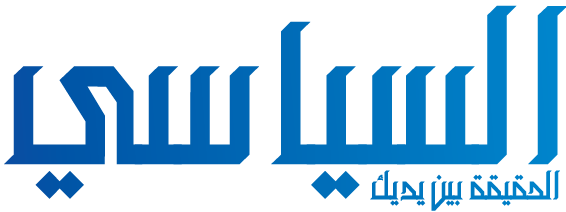في شوارع إسطنبول التي تتشبث بجذورها العثمانية بينما تندفع نحو حداثةٍ عاصفة، تتنفس تركيا هواءً سياسيًا مشحونًا بالأسئلة المصيرية. رجب طيب أردوغان، الرجل الذي حكم البلاد لعقدين كاملين، وصنع من نفسه أيقونةً تجمع بين الحلم الإسلامي والعظمة العثمانية، يبدو اليوم وكأنه يقف على حافة منحدرٍ تاريخي. الاقتصاد المنهار، الشارع الغاضب، والمعارضة التي تتحدى أسطورة “الزعيم الذي لا يُهزم”، كلها عوامل تدفع نحو سؤالٍ واحد: هل تشهد تركيا بداية النهاية لعصر أردوغان، أم أن الرجل القادم من حي قاسم باشا الفقير سيُعيد اختراع معجزته السياسية مرة أخرى؟
الاقتصاد كان دائمًا ورقة أردوغان الرابحة، فمع وصوله إلى السلطة عام 2002، حوَّل البلاد من دولةٍ على وشك الإفلاس إلى قوةٍ ناشئة ببنية تحتية عملاقة ونموٍ سنوي تجاوز 7%. لكن اليوم، تحولت “المعجزة” إلى كابوس: الليرة التركية التي كانت تُقابل 1.5 للدولار عام 2012، صارت تحتاج إلى 32 ليرة للدولار الواحد في 2023. التضخم يقفز فوق رؤوس الفقراء كوحشٍ كاسر، فسعر كيلو اللحم الذي كان بـ25 ليرة قبل عشر سنوات، صار بـ400 ليرة. الشباب الذين رأوا في أردوغان رمزًا للفرص الجديدة، يعيشون الآن على قروضٍ بفوائد عالية، أو يفرون إلى أوروبا بحثًا عن مستقبل. حتى القهوة، رمز الثقافة التركية، صارت رفاهيةً في مقاهي إسطنبول الفاخرة، حيث يراقب المثقفون بسخريةٍ مريرة تحولَ شعار “سنبني تركيا جديدة” إلى “كيف ننجو من الغد؟”.
في خضم هذا الانهيار، تتحرك المعارضة كقطارٍ يكتسب سرعة. كمال كليتشدار أوغلو، الزعيم الهادئ الذي يجمع بين الصورة الأبوية للسياسي العجوز والخطاب الثوري للشباب، نجح في توحيد تحالفٍ غير مسبوق: قوميون غاضبون من سياسات المصالحة مع الأكراد، علمانيون حالمون بعودة زمن أتاتورك، وحتى أكرادٌ مستاؤون من وعود أردوغان المكسورة. لم تكن الانتخابات البلدية عام 2024 مجرد صفعةٍ لأردوغان، بل إعلانًا بانتفاضة المدن الكبرى. إسطنبول، المدينة التي قفز منها أردوغان إلى السلطة، منحته صفعةً تاريخية بفوز أكرم إمام أوغلو، الرجل الذي حوَّل شعار “كل شيء سيكون على ما يرام” إلى نغمةٍ يرددها اليائسون. حتى في الأناضول، معقل المحافظين، بدأت أصوات تُهمس: “كفى وعودًا.. نحن نريد خبزًا”.
لكن تركيا ليست دولةً بسيطة تُختزل في أرقام اقتصادية أو انتخابات. الصراع هنا أعمق من ذلك: إنه معركة هوية. من يزور إسطنبول يرى التناقض عاريًا: سيدات محجبات بفساتينَ مطرزةٍ بعلاماتٍ أوروبية يسيرن أمام مقاهٍ ترفع علم المثليين، شبانٌ يهتفون ضد الحجاب في الجامعات بينما تُسمع أصوات الأذان من مآذن آيا صوفيا. أردوغان، الذي حوَّل المساجد إلى رمزٍ سياسي وأعاد آيا صوفيا إلى سابق عهدها، يعرف جيدًا أن معركته ليست ضد المعارضة، بل ضد “التغريب” الذي يراه سرطانًا ينهش جسد الأمة. لكن خطابه الديني لم يعد كافيًا: فالشاب الذي يبحث عن عملٍ لا يهتم بكون الرئيس يصلي أم لا، بل بكون راتبه يكفي لدفع إيجار غرفته.
السياسة الخارجية، التي كانت سلاح أردوغان السري، تحولت إلى عبءٍ ثقيل. العلاقة مع الغرب تشبه زواجًا بلا حب: فتركيا عضوٌ في حلف الناتو لكنها تشتري أسلحةً من روسيا، وتتفاوض مع الاتحاد الأوروبي بينما تهدد بإغراقه باللاجئين. التدخل في سوريا وليبيا حول الجيش التركي إلى لاعبٍ إقليمي، لكنه كبَّد الاقتصاد تكاليف باهظة. حتى اللحظة التي صافح فيها أردوغان محمد بن سلمان أو السيسي، رآها مؤيدوه السابقون خيانةً لـ”القضية الإسلامية”. لكن الرئيس التركي، الذي يعرف أن السياسة لا مكان فيها للعواطف، يبدو مستعدًا لبيع أي حليفٍ مقابل شريان حياةٍ اقتصادي.
وسط هذا العاصف، يبقى السؤال: كيف ما زال أردوغان قائمًا؟ الإجابة تكمن في آلةٍ سياسيةٍ صنعها بحرفية. من خلال السيطرة على الإعلام (90% من القنوات التلفزيونية مؤيدة له)، وتحويل المؤسسات الدينية إلى منابر دعاية، وربط مصير ملايين المواطنين بالمنح الحكومية، نجح في تحويل السياسة إلى شبكة مصالح معقدة. حتى اتهامات الفساد التي طالت عائلته وأقرباءه، مثل صهره بيرات ألبيرق، لم تُسقطه، لأنها – كما يقول منتقدوه – “فسادٌ منهجٌ وليس أخطاءً فردية”.
لكن التاريخ يُذكرنا أن كل الإمبراطوريات تنهار من الداخل. هل يمكن لتركيا أن تشهد رحيل أردوغان سلميًا عبر صناديق الاقتراع؟ أم أن الرجل الذي نجا من انقلابٍ عسكري دموي عام 2016، سيشدّد قبضته الأمنية، مُحولًا البلاد إلى ديكتاتورية مفتوحة؟ الأسوأ من ذلك: هل ستتحول تركيا، ذات الموقع الجيوسياسي الحساس، إلى ساحة صراعٍ بين قوى داخلية وخارجية، كما حدث في دول الربيع العربي؟
المفارقة الكبرى أن أردوغان نفسه هو من زرع بذور سقوطه. بوعوده الكبيرة، صنع جيلًا من الشباب الطموح الذي لم يعد يقبل بالشعارات. بسياساته الخارجية الطموحة، فتح الباب أمام منافسين أقوياء. وبتحالفه مع الإسلام السياسي، أثار غضب النخبة القديمة التي تنتظر دورها للانتقام. اليوم، بينما يقف على شرفة القصر الرئاسي بأنقرة، ربما يتذكر مقولته الشهيرة: “العالم كبير، لكن تركيا أكبر”. لكن السؤال الذي يطارده الآن: هل تركيا كبيرة بما يكفي لاحتواء سقوطه؟