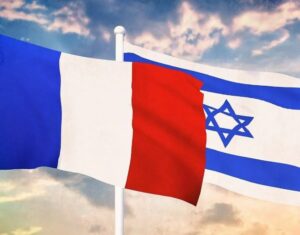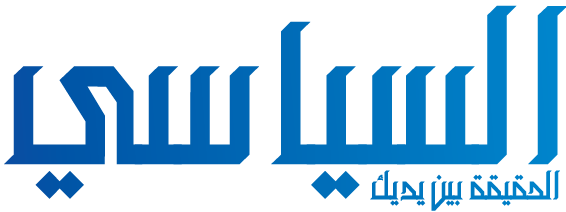تنتقد النُّخب السورية مطالبة الأقليات القومية بحقوقها، وتصفها بالطرح الغربي الساعي إلى تفتيت البلاد، من دون البحث في جذر غياب أيّ مادة دستورية تصون حقوق تلك القوميات وفقاً للأبعاد الوطنية. علماً أن قمع الأقليات القومية وسحقها كانا من بين أسباب الدمار والخراب في أوروبا. لذلك من المهم دراسة أوضاع القوميات وتوثيقها في سورية بصورة متكاملة، وسيلةً لتقدير حجمها وحقوقها الحقيقية، والبحث في أفضل السبل لحل مشكلاتها وتقليص المعاناة التي تواجهها تلك الأقليات.
تاريخياً، ارتبطت هيمنة الدول بعضها على بعض في القرن الـ19 بالاستعمار، ثمّ بالقوة العسكرية، وفي القرن العشرين بالهيمنة الاقتصادية، وفي القرن الحادي والعشرين من خلال الثقافة كياناً مركّباً ينتقل اجتماعياً من جيلٍ إلى جيل، عبر المعرفة واللغة والمعتقد الديني والفنون والقانون. لكن الأنظمة، في العالم العربي، تتطلّب، عوضاً عن حلّ مشكلة الأقليات، واعتبارها قضايا محلّية وطنية وجودية، الحلّ الجذري، وإبعادها عن أيّ مفهوم غربي، تلجأ إلى محاولات الصهر والابتلاع.
حقوق الأقليات بعد الحربين العالميتين
استقر التوجّه الدولي بعد الحرب العالمية الأولى، على أن المسائل المتعلّقة بدراسة حقوق الأقليات القومية والدينية موضع اهتمام دولي مشروع، وليست شأناً داخلياً في أيّ دولة. علماً أن هذا الافتراض اعتمد منذ عام 1900، لتبرير صياغة معايير وآليات رقابية جديدة.
وخلال العقود الأولى للقرن العشرين، نُظر إلى المشكلة أنّها قصة الأقليات الانضمامية، فمع اقتسام إمبراطورية هابسبرغ التي حكمت النمسا والمجر، وإمبراطورية روسيا القيصرية التي انتهت عام1937، والإمبراطورية العثمانية التي حكمت تركيا وسورية والعراق وفلسطين وأجزاء من شبه الجزيرة العربية وشمال أفريقيا وشبه جزيرة البلقان. وتقسيم تلك الإمبراطوريات إلى عدة بلدان مستقلة حديثاً، تركّزت مشكلة الأقليات في أولئك الذين انتهوا إلى الجانب الخاطئ من الحدود الدولية، وهذا الأمر شمل الكرد في سورية وباقي القوميات في أغلب الدول العربية، إضافة إلى الدول الغربية، مثل الهنغاريين الذين وجدوا أنفسهم يعيشون في رومانيا، أو ألمانيين انضمّوا إلى بولندا، والأقارب في الطرف الآخر. لكن الفرق أن الدول الغربية عقدت معاهدات لضمان حماية متبادلة للقوميات التي تعيش في دول متجاورة، مثلاً منحت ألمانيا بعض الحقوق والامتيازات للسلالات البولندية التي تعيش داخل حدودها، ما دامت بولندا توفّر حقوقاً متبادلة للسلالات الألمانية التي تعيش في بولندا، ليتطوّر الأمر أكثر إلى معاهدات لحماية الأقليات، ومنح ضمانات أكثر على أساس دولي وقانوني في ظلّ عصبة الأمم المتحدة.
في حين أسس بناء النظام الدولي الجديد بعد الحرب العالمية الثانية، مقاربة بديلة، فجرى استبدال الحقوق الخاصة بالأقليات بحقوق الإنسان الشاملة. أي بدلاً من الحماية المباشرة للجماعات الضعيفة من خلال حقوق خاصة بهم، لحمايتهم عبر ترسيخ حقوق سياسية ومدنية لجميع الأفراد، جرى استبدالها بحقوق الإنسان الأساسية، مثل حرية التعبير والتجمّع والضمير، وتصويرها حماية جماعية للأقليات، بحجّة أنه حيثما كانت هذه الحقوق الإنسانية الفردية محميّة لن نحتاج إلى حقوق للأقليات.
بطريقة أكثر لطفاً، يمكن القول إن الاتجاه العام لحركات ترويج حقوق الإنسان، في ما بعد الحرب العالمية الثانية، تمثل في إدراج مشكلة الأقليات القومية تحت مشكلة أوسع لضمان الحقوق الفردية الأساسية لجميع الأفراد، ومن دون الرجوع إلى عضويتها في الجماعات العِرقية. وطرح مبدأ حقوق الإنسان بديلاً، مفهوم حقوق الأقليات، في إشارةٍ قويةٍ إلى أن الأقليات التي يتمتّع أعضاؤها بمساواة فردية في المعاملة لا يحقّ لها المطالبة بتسهيلات للحفاظ على خصوصياتها العرقية، لتتحوّل حقوق الأقليات بعد الحرب العالمية الثانية إلى شيءٍ معيبٍ وقضيةٍ غير ضرورية ومزعزعة للاستقرار. وخلال بضع سنوات قليلة اختفت حقوق الأقليات فعلياً من قاموس المفردات الدولية، أو كما صورها جوزيف كونز في عبارة شهيرة عام 1954: “في أواخر الحرب العالمية الأولى، كانت الحماية الدولية للأقليات موضة عظيمة، حيث وفرة معاهدات ومؤتمرات وناشطي عصبة الأمم المتحدة، وكم هائل من الكتّابات. أما الآن فقد عفا الزمن على هذه الموضة، أصبح الزي الذي يرتدي المحامي الدولي هو حقوق الإنسان”.
النقطة المرجعية التي أحدثت تغيراً في الموقف الدولي إزاء حقوق الأقليات كانت واحدة من شروط العهد الدولي للسياسة والمدنية، الذي أعلنته الأمم المتحدة في العام 1966، فورد في البند 27 أنه “في الدول التي توجد فيها أقليات عرقية أو دينية أو لغوية، فإن الذين ينتمون إلى مثل هذه الأقليات لا يُنكر حقّهم في الاجتماع مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم والاستمتاع بثقافتهم الخاصة، وممارسة طقوس دينهم الخاص، واستخدام لغتهم الخاصة”. لم يخصّص هذا البند أيَّ حقوق خاصة للأقليات، بل كان إعادة تأكيد الالتزام بحقوق الإنسان الشاملة، ودعوة إلى الدول إلى ضمان حصول أعضاء جماعة الأقليات على الحرّيات المدنية نفسها التي يملكها غيرهم من المواطنين، أي دعوة إلى عدم التفرقة، ولكن من دون خصوصياتٍ على أساس اللغة والعرق.
إعادة أحياء حقوق الأقليات
تغيرت المواقف منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي تجاه حقوق الأقليات، وأعيد بالتدريج تفسير المادة 27 لتشكّل الحقوق الإيجابية للأقليات. ففي 1994 أعيد النظر في تلك المادة، وأكّدت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن تلك المادّة لا تفرض واجب عدم التفرقة لحماية الحرّيات المدنية، بل لا بدّ من تبنّي تدابير إيجابية لتمكين الأقلية وتهيئتها لممارسة هذا الحقّ بالاستمتاع بثقافتها. ثمّ تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلاناً لحقوق الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات قومية أو عرقية أو دينية أو لغوية، وتأكيد إعادة صياغة العبارات الرئيسية للمادة “27” ليوضّح أنها تفرض التزامات إيجابية تمكّن الأقليات من الاستمتاع بثقافتهم.
انعكست إعادة صياغة المادة “27” في إيجاد مؤسّسات وإجراءات مختلفة خاصة بالأقليات، مثل إنشاء جماعة عمل للأقليات تابعة للأمم المتحدة في العام 1995، برعاية لجنة فرعية من حقوق الإنسان تابعة للجنة حقوق الإنسان، وتعيين خبير مستقلّ من الأمم المتحدة لموضوع الأقليات في عام 2005. أي، أصبح هناك طريق خاصة للأقليات للاستمتاع بثقافتهم وحقوقهم القومية الخاصة، وجاءت نتيجة وثمرة عمل ثلاث من أقوى المنظمات الأوروبية الحكومية: المجلس الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة الأوروبية للأمن والتعاون.
لم يقترن الحديث عن حقوق الأقليات بالفعل والتطبيق، والإلزام القضائي، لكن قرار جعلها أحد مقاييس انضمام أيّ دولة إلى الاتحاد الأوروبي، شكّل تأثيراً واضحاً ومباشراً في سياسات كثير من دول ما بعد الشيوعية. كما أن مفهوم الدولة الحديثة تغيّر كثيراً خلال العقود الماضية، وفي الخطاب الدولي المعاصر نجد أن فكرة الدولة المركزية أو الموحّدة، توصف على أنها تحتوي مفارقات تاريخية تُلغي غير المنتمين إلى دوائر السلطة أو ذوي الهويات الخاصة. في حين يُنظر إلى الدول متعدّدة اللغات والمستويات، وذات البناءات الداخلية المستعدّة للاعتراف بالمناطق الإقليمية والأقليات وتمكينها، على أنها تمثل المنظور الأكثر حداثة. والدول التي تمسّكت بشدة بالنموذج الوحدوي والمركزي القديم، وواصلت إنكار وجود الأقليات توصف على نحو متزايد بأنها رجعية، وعاجزة عن التعرف والتعامل مع تعقيدات العالم الحديث وتعدديته المتأصلة.
واقع القوميات في سورية
لعبت حركات التحرّر العالمية للأقليات، وتأثيرها في النزاع الدائم، وبالإضافة إلى انهيار سور برلين، وتفكّك الاتحاد السوفييتي، ورغبة الدول العظمى في خلق الاستقرار والأمان، إضافة إلى الدراسات الأنثروبولوجية والثقافية، دوراً مهماً في رفض المبادئ الكلية التي تعتمد عليها الدول المركبة في مقارباتها مع القوميات والأقليات ومنع وصولهم إلى دوائر رسم السياسات والقرار، خاصة أن التبريرات التي قدمتها المنظمّات الدولية لتبني حقوق الأقليات تتسق مع هذه الدراسات نفسها. وما تغير هو التأكيد أن تكيف التنوع العرقي شرط مسبق للمحافظة على نظام دولي شرعي. ويبدو واضحاً أن جميع أهداف وقيم المجتمع الدولي تعتمد على الاعتراف بحقوق الأقليات.
لم تكن سورية مؤلفة أبداً من قومية أو ديانة واحدة منذ نشأتها. ومنذ سيطرة حزب البعث على مقاليد الحكم، نجح في تفتيت المجتمع السوري، وعمق من العسف السياسي، مع سيولة كبيرة للمشكلات التي جاءت بها القرارات والمراسيم التي طُبقت بحق الكرد، مثل عدم الاعتراف الدستوري، والتجريد من الجنسية والحزام العربي وقانون الإصلاح الزراعي، ومنع الأسماء الكردية وتعريب أسماء القرى والبلدات، ومنع اللغة الكردية، ومنع وصول الكرد إلى البرلمان قدر المستطاع، والتمييز في الوظائف والمناصب السياسية والإدارية العليا.
ورغم كلّ ما جرى للأقليات القومية والدينية، لم تتلاشَ، ولم تقبل أن تصهر مع الأكثرية، ولم تفقد وعيها بذاتها وبنشاطها السياسي، ولم تتخلّ عن موروثها الثقافي والهوية الوطنية السورية الجامعة، تحت الضغوط والمواجهات، وآن الأوان للاعتراف بأن النموذج القديم للدولة والنظام السوري لم يعد يتناسب مع الظروف التاريخية التي أفضت إلى نشوء سورية، والواقع السكّاني الجديد. وهناك ثلاث مشكلات محورية لقضية حقوق القوميات في سورية:
الأولى مشكلة التعددية القومية والثقافية والدينية، والصراع ما بين معايير وقواعد يمكن تطبيقها على الجميع من دون خصوصيات، مع منح حق الأولوية تفوق جماعة على أخرى، أو صياغة قواعد مختلفة لأنواع متعدّدة من القوميات والأقليات.
الثاني: مشكلة الظروف والديمقراطية في سورية التي يمكن تنفيذها في دولة ذات نهج ديمقراطي يؤمن بالتعددية بأشكالها، بعكس البلاد ذات الديمقراطيات الضعيفة التي من الطبيعي أن تتحول قضية حقوق القوميات ساحةَ صراع ونزاع، لتصبح سورية أمام خيارين، إما صياغة قواعد وقوانين ناظمة؛ يتحقق فيها مستوىً معيّن من الديمقراطية، تعيش فيه جميع المكونات بالقدر ذاته والمساواة وفقاً للمواد الدستورية، وإما كبح جماح الصراع العرقي عبر العنف، لتكون البلاد ذات مستويات ضعيفة أو متفاوتة في الديمقراطية.
ثالثاً، عجزت جميع الحكومات (تاريخياً)، وبتوجيه من النظام السوري البائد، عن توفير العدالة والأمن، وعدم الاعتراف بالأقليات القومية والعرقية على أنهم ممثلون شرعيون وشركاء متساوون في الحكم في المجتمع السوري، سيقود حتماً إلى الهلاك.
المشكلة العميقة بخصوص حقوق القوميات، هي في الأصوات والتوجهات التي تنظر إلى علاقة الدولة السورية الحالية مع القوميات، من ناحية “ابتكار” الأخطار الناجمة عن منحهم حقوقهم، وهي نظرة تشاؤمية وإقصائية معاً. والأكثر غرابةً عدم ربط أبرز أوجه الاستقرار والسلام بحلّ قضية القوميات. الواضح أن الوضع القائم في سورية غير قابل للاستقرار والاستمرار بشكله الحالي، فالمثالب ظهرت بالفعل، وتحتاج إلى تفكير طويل وبعمق، في الأهداف والمكاسب التي سيجنيها السوريون من خطاب وممارسات التعددية السياسية الثقافية، القومية والإثنية. فالإقرار بوجود قوميات وأعراق، وتضمين مواد دستورية لحقوقها، سيقود إلى التعايش القومي والإثني والثقافي، ويعني جمعاً بين المثل العليا طويلة الأمد والتوصيات البراغماتية التي تحمي البلاد.
الادعاء أن قضايا حقوق الأقليات بدعة ودعم غربي وخروج عن التقاليد والسيادة الوطنية، هو مناقض لعقود طويلة لتأسيس الدول، ومن بينها سورية، التي كانت تمتلك كامل الوسائل والطرائق لمعالجة التنوع القومي والعرقي. في المقابل بقيت القوميات والأقليات، سواء في سورية أو في غيرها من الدول، تحت تأثيرات العنف والتهميش ضدّها. ولعلّ ما قاله وودرو ويلسون عام 1919: “لا يمكن للمرء أن يغامر بقول شيء يدعو إلى اضطراب السلام في العالم أكثر من الحديث عن المعاملة التي تتلقاها الأقليات تحت ظروف معينة” هو دليل على دور الأقليات في تقويض أركان الحكم أو تثبيتها.
المطلوب من السوريين البحث عن أفضل الممارسات ضدّ التصدّعات والنزاعات الجديدة، والاستفادة من تكثيف الجهود والمعايير الدولية لحقوق الأقليات خلال السنوات الماضية، ففشل الدولة في حماية حقوق الأقليات يقود إلى سلسلة من الأزمات المتراكمة، فالدولة الطبيعية والحديثة هي التي تعترف بحقوق الأقليات وحقوق جميع المكوّنات، وإلا فستستمرّ محاولات الجماعات القومية في التحرّك سياسياً للمطالبة بحقوقها وتمثيلها في المحافل الدولية أو في السياسات المحلية، خاصة أن البيئة الدولية تتعاطف مع مطالب الأقليات، أكثر مما كانت تفعل منذ 30 أو 40عاماً مضت.