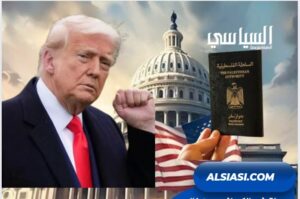ليس من العدل ولا من الإنصاف أن ينصّب أحدهم نفسه قاضيًا على الآخرين، مهما علا شأنه، ليبدأ في إصدار الأحكام جزافًا، بما يخدم أهواءه ومصالحه الخاصة أو مصالح الجهة التي ينتمي إليها. غير أنّ الأمر يزداد خطورة حين نجد عددًا من حَمَلة الأقلام والأفكار يؤدّون الدور ذاته، ولكن بصورة غير قانونية وغير شرعية؛ إذ ينصّب الواحد منهم نفسه مالكًا للحقيقة المطلقة، وصاحب الموقف الأوحد، متجليًا “ملكًا أكثر من الملك”، بينما يُختزل الآخرون إلى أرقام قابلة للجمع والطرح والتقسيم، أو مجرد متلقّين للأوامر والنواهي. وهنا لا بد من مواجهته بكل ما أوتينا من إرادة ووعي.
وإنّ من المؤسف أن نجد في بعض المكتبات إصداراتٍ تنصّب أصحابها قضاةً على الفكر، يجيزون ويحرّمون، ويهتدون في أحكامهم باجتهاداتهم وميولهم، بل وربما أذواقهم الخاصة. وتبلغ الخطورة ذروتها حين يُضاف إلى تلك الآراء استدلالاتٌ دينية أو “مقدّسة”، يُستقوى بها لإضفاء قداسة زائفة على رأي شخصي لا يحتمل هذا التفرد.
ولتجنّب هذه الممارسات التضليلية في الفكر، يتوجّب علينا – نحن العرب – أن نُسخّر كل طاقاتنا وإمكاناتنا لإنشاء مراكز بحثية ودراسية متخصصة، تشمل مختلف حاجاتنا الحياتية: الفكرية، الثقافية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، العسكرية، والأمنية.
إنّ في الغرب، وتحديدًا في أوروبا، مئات، بل آلاف مراكز الأبحاث والدراسات المتخصصة في شتى المجالات: الفكرية، الأدبية، الفلسفية، العلمية، اللاهوتية، الطبية، التكنولوجية، والرقمية المتقدمة (الهايتك). ففي جمهورية ألمانيا الاتحادية وحدها، يوجد 218 مركزًا فكريًا، ما يجعلها تحتل المرتبة السادسة عالميًا من حيث عدد مراكز التفكير وصناعة السياسات. الجدير بالذكر أن البحث العلمي في ألمانيا، ومنذ أكثر من أربعة عقود، يضمّ في معاهده ومراكزه أكثر من 3000 عالم، ألماني وأجنبي، من مختلف التخصصات
وقد بيّن تقرير جامعة بنسلفانيا حول مراكز الفكر العالمية عام 2018، معطيات دقيقة عن المراكز الألمانية. فمراكز التفكير في ألمانيا تلعب دورًا محوريًا في الحياة السياسية اليومية، من خلال تقديم المشورة الواقعية والعلمية لصنّاع القرار. هذه المراكز تشكّل نقطة التقاء بين السياسة والعلوم، ويتركّز معظمها في العاصمة برلين، حيث تتمتّع باحترام كبير على الصعيدين المحلي والدولي.
_ من أبرز هذه المؤسسات:
مؤسسة العلوم والسياسة (SWP): تأسست عام 1962، وتختص بالسياسات الخارجية والأمنية. حازت المرتبة 21 عالميًا حسب مؤشر مراكز الفكر، ويترأسها البروفيسور فولكر بيرتيس، الذي شغل سابقًا منصب نائب الأمين العام ومستشارًا خاصًا للأمم المتحدة في سوريا (2015–2016). وقد نشرت المؤسسة بالتعاون مع صندوق مارشال الألماني عام 2013 ورقة استراتيجية حول السياسة الخارجية الألمانية.
مركز الشفافية الدولية (TI): تأسس عام 1993، ويُعنى بمكافحة الفساد. صنّف في المرتبة 53 عالميًا، ويُصدر سنويًا “مؤشر الفساد العالمي”. ترأسه إيدا مولر، وهي خبيرة في العلوم السياسية ونشطة سابقة في مجال حماية المستهلك. يقوم المركز على مجموعات عمل تطوعية تصوغ المواقف وتعالج قضايا الشفافية المالية ومكافحة الفساد.
الجمعية الألمانية للسياسة الخارجية (DGAP): تأسست عام 1955، وتختص بالسياسات الخارجية، وحلت في المرتبة 50 عالميًا. تضم الجمعية أكثر من 30 خبيرًا ضمن عشرة برامج بحثية، وتصدر مجلة “السياسة الدولية (IP)”، وهي مجلة رصينة تُقدِّم دراسات علمية دقيقة.
المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (DIW): أُسس عام 1925، ويُعنى بالاقتصاد فقط. صُنّف في المرتبة 59 على مستوى أوروبا الغربية. يهتم المعهد بالترابطات الاقتصادية والاجتماعية، ويقدّم مؤشرات دقيقة للنمو الاقتصادي الألماني. يترأسه الاقتصادي البارز مارسيل فراتشر.
مؤسسة البحوث الألمانية (DFG): تُعدّ أكبر منظمة تمويل للبحث العلمي في أوروبا، وتدعم البحوث في العلوم الطبيعية والهندسية والإنسانية، عبر برامج تمويل ومنح متنوعة. يقع مقرها في بون، وتضم في عضويتها نخبة من الجامعات البحثية الألمانية الرائدة.
هذا غيض من فيض ما لدى الغرب من مراكز بحثية متخصصة، تُبنى قراراتها على دراسات موضوعية دقيقة وتُقدّم خلاصاتها لصانعي القرار الذين يأخذون بها على محمل الجد.
وعودة إلى النقطة الجوهرية: إنّ وجود مراكز بحثية جادة ومستقلة هو الكفيل بإفشال محاولات أولئك الذين ينصّبون أنفسهم أوصياء على الفكر من دون وجه حق، ولا سيما أولئك المرتبطين بأقلام السلطة، والمنافقين، الذين يسعون لإضفاء الشرعية على مواقفهم المتحيّزة.
وعلى الرغم من قلّتها، فإن بعض مراكز الأبحاث في الوطن العربي تعاني من التوجيه والتأدلج، حيث تُقرَّر نتائج دراساتها مسبقًا، وتُبنى على انحياز لا على حياد. وهذا يفسّر هشاشة المخرجات الفكرية، وتبدّل الآراء عند أول حوار جاد، بسبب غياب المعلومة الدقيقة وانعدام الاستقلالية. يُضاف إلى ذلك شيوع مراوغة الخطاب وتدنّي مستوى الطرح في وسائل الإعلام، وغياب آداب الحوار والانحياز لطرف دون آخر.
أما الطامة الكبرى، فتكمن في الفجوة بين التنظير اللساني والممارسة الواقعية؛ فكم من المنظّرين والباحثين يستصغرون الآخر من أجل مصالح شخصية أو حزبية، وهم يدركون أنهم على باطل! ولهذا نلاحظ ندرة وجود باحثين مستقلين قادرين على مخالفة أهواء أحزابهم عند حضور صوت الضمير.
وغالبًا ما يُعاقَب كل من يخالف السائد، بدءًا بالطرد أو التسريح من العمل، في ظل أنظمة تدرك أن هذا المسار – إن استمر – سيجعل شوارع البلاد تغصّ بالمسرّحين. وهنا تتجلّى خطورة تقديم الولاء للحزب على الولاء للحق والمجتمع. إنها عقلية ميكيافيلية، لا تؤمن إلا بـ”الأنا” على حساب “النحن”، وفقًا لما وضعه المفكر السياسي الإيطالي نيكولو مكيافيللي.
من هنا، يجب التفريق بين النفاق العملي والاعتقادي. فالمعتقد قد يبقى مستورًا، أما السلوك الظاهر فشاهده العيان، ويقرأه العقلاء.
إنّ التضليل الفكري القائم اليوم، والذي يدّعي امتلاك الحقيقة المطلقة، هو السبب الرئيس لتخلّفنا الفكري والميداني، حيث ينتقل بنا من جنحة في الرأي إلى جريمة في الفعل، ومن خطأ في التفكير إلى خطيئة في التبرير.
لقد أصبح واقعنا العربي عاجزًا عن مجاراة حتى الناتج الاقتصادي لدولة واحدة لا تملك ثروات نفطية ولا معادن، لكنها تملك رجالًا يُفكرون ويعملون، يحترمون المبادئ ويحافظون على القيم والعادات التي ورثوها من الأجداد.
وإذا كان الخطأ في الفعل جريمة، فإنّ تبريره عبر التضليل الفكري المدعوم بنظريات ميكيافيلية ممنهجة، لهو الجريمة الأكبر والمصيبة الأشد.