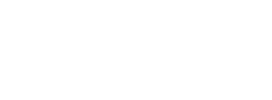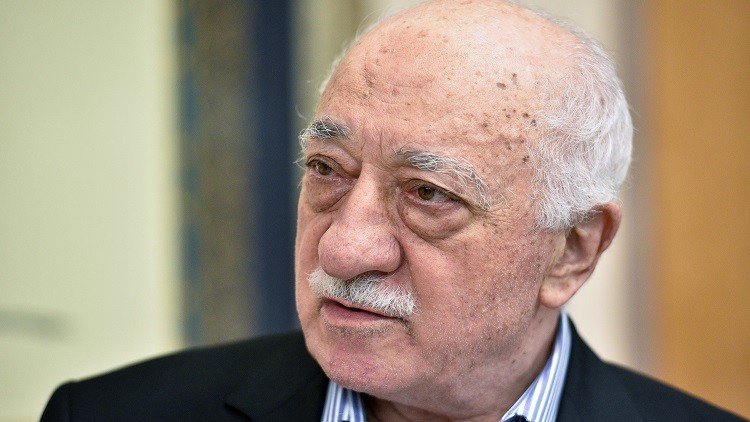عدلاء ونزهة شقيقتان مُسنّتان ينزوي بيتهما في طرف القرية، فإذا مرّ به عابرون قليلون امتنع أغلبهم عن الالتفات إليه. هكذا انطوت الحكمة السائدة في التعامل مع هاتين السيّدتين “المستورتين” على تركهما تعيشان عيشهما البسيط بالهدوء الذي يليق به.
والدهما أعطاهما هذين الاسمين لأنّه، كما يروي أهل القرية المُسنّون، قرأ قصّة عن أختين تُدعيان عدلاء ونزهة كان الأمير بشير الشهابي يستشيرهما في أمور قصره وفي تنظيم أثاثه. لكنّ أهل القرية إيّاهم مارسوا اعتداءات متفاوتة على الاسمين: فمن عدلاء حذفوا الهمزة بحيث صارت عدلا، بينما صدّعوا اسم نزهة إذ استغنوا عن نصفه حتّى صار نزا فحسب. فهم كثيراً ما يستثقلون الأسماء فيُسقطون منها ما يتراءى لهم فذلكة واصطناعاً لا لزوم لهما، غير عابئين بمعاني الكلمات وبما يجوز لغةً أو لا يجوز. ولربّما ظنّوا أنّ أصغر الأسماء وأشدّها اقتصاداً أكثر من كافية لسيّدتين كعدلا ونزا، سيّدتين يكفي أقلّ القليل للتدليل عليهما.
وأنا كلّما كنت أسأل جدّتي عن القرابة التي تجمعها بهما كانت تدخل في دوّامة لا تخرج منها بسهولة. فهي كانت تقول: “أمّهما كانت قريبة أبي من جهة…”، وهنا تتوقّف قليلاً قبل أن تضيف: “وأبوهما كان قريب أمّي من جهة…”. فتحديد جهة القرابة كان يُتعب جدّتي، فتحاول استنطاق ذاكرتها بتحريك أصابعها على جبهتها فيما هي تنظر إلى البعيد، ثمّ تعلن يأسها من المحاولة عبر إشارة من يدها تفيد أنّ الأمر لا يستحقّ التفكير به.
وكانت هذه القرابة التي يعسر إيضاحها جزءاً من غموض هاتين السيّدتين. فهما لم يُذكَر مرّةً اسماهما إلاّ كاسم واحد، إذ لا ترد بتاتاً عدلا وحدها أو نزا وحدها، وقد يتراءى للسامع أنّ كلاًّ منهما تُسمّى “عدلا ونزا”. وقد جرت محاولات قليلة للتمييز بينهما، كأنْ يقال أنّ عدلا طيّبة ونزا خبيثة، لكنّ هذه المحاولات أُجهضت في المهد إذ لم تحظ بأيّ تبنٍّ يتعدّى قائلها. وكان ما يردع الآخرين عن إجراء مقارنات كهذه انعدام البراهين والأدلّة، فلا عدلا عُرفت بفعل شيء طيّب ولا نزا عُرفت بفعل شيء خبيث. ذاك أنّ ما تفعلانه ويراه الآخرون قليل جدّاً وسريع الزوال والتبخّر حتّى ليصعب أن يُسمّى فعلاً.
فهما كانتا، كلّما بلغت الساعة الخامسةَ مساء، تزوران معاً بيت جدّي، فتدخلان بهدوء مَن لا يريد أن يُرى له وجهٌ أو يُسمع له صوت: عدلا، الأكبر سنّاً بعام واحد، تدخل أوّلاً، ووراءها بنصف متر تقريباً تدخل نزا. وبعد أن تجلسا لا تنبسان ببنت شفة، إذ تكتفي كلّ منهما بالتلويح بتحيّة سريعة للحاضرين في الدار تؤدّيها كما يؤدّي العسكريّ تحيّته لمن يفوقه رتبة. بعد ذاك، وفيما هما تدسّان في جيبيهما اليدين اللتين استخدمتاها للتحيّة، تجلسان على المقعدين المتلاصقين إيّاهما اللذين جلستا عليهما أمس وقبل أمس وقبل عام وقبل عشرة أعوام. وخلال ساعتين تقضيانهما في بيت جدّي، لم يكن يُسمع أيّ صوت لعدلا ونزا. فهما تهزّان أحياناً رأسيهما في اللحظة نفسها دون أن يكون مفهوماً سبب هزّ الرأس إذ لا يكون قد سبقه ما يستدعي الموافقة أو الإنكار. أمّا حين يُقدّم لهما فنجانا قهوة، فتلوّحان بيديهما تماماً كما فعلتا عند دخولهما.
فعدلا ونزا لا تتفاعلان مع البشر بأكثر من تلويحة اليد التي يرافقها عزوف الوجه عن كلّ تعبير. لكنّهما أيضاً لا تتفاعلان مع الأشياء التي تحيط بهما أو تقتربان هما منها. فذات مرّة كان عدد من جريدة “لسان الحال” مرميّاً على طاولة وُضعت أمامهما، فإذا بعدلا تلتقطه وتحدّق في صفحته الأولى لبضع ثوانٍ، من غير أن يظهر أدنى تعبير على وجهها، ثمّ تسلّمه إلى نزا التي حدّقت هي الأخرى لبضع ثوان في صفحته الأولى قبل أن تعيد الجريدة إلى حيث كانت على الطاولة. أمّا العدد ذاك فتصدّرت صفحته الأولى صورة جون كينيدي لحظة اغتياله وأخبار كثيرة ومثيرة عن ذاك الحدث.
على هذا النحو مضى الزمن مع الشقيقتين اللتين ظلّتا أشبه بالسرّ المستغلق. وهما لئن أثارتا فضولاً مؤكّداً عند سواهما، إلاّ أنّ أحداً لم يتعقّب ذاك الفضول ولم يحاول فكّ ألغازه. فليس في القرية مَن تساءل عمّا يحتويه بيتهما وما يجري في داخله، بل عن البيت نفسه الذي لم يدخله رجل أو امرأة أو طفل منذ عشرات السنين، فيما الذين يقال أنّهم دخلوه إبّان حياة والدهما فماتوا كلّهم. وأوحى غياب التساؤل هذا كأنّ هناك تسليماً شاملاً بأنّ عدلا ونزا هما حيث لا تجرؤ الأسئلة لأنّ الإجابات سوف تعجز. فهما هكذا لأنّهما هكذا، أمّا مَن يتجشّم محاولة التفسير فلن يعود بأكثر ممّا تعود به جدّتي حين تحاول تذكّر تفاصيل القرابة التي تجمعها بهما.
وحين استحسن أحد الضيوف الذي خرق القاعدة أن يصفهما بالساحرتين، علّق جدّي بابتسامة ساخرة فقال إنّهما مسحورتان، لا ساحرتان، وهو ما أزعج جدّتي التي اعتبرت أنّ الألسنة تطال قريبتيها بالتهكّم.
لكنْ في ذاك المساء الصيفيّ الحارّ، وكان أكثر أهل القرية يجلسون بين بوّابات بيوتهم وبين الطريق، طامحين باقتناص نسمة هواء من مكان ما، سُمعت أصوات قويّة صادرة عن بيت عدلا ونزا. وما لبثت أن صدحت موسيقى مرتفعة آتية من الجهة نفسها. وفجأة استولت على السكّان حيرة لم يبدّدها سوى قول أحد المارّة، الآتي من طرف القرية، إنّ الدكتور قد وصل. بيد أنّ الحيرة التي تبدّدت تبقى ذرّة بقياس الحيرة التي نشأت: فمن هو الدكتور، ومن أين وصل، وما الذي يجعل الأصوات والموسيقى الصاخبة تفد إلينا من بيت السيّدتين الصامتتين؟
وكان ممّا تناقلته الألسنة بسرعة غير مألوفة في بطء أهل القرية أنّ الدكتور اسكندر، شقيق عدلا ونزا، وصل من البرازيل التي أقام فيها أكثر من خمسين عاماً. وما لبث أن تبيّن أن الدكتور، الذي تقدّمت به السنّ، اختار أن يقضي في قريته ما تبقّى له على قيد الحياة وأن يُدفن فيها. فهو حين هاجر كانت شقيقتاه صغيرتي السنّ، فراح من ممارسته الطبّ في البرازيل يرسل للوالد ما يساعده على تدبّر أمره وأمر صغيرتيه. وعندما رحل الوالد مضى اسكندر، الذي لم يتزوّج، في إعانة شقيقتيه عدلا ونزا. أمّا وقد عاد، فقد قرّرت الأختان أن تحتفلا به، لا يعيقهما سوى أنّ أخاهما لم يعد يجيد أيّة كلمة بالعربيّة ما عدا “لبنان” التي يردّدها بإفراط شديد. أمّا هما فلا تفقهان، بطبيعة الحال، أيّة كلمة بالبرتغاليّة، فحين تنويان مخاطبته أو الإشارة إليه تكتفيان بكلمة “برازيل”.
ويبدو أنّ الأمور سارت على خير ما يرام بينهما. هكذا تردّدت في القرية أخبار عن الجلبة الدائمة الصادرة عن ذاك البيت الصامت، وقيل أنّ نكات الدكتور التي يلقيها بالبرتغاليّة تحمل عدلا ونزا على ضحك متواصل وصاخب، تماماً كما أنّ نكاتهما الملقاة بالعربيّة تجعل الدكتور يصرخ بأعلى صوته المسموع من بعيد لشدّة الضحك.
وبالفعل توقّفت زيارات عدلا ونزا المسائيّة إلى بيت جدّي، إذ باتتا تقضيان كلّ الوقت في بيتهما مع أخيهما الدكتور. لكنْ لم يمض إلاّ شهر وأسبوع حتّى عادت عدلا ونزا إلى مزاولة زيارتهما اليوميّة إلى بيت جدّي، مرفقتين بالصمت القديم ذاته وبفستانين أسودين ومنديلين أسودين وجوارب سوداء وحزن أكبر كثيراً من ذي قبل.