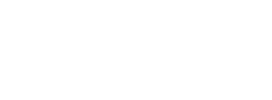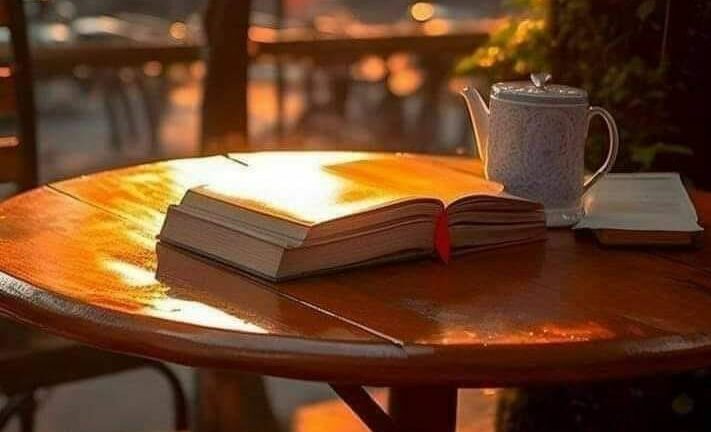عادَ المعارض المخضرم من منفاه الألماني بُعيد سقوط الأسد، ومن دون تردّد، ذهب إلى صلاة الجمعة، حيث احتشد المؤمنون. وبعد نهاية الصلاة، صعد إلى المنبر ليلقي خطاباً، لكنّ شبّاناً لحقوا به وأنزلوه، وقالوا إنه لا يحقّ له ذلك. وفي اليوم التالي، في مقابلة متلفزة، سأله المذيع عن الحادثة، فأجابه بأن الشبان لم يكونوا أبداً مُحقّين بإنزاله من على المنبر، فسورية أصبحت حرّةً، والمنبر لجميع المؤمنين، يقولون منه ما يجول في عقولهم، مكرّراً “حرّية التعبير” مرّات عدّة، ثمّ استفاض بشرح الوضع السوري، فهجا ديانة الإيرانيين، وقال إن “ديانتهم ليست من الإسلام”، إنما هي مزيج “ماجوسي نصراني” (انتبه، “نصراني” هذه معتمدة لدى الإسلاميين الأصوليين للإشارة إلى المسيحيين)، ثمّ أثنى على السُنّة، معبّراً عن ارتياحه لأنهم يشكّلون 80% من سكّان سورية. اعترض عليه المذيع بلطف، قال له: “أنت علماني. السُنّة ليسوا أكثر من 71%”، لكنّه تابع وقارن نفسه بالخليفة الثالث عثمان بن عفّان، الذي قُتِل ظلماً ولم يدافع عنه أحد.
المهم أنّ هذا المعارض، الذي زاد عمره عن التسعين، بدا وكأنّه لم يكن ذاك الشخص الذي وقّع “إعلان دمشق” عام 2005، الوثيقة التي انطلقت منها المعارضة السورية العلمانية، التقدّمية، اليسارية، وكانت شرارة الثورة الأولى. كان، مع رفاقه من الراحلين ميشيل كيلو ورياض سيف، من أصحاب الفضل الكبير في احتضان الثورة خلال السنوات اللاحقة، من انطلاقتها وحتى التهجير الجماعي القسري. قصّة هذا المناضل الحقوقي العلماني الكبير تلخّص قصصَ نسبةٍ غير مُحدَّدة من أشباهه. ولكن أيضاً، سوف تجد نسبةً أخرى منهم تنقد إسلامية العهد الجديد بدرجات متفاوتة من المسايرة، وبعضها يصبّ في رفضها، أو الحَرَد منها. ومن الاثنين تتسلّل رائحة الغيرة السياسية.
في العموم، يتصرّف العلمانيون وكأنّ الحدث تجاوزهم. أين هم هؤلاء المعارضون العلمانيون الآن، بعد أن أبقوا القضية السورية حيّةً طوال عقد؟ أين كانوا عشيّةَ الحدث؟ من هم قادتهم؟ من هو قائدهم؟ ما هي مقترحاتهم؟ ما هي الحركة الميدانية أو التجربة الميدانية التي كان يمكنهم الانطلاق منها لبناء قوة (ليست عسكرية بالضرورة كما هي حال تجربة أحمد الشرع الإدلبية) توصلهم إلى السلطة مثلاً؟… الأرجح أنهم خارج زمنهم، وهذا عكس اعتقادهم بأنهم في مقدّمة الأزمان. هم يعيشون اليوم في عصر عربي أو إسلامي يحتلّ الدين فيه الواجهة والمضمون، كلّ بتعبيرات وأشكال تناسبه. الغالبية من السوريين، سواء من صمدوا في الداخل أو الذين هُجِّروا إلى الخارج، مثلهم مثل بقية من حولهم، صاروا من المتديّنين، والإسلام السياسي على نمط هيئة تحرير الشام (في تجاربها البعيدة والقريبة) يناسبهم. وقبل كل شيء، هو الذي حقّق الإنجاز التاريخي بإسقاط الأسد، وهم على خصومة مع العقيدة العلمانية التي كان يتبنّاها العهد الساقط في أقواله وبعض ممارساته، على الرغم من تناقضها مع أفعاله العصبية المذهبية الصرفة، خصوصاً بعد ثمانينيّات القرن الماضي، إثر المقتلة التي خاضها ضدّ أهل حماة، على أساس أنه يحارب التعصّب والجهل والرجعية، وممثّليها من الإخوان المسلمين، فتحوّل الإسلام السياسي إلى عقيدة مواجهة الأسد. وهذا الاستثمار الأسدي بالعلمانية، سبقه استثمار في الاشتراكية، ولحقه استثمار آخر في حقلَي الحداثة والنسوية، فكان خير من يحيي إسلاماً سياسياً معادياً للعلمانية والحداثة والنسوية والاشتراكية.
تلك هي أولى نقاط ضعف المعارضة العلمانية، أنها لم تتمكّن من أن تتحوّل لما تصبو إليه الحركات الشعبية (العضوية) كلّها، على تماس مع معتقدات بيئتها؛ أي مثقّفين عضويين، تصنعهم ويصنعونها، ومن منطلقات واحدة أو مُوحَّدة. أضف إلى ذلك أن الإسلام السياسي ليس معزولاً عن العالم. العرب من حول سورية ينشدون له، والغرب عائد إلى مسيحية يمينية متطرّفة، وكذلك يهود إسرائيل، التي تتحكّم بحاضرها اليهودية السياسية الأشدّ صراحة وقوة. يعني للمقارنة البسيطة، لو حصلت هذه الأحداث كلّها في ثلاثينيات القرن الماضي، مثل تلك الحرب الأهلية الإسبانية، التي تقاتل فيها الجمهوريون والملكيون المتديّنون (1936- 1939)، وكان كلّ القادة والأفراد من الصفّ الجمهوري ينتمون إلى أحد الأحزاب اليسارية، الاشتراكية أو الشيوعية أو الفوضوية، بل في ستينيّات القرن الماضي وسبعينياته، لو كنتَ في بوليفيا، أو في أيّ بقعة مشتعلة من أميركا اللاتينية، تخوض حرباً ضدّ سلطة بلادك وداعميها الأميركيين، لكنت خرجتَ منها بأبطال لا يختلفون عن تشي غيفارا بشيء، بعلمانيّته ويساريّته، ما يحيلنا على عمر هؤلاء العلمانيين، وإلى نسبة الشباب الذين يصعدون في صفوفه الأمامية. والحال أنه حتى اللحظة، لم يبرز ولا شابّ في قيادة العلمانيين، ولا تصدّر على الأقلّ أحد مشاهدها، فيما معظمهم تجاوز الستّين من العمر، وغيرهم على أبواب التسعين، وقد توفّي منهم اثنان، الراحل ميشال كيلو (2021)، عن 81 عاماً، ورياض الترك أيضاً (2024)، بعدما أصبح في 94 من العمر. ويعكس المشهد الذي يقدّمه أحمد الشرع ورجاله في الوزارات (الشرع نفسه في الأربعين ونيّف، ومن معه من جيله)، كيف استطاع شبان الإسلام السياسي أن يصعدوا إلى السلطة.
كان العلمانيون في البداية يساريين، حذفوا معتقدهم الأول، ثمّ أصبحوا ديمقراطيين، فيما نظراؤهم الإسلاميين ظلّوا إسلاميين، مع تفاوت بالدرجات، بعدما انفصلوا عن “القاعدة” و”داعش”. وقد تكون سيرة أحمد الشرع واحدةً من تجلّيات التحوّل ضمن الاستمرار، من إرهابي إلى سلفي متشدّد إلى “براغماتيكي”، ولكن يبقى إسلامياً، إنقاذاً لقيادته المرحلة. أيّ أن خيوطاً بين ماضيه وحاضره هي حلقات متقطّعة، ولكنّها موصولة. العلمانيون الذين يلبّون الآن إغراء لعب دور ما في الحدث الجديد، ويكون الصعود إلى منبر الجامع وجهتهم، بأيّ قياس يفصّلون علمانيتهم؟ بأيّ ميزة يتميّزون؟ أم سيلعبون دور “الحلقات الحصينة”، التي اعتمدها عدد من علمانيي لبنان تجاه حزب الله، فيصيبهم ذاك المزيج المحلّي من التناقض والعبثية بأن يموتوا من أجل إسلام سياسي لبناني (حزب الله) من جهة، وأن ينقضّوا، من جهة أخرى، على أولى تجارب إسلام سياسي سوري، أي هيئة تحرير الشام، فتكون أولويتهم اليوم حملةً إعلامية مركّزة لـ”حماية” الحرّيات والديمقراطية والمواطنة في سورية بعد سقوط حليفهم الأسد، وفتح أبواب سجونه ونبش مقابره الجماعية؟