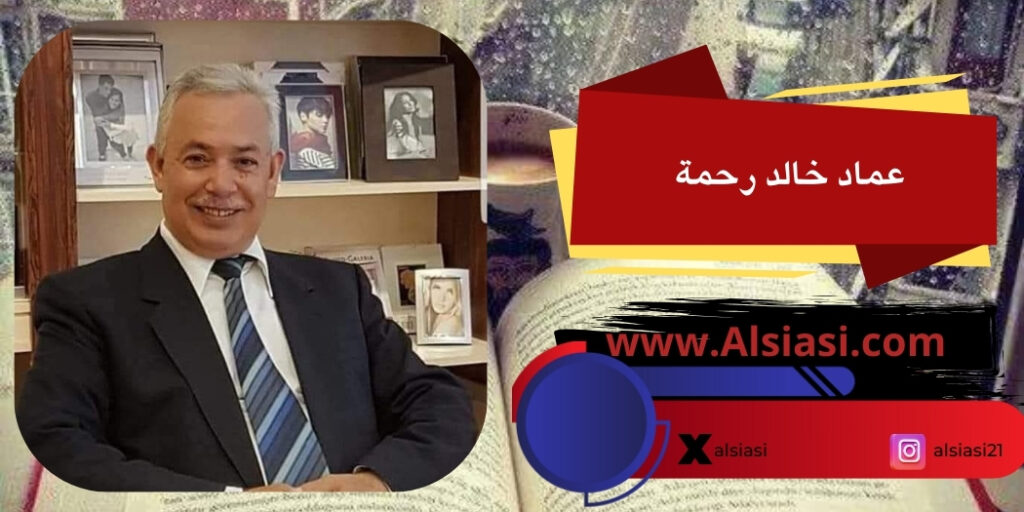في عالمٍ تتسارع فيه التحوّلات وتتقاطع الثقافات وتتنامى التحديات التي تتجاوز حدود الجغرافيا والانتماء، يغدو الحوار بين الحضارات والثقافات، لا ترفاً فكريّاً، بل ضرورة وجودية. غير أن هذا الحوار لا يمكن أن يُكتب له النجاح ما لم ينبثق من عقل منفتح وقلب منفتح، يُحسن الإصغاء قبل القول، ويؤمن بأن الاختلاف لا يعني التنافر، بل قد يكون مدخلاً إلى التآلف وبناء المشترك الإنساني. ولعل هذا ما قصده الفيلسوف الألماني هانس-غادامر حين قال: “الفهم لا يقوم على تذويب الآخر في الذات، بل على لقاء أفقين مختلفين”.
أولًا: العقل المنفتح… من الذاتية إلى الكونية
العقل المنفتح ليس انكسارًا أمام الآخر، بل هو ارتقاء بالذات إلى مستوى يُمكّنها من أن ترى العالم لا بعينها فقط، بل بعين الآخر أيضاُ. هو عقل يعي حدوده، فلا يدّعي امتلاك الحقيقة المطلقة، بل يؤمن بأنها ثمرة التلاقي بين عقول متعددة، تجتمع على قاعدة الاحترام المتبادل.
وقد أشار المفكر المغربي طه عبد الرحمن إلى أهمية الانفتاح العقلي، معتبرًا أن “العقلانية الحقّة لا تكون إلا بمصاحبة البُعد الأخلاقي”، ذلك أن عقلًا منفتحًا بلا ضوابط أخلاقية قد ينقلب إلى أداة هيمنة، لا أداة حوار. وهنا تبرز الحاجة إلى التآلف بين “العقل الخاص” بكل ما يحمله من خصوصيات ثقافية وتاريخية، و”العقل العام” بوصفه مجالًا للتشارك الإنساني.
ثانيًا: القلب المنفتح… شرط التلاقي الإنساني
إن الحوار لا يتحقق بالعقل وحده، وإنما يستلزم قلباً منفتحاً يَقبل الآخر لا بوصفه نقيضاً، بل بوصفه شريكاً في المعنى والكينونة. فالقلب المنفتح، كما عبّر عنه المتصوف جلال الدين الرومي، هو ذلك الذي يرى النور في كل العقائد، والإنسان في كل الاختلافات. يقول الرومي: “ما دامت أفكارنا واحدة، فقلوبنا لا بد أن تلتقي”.
ولعل جوهر الحوار هو هذا الالتقاء بين العقول التي تفكر والقلوب التي تشعر، في مسعى لا لتذويب الفروق، بل لفهمها والاحتفاء بتعددها. فـ”المعرفة”، كما يرى المفكر الفرنسي بول ريكور، “تبدأ حين ندرك أن الآخر ليس خصمًا، بل نافذة أخرى على العالم”.
ثالثًا: من أحادية الرؤية إلى تعددية المنهج
إن الانغلاق الفكري، المبني على مناهج أحادية البعد، كان ولا يزال أحد الأسباب الرئيسة لتصادم الحضارات، سواء باسم الدين أو القومية أو الإيديولوجيا. أما الانفتاح المنهجي، فيقتضي تجاوز هذه الأحادية نحو مقاربات متعددة تُنصت لكل صوت، وترى في كل تجربة بشرية حكمة تستحق الإصغاء.
وهذا ما دعا إليه المفكر اللبناني علي حرب، الذي انتقد “المثقف الأحادي” الذي يحصر الحقيقة في زاوية رؤيته، ويعجز عن رؤية التعدد كقيمة. فالانفتاح المنهجي هو أول خطوة نحو تأسيس بنية فكرية تُؤمِن بأن الحقيقة أكبر من أن تُحتكر، وأغنى من أن تُختزل.
رابعًا: نحو قاعدة مشتركة للحوار الإنساني
ليتحقق الحوار الحقيقي، لا بد من وجود قاعدة مشتركة تلتقي عندها العقول، دون أن تُذيب خصوصياتها. هذه القاعدة لا تُفرض من الخارج، بل تُبنى من الداخل، من خلال ما يُسميه المفكر الألماني يورغن هابرماس بـ”العقل التواصلي”، الذي يرى أن التفاهم بين البشر لا يتحقق إلا عبر التواصل المتكافئ والمفتوح.
في هذا السياق، يمكن استدعاء مفهوم “العقل المكوِّن” عند طه عبد الرحمن، مقابل “العقل المكوَّن”، للدلالة على ضرورة الانتقال من عقل يستهلك المفاهيم الجاهزة إلى عقل يُنتج مفاهيمه من داخل بيئته الثقافية، دون أن ينغلق عن الآخر. وبهذا المعنى، يصبح الحوار فعلًا إبداعيّاً، لا مجرد تبادل أفكار.
الخاتمة:
إن بناء عالم أكثر عدالة وإنسانية لا يمكن أن يتم إلا على أساس عقل منفتح وقلب منفتح، يُؤسسان لحوار دائم بين الشعوب والثقافات، حوار لا يُنكر الخصوصيات، بل يحتفي بها ضمن أفق كوني مشترك. وكما قال محمد عابد الجابري: “لا يمكن أن نتحاور ونحن في مواقع مغلقة، لا نتحاور إلا من موقع الانفتاح، من موقع المشترك الإنساني”.
من هنا، لا يكون الانفتاح مجرد دعوة تجريدية، بل هو مشروع أخلاقي وفكري يتطلب شجاعة في التفكير، وتواضعًا في الرأي، وجرأة في الاعتراف بالآخر، لا كتهديد، بل كفرصة لفهم الذات والارتقاء بها.