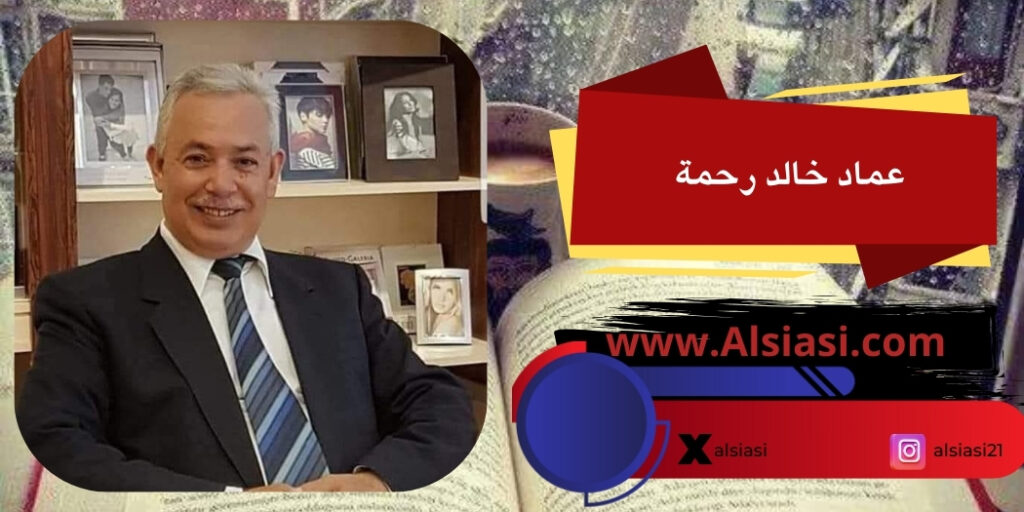يُعَدُّ الاغتراب من أعقد الظواهر الإنسانية التي عايشت الإنسان منذ فجر التاريخ، فهو ليس مجرد إحساس بالغربة عن الآخر، بل هو انقسام داخلي يطال الذات في علاقتها بالعالم والمجتمع والمعنى. ولعلّ مقاربة مفهوم الاغتراب أنثروبولوجيًّا تكشف عن أبعادٍ متشابكة تتجاوز التجربة الفردية إلى التجربة الجمعية، حيث يتقاطع النفسي بالاجتماعي، والفلسفي بالديني، والوجودي بالاقتصادي. ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث الذي يحاول رسم قراءة أولية لمسار المصطلح، منذ جذوره الميتافيزيقية والدينية القديمة، مروراً بفلسفات اليونان والمسيحية، وصولاً إلى الفلسفة الألمانية الحديثة وما تركته من أثر في الفكر الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.
—
النص بعد التدقيق والتحرير
الاغتراب: قراءة أنثروبولوجية أولية
بقلم: عماد خالد رحمة – برلين
من أكثر التجارب قسوةً في حياة الإنسان أن يشعر بالغربة والاغتراب معاً، إذ يشكّل ذلك مأزقاً نفسيّاً ومعنويّاً عميقاً. فالاغتراب، في جوهره، يعني فقدان الذات وتلاشي الهوية الشخصية، الأمر الذي قد يدفع الإنسان إلى الثورة بحثاً عن استعادة وجوده وكينونته. ولا يقتصر الاغتراب على الأزمات البنيوية الظاهرة، بل يتعدّاه إلى الصراعات الداخلية النفسية، ولا سيما الاغتراب الذهني، وهو حالة مرضية تُغيّر سلوك الفرد ومنهجه في الحياة، فتجعله يشعر بالغربة عن مجتمعه ومحيطه الإنساني، فيلجأ طواعيةً إلى العزلة، تلك العزلة التي تتحول إلى قسرية خفيّة، تدفعه في كثير من الأحيان إلى سلوكيات متطرفة تسيطر عليه بدلاً من أن يسيطر هو عليها.
والاغتراب ليس حالة فردية فحسب، بل هو أيضاً ظاهرة جمعية من أقسى صور الاغتراب، وبالأخص ما يُعرَف بـ الاغتراب الاجتماعي (Social alienation)، الذي يتجلّى في العلاقات الاجتماعية بحسب درجة التكامل والتفاعل بين الأفراد، ومدى الالتزام بالقيم الأخلاقية السائدة، إضافةً إلى طبيعة المسافة أو العزلة بين الفرد والجماعة أو بين العامل وبيئة عمله. وهو مصطلح محوري في علم الاجتماع تناوله العديد من المفكرين والمنظّرين الكلاسيكيين والمعاصرين.
لقد عُرف مصطلح الاغتراب منذ أمد بعيد، إذ مرّ عبر العصور بمعانٍ متناقضة ومتنوعة. ففي العصور القديمة ارتبط بالمفهوم الميتافيزيقي، أي الإحساس بالسمو عبر التأمل، كما في فلسفة “الزن” والنيوبلاتونيين أمثال بلوتينوس، الذين اعتبروا الاغتراب حالة انفصال عن الواقع نحو المطلق. وفي المقابل، استُخدم المصطلح دينياً للدلالة على الانفصال عن الله، كما عند أوغسطينوس والمانويين والأريوسيين. أما في المعنى القانوني، فقد وظّفه شيشرون بمعنى المبادلة أو البيع (التنازل عن الملكية).
وفي الفلسفة الغربية الحديثة، لا سيما الألمانية، تبلور المفهوم بشكل أوضح. ففي اللغة الألمانية ظهر مصطلح Entfremdung منذ العصور الوسطى، واستُعمل عند مارتن لوثر في ترجمته للإنجيل للدلالة على الابتعاد عن الله. وفي الفلسفة المثالية، جعل هيغل الاغتراب مرحلة ضرورية لتحقيق الروح لذاتها، معتبراً إياه شرطاً جدلياً بين الذاتي والجماعي، في حين رأى فويرباخ أنه اغتراب الإنسان عن ماهيته بإعلاء الإلهي على الإنساني. أما كارل ماركس، فقد قدّم التحليل الأعمق للاغتراب حين اعتبره النتيجة البنيوية للنظام الرأسمالي، حيث يفقد العامل السيطرة على نتاج عمله، فيغترب عن ذاته وعن الآخرين، ويتحوّل العمل إلى قوة معادية بدلاً من أن يكون فعلاً لتحقيق الذات. وقد صنّف المفكر كوستاس أكسيلوس أنماط الاغتراب الماركسي في أربعة: الاجتماعي، والاقتصادي، والسياسي، والأيديولوجي.
كما تناول فلاسفة وباحثون آخرون المفهوم من زوايا مختلفة: روسو الذي رأى في العقد الاجتماعي تنازلاً يُنتج الاغتراب، وهوبز الذي اعتبر أن الإنسان الاجتماعي يعيش دائماً خارج نفسه، وماكس شتيرنر الذي ذهب أبعد من ذلك فاعتبر أن حتى “الإنسانية” نفسها شكل من أشكال الاغتراب عن الفرد. وقد ردّ عليه ماركس وإنجلز في الأيديولوجية الألمانية (1845).
وفي علم الاجتماع الحديث، قدّم جورج زيمل وفرديناند تونيز تحليلات للاغتراب في ظل التحضّر والتفرد، حيث تتحول العلاقات الاجتماعية إلى علاقات وساطة مالية، ويجد الفرد نفسه مهمّشاً إزاء متطلبات الجماعة والقرار الجمعي.
وهكذا، يتبيّن أن الاغتراب ليس مفهوماً أحادي المعنى، بل هو شبكة من الدلالات الأنثروبولوجية والفلسفية والاقتصادية والسياسية والدينية، تعكس جميعها مأزق الإنسان في علاقته بذاته وبالعالم. إنه ظاهرة مستمرة عبر العصور، تتغيّر صيغها ولكنها تظلّ كامنة في قلب التجربة الإنسانية، بوصفها أحد أعمق جروح الوعي البشري.