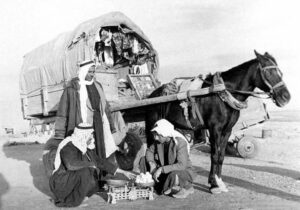لم تتوقف المناظرات بين الفلاسفة والمفكرين حول جدلية (الأنا) و(الآخر)، إذ تُرى (الأنا) على أنّها الأفضل والأجمل والأكمل والأصوب، بينما يُنظر إلى (الآخر) بوصفه النقيض: المشتِّت، والناقص، والأسوأ. وهذه النظرية، بما تحمله من دلالات سلبية، هي نظرية ضدّية وعدائية تكرّس حالة الانفصال بين (الأنا) و(الآخر) بشكلٍ تعسفي، على الرغم من حضورها في مجالات الفكر والفلسفة والسياسة والأدب، وغيرها من حقول المعرفة الإنسانية.
وقد رأى الفيلسوف والكاتب المسرحي الفرنسي (جان بول سارتر Jean-Paul Sartre) (1905 ـ 1980) أن وجود الغير (الآخر) ضروري من أجل وجود (الأنا) ومعرفته لذاته، فالغير عنصر جوهري مكوِّن لـ (الأنا) ولا غنى عنه في وجوده على الإطلاق. غير أنّ العلاقة الجاذبة والنابذة بينهما تبقى علاقة خارجية وانفصالية، ينعدم فيها التواصل ما داما يتعاملان مع بعضهما البعض كشيء غير محدَّد، لا كـ (أنا) و(آخر). ويقدّم سارتر مثالاً على ذلك بعبارته الشهيرة: “الغير هو الجحيم”.
من هنا عُدَّ مفهوم (الذات/الأنا) واحداً من أعمق المفاهيم النفسية والإنسانية في حياة الفرد والمجتمعات. فكلّ خلل أو قصور في الوعي المتكامل به، أو في كيفية التفاعل معه، قد يقود إلى انحرافات خطيرة في الفهم والسلوك، وربما إلى انهيار كلي أو جزئي في قناعات الإنسان، فيرفض ذاته أو يعجز عن قبولها. وهذه حالة نفسية ذات خصائص مرضية تهدّد وجوده الحيوي، إذ تجعله أقرب إلى الجماد والسكون منه إلى الإنسان الفاعل. ومن ثمّ يصبح عاجزاً عن استثمار طاقاته في الحياة الإنسانية. لذلك، فإنّ على الإنسان أن يسعى بما أوتي من إرادة وقوّة إلى فهم ذاته (الأنا) وتفعيل إيجابيتها.
لقد بدأ الدين منذ وقت مبكّر في طرح هذه الجدلية، ثم اتسع نطاق السجال الفلسفي حولها بوصفها موضوعاً افتراضياً عُرف باسم “النفس” أو “الروح”. وتطوّر المفهوم لاحقاً في علم النفس، واكتسب مدلولات نظرية جديدة منذ القرون الوسطى. فقد أسّس الفيلسوف وعالم النفس الأمريكي (ويليام جيمس William James) (1842 ـ 1910) من خلال كتابه المهم “مبادئ علم النفس” (1890) أرضية واسعة لعدد من النظريات الحديثة، وكان له الفضل في بلورة الدراسات الأولى حول (الأنا) أو (الذات).
تلاه الفيلسوف وعالم الاجتماع الأمريكي (جورج هيربرت ميد George Herbert Mead) (1863 ـ 1931) بنظرية (الأنا) الاجتماعية، ثمّ نظرية (الذات الاجتماعية) لتشارلز هورتون كولي (Charles Cooley) (1864 ـ 1929)، وكذلك نظرية اتساق الذات (Lecky) وغيرها. فأصبح مفهوم (الذات/الأنا) يحتل مركزاً رئيسياً في الفكر النفسي والاجتماعي.
وخلال الحرب العالمية الثانية وما بعدها، ازدهر المفهوم من جديد، فلم يعد محصوراً في نظريات الشخصية، بل غدا حجر الزاوية في العديد من المدارس النفسية. من أبرزها نظرية (الذات) لفيليب فرنون (Vernon) عام 1946، ونظرية سنيج وكومز عام 1949، ثم نظرية عالم النفس الأمريكي كارل روجرز (Carl Rogers) (1902 ـ 1987)، الذي أسّس مع أبراهام ماسلو (Abraham Maslow) (1908 ـ 1970) التوجّه الإنساني في علم النفس. كما أسهمت نظريات كورت غولدستين (Kurt Goldstein) (1878 ـ 1965) وماسلو (1954) في تعزيز هذا التصوّر، مؤثرةً بعمق في دراسة الشخصية والوعي الفردي.
لقد بات مفهوم (الذات/الأنا) إطاراً أساسياً في الدراسات النفسية والتربوية الحديثة، وركيزة للعديد من الأبحاث المعاصرة. فهو مفهوم شعوري يعيه الفرد ويفهمه، ويمثّل الخطوة الأولى لفهم كيانه الشخصي، ومن ثمّ إدراك (الآخرين) من حوله، سواء أكانوا بشراً أم بيئة مادية. لذلك يتفق معظم الباحثين على أنّ وظيفة (الذات/الأنا) تتمثّل في توحيد الجوانب المتنوعة للشخصية وتماسكها، ومنحها طابعاً خاصاً، فضلاً عن تنظيم عالم الخبرة والمعرفة لدى الفرد، ليصبح طاقة دافعة لسلوكه في المجتمع ونشاطاته المختلفة.
إنّ (الذات/الأنا) لا تحدّد السلوك الفردي فحسب، بل تؤثّر في اتساقه مع السلوك الجمعي، وتوجّهه في ضوء خبراته، وقيمه، ونضجه، وتجاربه مع الآخرين. وهي تنمو تكوينياً نتيجة التفاعل الاجتماعي، إلى جانب الدوافع الداخلية. ولها دور محوري في العمليات الإدراكية والتعلّم والصحة النفسية وتربية الطفل والتوافق المدرسي. وبقدر ما يعي الفرد ذاته، بقدر ما يستطيع أن يوجّه سلوكه ويندمج مع الجماعة.
وعلى الرغم من أنّ جدلية (الأنا) و(الآخر) قائمة على التناقض، فإنّهما لا ينفصلان. فالعلاقة بينهما علاقة شدّ وجذب، وصراع واتصال في آن واحد. فلا يمكن تصور (الأنا) من دون (الآخر)، ولا (الآخر) من دون (الأنا). وكلّ سعي من أحدهما لفهم الآخر هو في الوقت نفسه سعي لاكتساب مزيد من الوعي بالذات. وهكذا فإنّ وعي (الأنا) لا يتحقق إلا بوجود (الآخر)، وبالتمايز عنه.