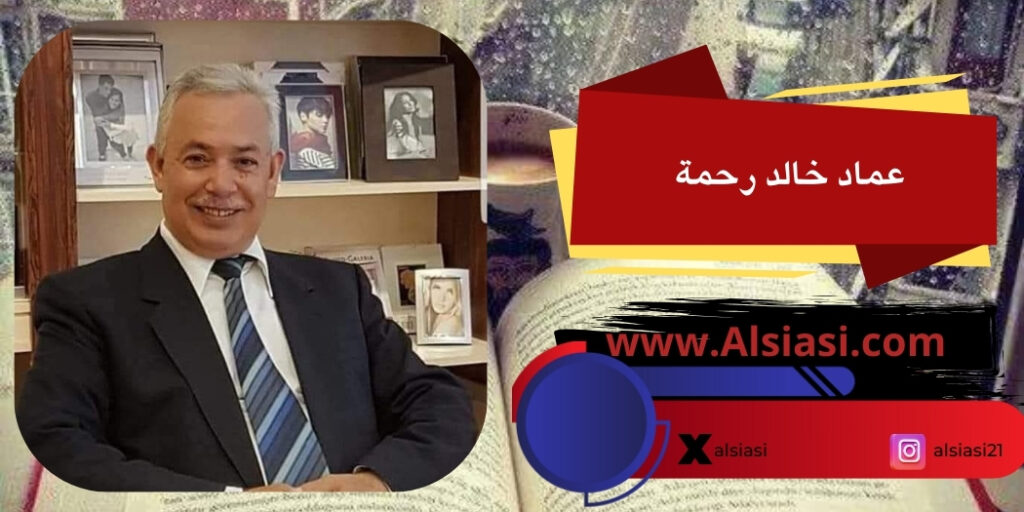إذا كانت العلوم عموماً لا تُنتَج في الفراغ، فإن السيكولوجيا تحديداً لا يمكن أن تنفصل عن شروطها الثقافية والسياقية. فهي علم يتغذّى على الإنسان، بوصفه كائناً مُركباً، حاملاً لهوية، ولغة، وسرديات تاريخية. ومن هنا تبدأ إشكالية السيكولوجيا في العالم العربي: غياب الجذور، وضبابية الهوية، والانخراط التابع في منطق لم يُنتَج من رحم الذات، بل من معايير الآخر. فهل يمكن الحديث اليوم عن سيكولوجيا عربية أصيلة؟ أم أننا لا نزال نتموضع داخل نصوص الفلاسفة الغربيين كمستعمرات معرفية، تستبطن الاغتراب وتعيد إنتاجه في خطاب علمي مقلد؟
هذه الورقة تسعى إلى مساءلة الواقع السيكولوجي العربي، من خلال قراءة إمبريقية نقدية في مسألتي التأريخ والهوية، مستنيرة بأفكار الفلاسفة والمفكرين العرب والغربيين، من أمثال عبد الله العروي، محمد عابد الجابري، مصطفى حجازي، علي زيعور، إدوارد سعيد، وميشال فوكو.
أولاً: سيكولوجيا بلا تاريخ… أم تاريخ بلا سيكولوجيا؟
إن أول ما يلفت النظر في خريطة السيكولوجيا العربية هو غياب سردية واضحة لتاريخها. وكما يقول فوكو في دراسته للخطابات المعرفية: “الصمت التاريخي هو أداة للهيمنة بحد ذاته”. فأن لا نؤرخ لسيكولوجيتنا هو نوع من الإذعان لصمت الذات أمام الآخر، بل وإعادة إنتاج لموقع التابع في لعبة الهيمنة المعرفية.
التجربة الغربية في السيكولوجيا، بدءًا من فيلهلم فونت ومروراً بـ بافلوف وفرويد ووصولاً إلى بياجيه، لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت كثمرة لتفاعل جدلي بين الأسس الفلسفية للمعرفة وواقع الإنسان الأوروبي. أما في السياق العربي، فقد كانت البداية – منذ الخمسينات – متعثرة وتابعة، إذ تمت استعارة المناهج والمفاهيم بدون أن يُطرح السؤال التأسيسي: من هو الإنسان الذي ندرسه؟ وما هي أبعاده الثقافية والوجودية؟
ثانيًا: اغتراب المفهوم، أو عُسر الترجمة النفسية
حين نتحدث عن مفاهيم مثل اللاشعور، الإدراك، السلوك، فإننا غالبًا ما نفترض أنها مفاهيم كونية محايدة. غير أن المفكر إدوارد سعيد يُحذّرنا من هذا الافتراض، مذكّراً بأن المعرفة ليست بريئة، بل مشروطة بسياقها.
المفهوم النفسي الغربي نشأ من داخل ذات ثقافية محددة، أي الذات الغربية التي مرت بتحولات كبرى من الفردانية إلى الرأسمالية إلى الأزمات الوجودية. أما الذات العربية، فهي ذات جماعية، مشبعة بروابط دينية وتقاليدية، وقد خضعت لاستعمارات متعددة وتركتها في مفترق بين “الهوية” و”الحداثة”.
وعليه، فإن استيراد المفاهيم الغربية دون تفكيك شروطها المعرفية والأنطولوجية يؤدي إلى فشل تطبيقها على الإنسان العربي، الذي يعيش ضمن بنية سيكولوجية مختلفة تمامًا، كما نبه إلى ذلك مصطفى حجازي في “سيكولوجية الإنسان المقهور”، حيث أوضح أن الإنسان العربي يعيش حالة كمون سيكولوجي، قوامه القهر والتهميش والعجز، وهي أبعاد غائبة عن السيكولوجيات الغربية.
ثالثًا: أزمة الهوية السيكولوجية… بين الذات والآخر
يطرح علي زيعور في كتابه “التحليل النفسي للذات العربية” سؤالًا جوهريًا: هل نحن مجرد حالات مرضية في عيادة التحليل الغربي؟ أم أننا ذوات لها خطابها النفسي الخاص؟
الإجابة على هذا السؤال تكشف عن عمق أزمة الهوية في السيكولوجيا العربية، فهي تعاني من ازدواجية مريرة: من جهة، رغبة في الالتحاق بالمعرفة الحديثة، ومن جهة ثانية، شعور عميق بالانفصال عن التراث، بل وحتى عن الواقع الشعبي والمعيشي. إن الإنسان العربي ليس ذلك “الكائن المختبري” الذي يُعزل في شروط اصطناعية ليُدرس بمعايير أجنبية، بل هو إنسان مشبك في تاريخه، محكوم بثقافته، متصدع بالاستعمار، ومحكوم بتناقضات الحداثة.
ولعل محمد عابد الجابري كان من أوائل المفكرين الذين نبهوا إلى أهمية تفكيك “بنية العقل العربي” لفهم الشخصية العربية. فالعقل الذي لم يتحرر من “البيان” و”البرهان” ولم يستوعب “العرفان”، سيظل عقلًا منقوصًا، عاجزًا عن بناء نظرية نفسية تُعبّر عن ذاته.
رابعًا: من التأصيل إلى التأسيس… هل من أمل؟
لعل أبرز تحدٍّ أمام السيكولوجيا العربية هو الانتقال من الترجمة إلى الإنتاج، ومن التبعية إلى الاستقلال النظري. وهذا لا يعني القطيعة مع المنجز الغربي، بل يعني إعادة تشكيله في ضوء السياق العربي، تمامًا كما فعل ابن خلدون حين بنى نظرية في العمران تنطلق من واقعه لا من تنظيرات أفلاطون.
هناك بعض المحاولات التي تُبشر ببداية هذا التحول، كأعمال بدران ومليكة وحجازي، والتي سعت إلى تجاوز القوالب الجاهزة، من خلال دراسة الإنسان العربي لا بوصفه موضوعًا، بل بوصفه ذاتًا تاريخية. لكن هذه المحاولات لا تزال محصورة ومجزأة، وتحتاج إلى مشروع جماعي نقدي تتظافر فيه الجهود الفلسفية، والسيكولوجية، والأنثروبولوجية، والسوسيولوجية.
خاتمة: دعوة إلى انقلاب معرفي
ما نحتاجه اليوم ليس مزيدًا من التراكم الكمي في الأبحاث النفسية، بل انقلابًا معرفيًا جذريًا يعيد السيكولوجيا إلى جذورها الثقافية والأنطولوجية. كما قال عبد الله العروي: “الحداثة ليست تقليدًا بل هي قطيعة واعية مع التقليد”. ونحن نقول: “السيكولوجيا الأصيلة لا تُستورد، بل تُبنى من داخل الذات”.
فالإنسان العربي لا يحتاج إلى مرآة غربية يرى فيها نفسه، بل يحتاج إلى مرآة معرفية نابعة من تاريخه، ومن لغته، ومن جروحه. عندها فقط يمكن الحديث عن سيكولوجيا عربية لا تكتفي بوصف الألم، بل تملك شجاعة تحليله وفهمه وتجاوزه.