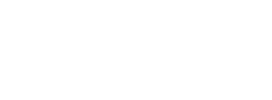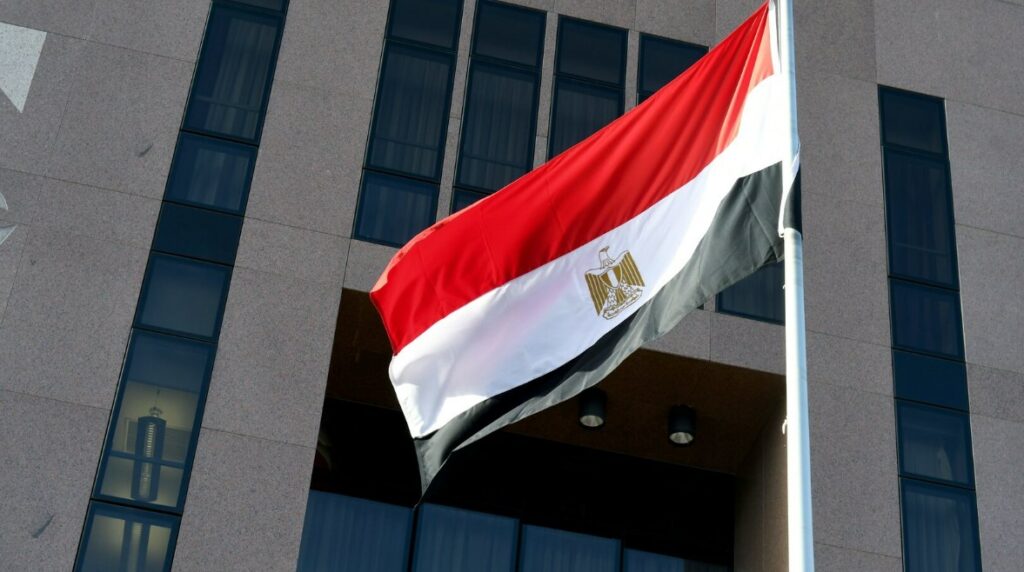التغيير السريع في سوريا أربك المنطقة، وأثار العديد من التساؤلات، والكثير من القلق. فالأمور تبقى غير واضحة، والكل يبحث عن إجابات وتطمينات بشأن المسار الذي ستسير فيه سوريا خلال المرحلة المقبلة، وما إذا كانت ستجد صيغة توفيقية بين الفصائل التي تحاربت في الماضي، أو ستتوصل إلى معادلة للسير بأمان وسط التجاذبات والمطامع الخارجية المحيطة بها. فهناك إجماع على أن المرحلة المقبلة أصعب، لأن جراحات سوريا كثيرة ومشاكلها معقدة، والأصابع الخارجية موجودة وتضيف إلى تعقيدات المشهد.
كيفية إدارة الفراغ الذي حدث بعد الانهيار السريع لنظام الأسد، هي المحك الآن، وبالتالي فإن العالم سيراقب أفعال القادة الجدد، ولن يكتفي بالتصريحات والبيانات والوعود.
إسرائيل كانت جاهزة لاستغلال الوضع، مثلما وضح من خلال عملية التوغل السريع في المناطق الحدودية لوضع اليد على مناطق استراتيجية حساسة، والتدمير الممنهج للقدرات والبنية العسكرية السورية، فيما يشبه عملية نزع السلاح لخلق «منطقة دفاع معقمة»، على حد تعبير وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.
هذا الاستعداد الإسرائيلي لم يأتِ من فراغ، وهو إن جاء في سياق توظيف تداعيات عملية «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، التي استخدمتها حكومة بنيامين نتنياهو لتدمير غزة وقدرات «حماس» و«حزب الله»، وإضعاف محور إيران، فإنه كان في الواقع سابقاً لكل ذلك، وبسنوات عديدة.
في عام 1996 أصدر نتنياهو كتاباً باللغة الإنجليزية تحت عنوان «محاربة الإرهاب»، أورد فيه ملامح من رؤيته الأمنية لمواجهة ما وصفه بآيديولوجيا الإرهاب، وسياسة الوقاية خير من العلاج، وكيفية التعامل مع الدول التي يراها داعمة للإرهاب. وعلى الرغم من أنه لم يتحدث بشكل مباشر عن سياسة تغيير الأنظمة، فإنه أشار إلى ضرورة إضعاف وعزل تلك الدول، باستخدام العقوبات والعمل العسكري عند الضرورة. وركّز وقتها على 7 دول في المنطقة بشكل رئيسي؛ هي إيران وسوريا والعراق والسودان وليبيا واليمن ولبنان، الذي ركز فيه على «حزب الله». ومع دعوته للتعاون «بين الديمقراطيات» للضغط الحازم على هذه الدول وغيرها، وعزل الأنظمة لمنعها من الاستمرار في دعم الجماعات التي وصفها بالإرهابية، فإنه لم يستبعد أن يؤدي ذلك إلى زعزعتها في سبيل دفعها لتغيير سياساتها. وكان أكثر وضوحاً عندما أشار إلى أن تغيير سلوك بعض الدول التي ذكر منها إيران والعراق، لن يتحقق إلا من خلال تغيير طبيعة النظام، وهو ما فُهم على أنه إشارة مبطنة إلى تغيير الأنظمة المعنية.
نتنياهو بالتأكيد لم يكن الوحيد بين الساسة والمنظرين في إسرائيل الذين حددوا معالم لسياسات التدخل الاستباقية في الدول ضمن الاستراتيجية الوقائية. فقبل كتابه ذاك بسنوات، وتحديداً في عام 2008، كانت هناك محاضرة أثارت اهتمام المتابعين والمعنيين ألقاها آفي ديختر، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي في ذلك الوقت، أمام معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، وتناول فيها «أبعاد الحركة الاستراتيجية الإسرائيلية المقبلة في البيئة الإقليمية» حسب العنوان الذي اختاره. وركز ديختر على 7 ساحات أيضاً هي الإيرانية والسورية والفلسطينية والعراقية واللبنانية والمصرية والسودانية، مقدماً رؤية إسرائيل الاستراتيجية لكيفية التعامل معها وفق سياسة طويلة النفس، والوسائل التي يمكن استخدامها.
وإذا كان مفهوماً في نظر الكثيرين اهتمام إسرائيل بمحيطها المباشر وبالدول التي تشعر بقلق إزائها، فإن ورود اسم السودان أثار التساؤلات، وهو ما شرحه ديختر في محاضرته بقوله إنه منذ خمسينات القرن العشرين كانت تقديرات إسرائيل أن هذا البلد بموارده الضخمة، ومساحته الشاسعة، وعدد سكانه، يمكن أن يصبح دولة قوية مضافة إلى قوى الإقليم، وبالتالي رأت أنه لا يمكن أن يُسمح له بذلك. ومن ذلك التقييم عمدت إسرائيل إلى التدخل في أزمتي السودان في الجنوب ثم في دارفور.
رؤية إسرائيل الاستراتيجية حددت الخيارات التي يمكن توظيفها في التعامل مع الدول المذكورة بدءاً من استخدام القوة، وإثارة الفتن الداخلية وخلق الفوضى، مروراً بالتواصل مع الجماعات العرقية والطائفية وقوى المعارضة المستعدة للتعاون مقابل دعمها في الوصول للسلطة، وانتهاء بإنشاء تحالفات مع بعض دول الجوار.
هكذا فإن إسرائيل تعمل دائماً للاستعداد بالخطط والاستراتيجيات الطويلة الأمد، ولا تجلس في انتظار أن تأتيها الفرص، بل تعمل لخلق الظروف التي تتيح لها تنفيذها، في حين أن منطقتنا مستغرقة في الحرائق المتنقلة التي لا تنطفئ بفعل فاعل خارجي، أو بأيادٍ داخلية. وبينما ننشغل نحن اليوم بتداعيات الحدث السوري المفاجئ، ونتخوف مما سيكون عليه اليوم التالي، وما إذا كانت سوريا ستسقط في فخ الفوضى والاضطرابات الداخلية لتلحق بركب دول أخرى في محيطنا، فإن إسرائيل تكون تخطط وتستعد للحدث الآخر المقبل.
نتحدث كثيراً عن الأمن القومي العربي، لكننا لا نملك استراتيجيات موحدة طويلة الأمد لدرء المخاطر، والتحسب للأزمات، ومعالجة الخلافات، والبحث عن مقومات التنمية المشتركة، بلغة المصالح… لا بروح العواطف المتقلبة.