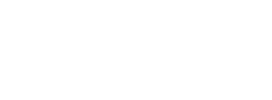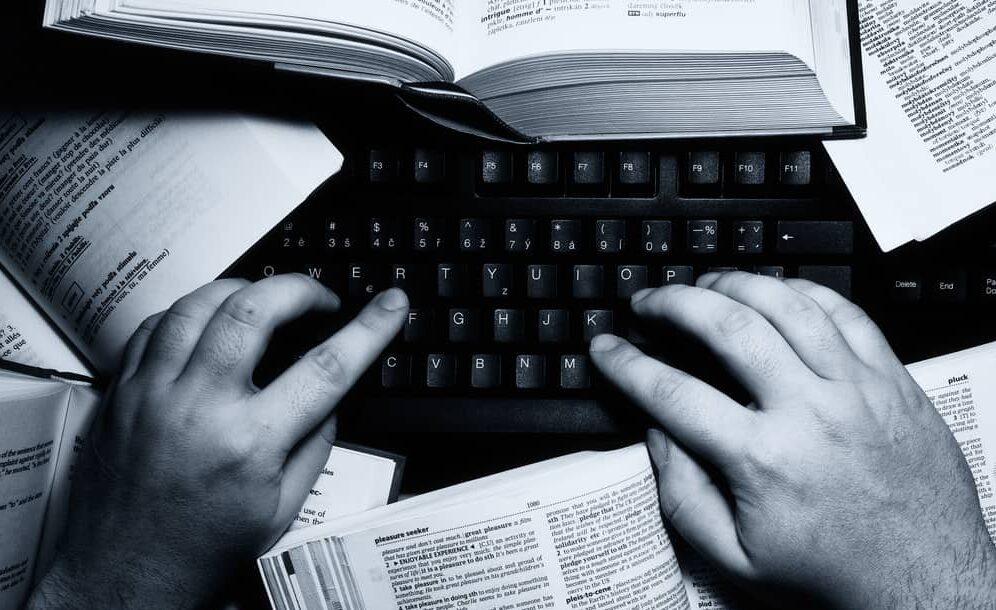بعد احتلال إسرائيل لما تبقى من أرض دولة فلسطين المنصوص عليها في قرار التقسيم العام 1947، هتف الروائي الفلسطيني الراحل، إميل حبيبي، قائلاً بسخريته المعتادة: الاحتلال وحّدنا. وكان يقصد إعادة وحدة الحال ما بين فلسطينيي الداخل المقيمين في أرضهم منذ العام 1948، وفلسطينيي القدس والضفة والقطاع الذين احتلت أرضهم العام 1967، ويبدو أن أطماع وعدوانية إسرائيل تتسبب في توسيع دائرة أعداء إسرائيل الاستعمارية، بحيث لم يعد أمر مقاومة احتلالها مقتصراً على الشعب الفلسطيني، أينما وجد، بل امتد إلى الشعوب العربية، وشعوب الشرق الأوسط، ولم يعد هذا الأمر مدفوعاً بالهواجس والتقديرات، بل هو ناجم عن عدوانية إسرائيل المباشرة والميدانية ضد أكثر من طرف، غير الطرف الفلسطيني، الرازح تحت احتلالها بمجمله منذ عقود طويلة.
وفي العرف العسكري وحتى السياسي اعتاد السياسيون التقليديون القول: إن «عدو عدوي صديقي، وصديق عدوي عدوي»، وهكذا، فإن فتح إسرائيل نار العداء ضد لبنان وسورية وإيران يعني أنه صار من الطبيعي أن ينشأ حلف مقاوم للاحتلال الإسرائيلي بين من هم أرضهم المحتلة من قبلها، وبالتحديد فلسطين ولبنان وسورية، مع مركزية فلسطين في هذا المثلث، كون كل أرض دولة فلسطين محتلة، فيما الجولان وهو بعض من أرض سورية، ومزارع شبعا وغيرها من أرض لبنان محتلة من قبل إسرائيل، ثم أن تعتبر إسرائيل إيران عدوها، فإن ذلك العداء يضع إيران في خانة الصديق لفلسطين، طبعاً إضافة إلى أنه من الطبيعي أن تقيم فلسطين علاقات الصداقة مع كل دول العالم، وعلاقات خاصة مع الأصدقاء الذي ينصرون حقها في الحرية والاستقلال، وبالتالي يقفون على مقعد الخصومة السياسية مع إسرائيل.
قبل عقود، بالتحديد ما بين عامَي 1948 – 1967، كانت حالة العداء بين إسرائيل وكل الدول العربية، خاصة دول الجوار، قائمة على أساس نصرة الشعب الفلسطيني باعتباره شعباً عربياً، ثم صار بعد العام 67، خاصة بالنسبة إلى مصر وسورية، بسبب احتلال إسرائيل لسيناء المصرية والجولان السوري، فيما بعد صارت تتفاوت درجات التعاضد مع الشعب الفلسطيني، ومستويات نصرته، لكن منذ أكثر من عام، بدأت حالة من الاصطفاف الإقليمي ببعد كوني، تتضح أكثر فأكثر، فحيث احتدت المواجهة العسكرية الميدانية بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، انضمت أميركا وبعض دول الغرب لإسرائيل، مشاركة إياها في حرب إبادة جماعية، انتفضت شعوب العالم ومنظماته الإنسانية والحقوقية، بسبب بشاعتها الفاشية، فيما شاركت قوى عربية وإقليمية المقاومة الفلسطينية فيما سمّيت جبهة الإسناد، متمثلة بشكل محدد في كل من «حزب الله» بجنوب لبنان، وجماعة أنصار الله في اليمن، والحشد الشعبي في العراق.
وبعد عام على بدء الحرب، وفي ظل انفضاض حالة الرفض والضغط العربي والدولي الرسمي على إسرائيل لوقف الحرب، لم يقتصر مجرمو الحرب الإسرائيليون على مواصلة حرب الإبادة في قطاع غزة، وارتكاب جرائم الحرب في الضفة، بل وسّعوا ساحتها لتشمل جنوب لبنان وشرقه ووسطه، وهكذا وحّدت إسرائيل ساحتَي المقاومة في جنوب لبنان مع جنوب فلسطين، وباتت حرب إسرائيل الإجرامية من الجنوب إلى الجنوب، تخوض نفس التكتيك وفق نفس الأهداف تقريباً، فيما كانت المقاومة في الجنوب هنا والجنوب هناك، تواجه العدو بنفس التكتيكات العسكرية، وهذا ما جنته على نفسها براقش.
بدأت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة بغارات جوية مكثفة، استمرت ثلاثة أسابيع، وفق منطق الحروب التقلدية، حيث يعني القصف الجوي، خاصة في ظل تفوق الاحتلال الإسرائيلي بسلاح الجو أن يمهد للحرب البرية، بما يحدثه من خلخلة في الدفاعات على الجانب الآخر، وتحولت إسرائيل للحرب البرية بعد أن قصفت آلاف المواقع التي قالت إنها مراكز قيادة «حماس»، كذلك بدأت في لبنان بعملية تفجير «البيجر» وجملة اغتيالات لقيادات «حزب الله»، قالت إنها شلت الحزب وقطعت أوصاله، بحيث صار بإمكانها أن تشن العملية البرية بسهولة، والحقيقة أن إسرائيل حققت مكاسب تكتيكية حققها سلاحاها الأقويان، وهما الجو والاستخبارات، وطالت قيادات «حماس» بمن فيهم أمينها العام إسماعيل هنيّة ومن قبله نائبه صالح العاروري، ثم يحيى السنوار، كذلك طالت قيادات «حزب الله» بمن فيهم أمينه العام حسن نصر الله، وفؤاد شكر، وإبراهيم عقيل، لكن في الحرب البرية كان للميدان رأي آخر.
وحيث واصلت إسرائيل سياسة الأرض المحروقة، حتى يكون جنوب فلسطين، أي قطاع غزة، غير قابل للعيش، بتدمير كل المباني السكنية، وارتكاب المجازر اليومية طوال 400 يوم حتى الآن، حيث نكبت غزة بعشرات الآلاف من سكانها بين شهيد وجريح ومفقود ومعاق، تمارس إسرائيل منذ شهرين نفس السياسة بتدمير القرى في جنوب لبنان وتدمير المباني فوق رؤوس ساكنيها في ضاحية بيروت الجنوبية، ولولا أن الحدود مفتوحه بين جنوب لبنان وشماله وحتى مع سورية، حيث نزح نحو مليون ونصف المليون، لكان عدد الضحايا المدنيين اللبنانيين ليس أقل بالمعدل اليومي عن الضحايا في قطاع غزة. بالمقابل تواصل المقاومة في غزة تنفيذ العمليات، كذلك تفعل المقاومة اللبنانية.
لهذا، فإن صورة الاحتلال الإسرائيلي في غزة باتت أشبه بصورة الجيش الأميركي في فيتنام خلال الفترة ما بين 1955 – 1975، لجهة تتابع الخسائر، فيما «حزب الله» الأكثر قوة واقتداراً من «حماس» ما زالت بجعبته الصواريخ والمسيّرات، والحدود المفتوحة حتى على التزود بالعتاد والسلاح والمقاومين، وما زال يتدرج في التوّغل بالعمق الإسرائيلي بصواريخه ومسيّراته وفق قاعدة التوازن المسماة قواعد الاشتباك، بينما تقوم قواته بمهمتها في التصدي للتوّغل البري الإسرائيلي على أكمل وجه.
والحقيقة أن كل ما يقال عن اضطراب في الأهداف الإسرائيلية من حربها ما بين الجنوب والجنوب غير دقيق، رغم ظهور خلافات سياسية معلنة أو مفتعلة بين تل أبيب وواشنطن، وبين قادة حرب الإبادة الإسرائيليين أنفسهم، نقصد بين نتنياهو وكل أعضاء حكومته من جهة، وبين من انضم اليهم مباشرة بعد 7 أكتوبر العام 2023، أي بيني غانتس وغادي آيزنكوت، ويوآف غالانت، وصولاً إلى استقالة غانتس وآيزنكوت وإقالة غالانت، إلا أن الحقيقة أن أهداف إسرائيل واضحة، لكن الخلافات نشأت، بصرف النظر إن كانت مفتعلة أو لا، حول طبيعة الأهداف التي يجب أن تظل مخفية وتلك المعلنة، وقد توافق جميع مجرمي الحرب بمن فيهم جو بايدن على إسقاط «حماس» وسحقها عسكرياً، وإعادة المختطفين، ومنع غزة من أن تشكل تهديداً، وكذلك على تدمير «حزب الله» وتجريده من السلاح، وإبعاده لما وراء الليطاني، لكن في لحظات النشوة العسكرية كانت الأهداف الحقيقية تظهر، من مثل إعادة احتلال واستيطان غزة، وتهجير سكانها بالكامل، بل وفي الذروة حين نجح نتنياهو في اغتيال نصر الله، أعلن بوضوح نيّته إعادة تشكيل الشرق الوسط وفق إرادته ورغبته ورؤيته، بما في ذلك اعتبار التطبيع أمراً تفرضه إسرائيل وحتى أنها غير ملزمة بإجراء الحوار حوله مع أحد.
أما الحرب الإسرائيلية في فصلها الأخير، فإنها تذهب في أحسن الأحوال إلى وقف إطلاق نار، وليس إلى إنهاء حرب، لأن إسرائيل عجزت عن تحقيق النصر، وهي تسعى إلى التوسع الجغرافي، والبداية في شمال قطاع غزة والشريط الحدودي لجنوب لبنان، وهذا بحجة إقامة المناطق الأمنية في محيط إسرائيل، الجولان، جنوب لبنان، شمال قطاع غزة، تبقى الضفة الغربية والأردن، حيث لا حدود للأطماع التوسعية الإسرائيلية، وما دامت العنصرية تقود المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية وتتحول إلى برامج عمل وسياسات حكومة، فإنه لن تكون هناك أي اعتبارات سياسية واقعية، لا أممية ولا إقليمية يمكنها أن تقنع إسرائيل اليمينية المتطرفة باحترام جيرانها باتفاقيات أو بغيرها، وفقط يمكن لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي التي تتوسع دائرتها ويتعمق نطاقها، وتقوى فاعليتها يوماً بعد يوم، أن تصد إسرائيل، ثم تواصل التقدم في حرب استنزاف طويلة الأمد، وإذا كانت اليوم قد وحّدت بين المقاومة الفلسطينية واللبنانية، فإنها ستوحّد كل شعوب الشرق الأوسط المحيطة بإسرائيل فيما بعد.