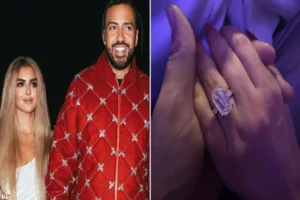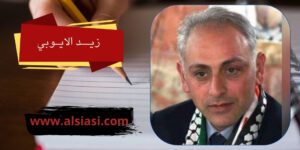يُتداول كثيراً في الفلسفة المعاصرة والسوسيولوجيا السياسية مفهوم “موت الأيديولوجيا”، وكأننا أمام إعلان نهاية عصر طويل من الهيمنة الفكرية على الوعي الجمعي. غير أنّ هذا “الموت” ليس موتاً بيولوجياً أو انطفاءً نهائياً، بل هو أشبه بتبدّل الأشكال والأنماط التي تتخفّى فيها الأيديولوجيا، لتظل كامنة في بنية الفكر والوعي، وإن تظاهرت بالنزعة العقلانية أو البراغماتية البحتة. فالحديث عن أفقٍ خالٍ من الأيديولوجيا إنما هو ـ كما يرى بعض المفكرين ـ ضرب من “العقل الأسطوري” الذي يوهم أصحابه بإمكان التفكير المحايد والمطلق، أو ضرب من “التفكير الرغبي” الذي يطمح إلى عالم بلا صراعات ولا مرجعيات.
لقد ذهب الفيلسوف لويس ألتوسير إلى أن الأيديولوجيا “لا تُغادرنا”، فهي لا تعكس الواقع بل تُمَثِّله من خلال البُنى الرمزية التي تشكّل وعينا. كما اعتبر سلافوي جيجك أنّ وهم موت الأيديولوجيا نفسه هو أقوى أشكالها المعاصرة، إذ ما يُسمّى بالحياد التقني أو الليبرالي ليس سوى أيديولوجيا متخفية تُعيد إنتاج النظام الاجتماعي ـ السياسي القائم. وهنا يتضح أنّ إعلان موت الأيديولوجيا ليس سوى ولادة لأيديولوجيا جديدة أكثر دهاءً: أيديولوجيا “اللا أيديولوجيا”.
وإذا عدنا إلى فرانسيس فوكوياما ونظريته عن “نهاية التاريخ”، نجد أنّه قد بشّر بموت الأيديولوجيا عبر انتصار الليبرالية الديمقراطية باعتبارها الأفق النهائي للتاريخ السياسي للبشرية. لكن هذا الطرح لم يلبث أن تهاوى أمام عودة الهويات الدينية والقومية، وصعود الشعبويات، وتنامي التيارات التي تعيد تشكيل العالم على أسس تناقض الادعاء الليبرالي الكوني. لقد أثبت الواقع أنّ التاريخ لا ينتهي، وأن الأيديولوجيا لا تموت، بل تتوالد وتتمدد بأقنعة جديدة.
الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس، من جهته، رأى أن العقل التواصلي يمكن أن يفتح المجال لتجاوز الأيديولوجيات الشمولية التي حوّلت العقل إلى أداة للهيمنة. لكنه لم يُلغِ الأيديولوجيا بقدر ما دعا إلى عقلانية نقدية قادرة على فضح الأنساق المغلقة، والتمييز بين “المعرفي” و”الإيديولوجي”. فالوعي الجمعي، كما يذهب كارل مانهايم، لا يمكن أن يكون بلا أيديولوجيا، لأنها البنية التي تُمَفْرِغ فيها الجماعات مصالحها وتصوراتها للعالم.
إنّ ما يُسمّى بـ”موت الأيديولوجيا” إذن ليس سوى تحوّل في بنيتها، من أيديولوجيات كبرى معلنة (الماركسية، القومية، الليبرالية، الأصوليات الدينية) إلى أيديولوجيات مُقَنَّعة تتخفّى في شعارات التقنية، السوق الحر، الحياد الإعلامي، أو حتى في سرديات “النهاية” ذاتها. إنها، بتعبير فريدريك جيمسون، حضور مُستتر في ثوب الثقافة المعولمة، حيث تغدو الأيديولوجيا اليومية أشد رسوخاً لأنها غير مرئية.
إنّ الأيديولوجيا لا تموت لأنها تمثّل آلية بنيوية في تشكّل الوعي، إذ لا يمكن للفكر أن يتحرك في فراغ خالص. وما يبقى على المثقف والفيلسوف هو أن يفتح أعين الناس على الأيديولوجيا التي تعيش في داخلهم، لا أن يزعم التحرّر المطلق منها. ولعلّ ما قصده بول ريكور حين تحدّث عن “هرمنيوطيقا الشك” هو هذا الوعي النقدي الذي يحفر في العمق، كاشفاً الأقنعة عن الوعي الزائف.
من هنا، فإن الحديث عن موت الأيديولوجيا إنما هو إعادة إنتاج لأسطورة جديدة، لا تقل عن أسطورة حياد العقل، أو صفاء الوعي. الأيديولوجيا تتبدّل ولا تنقرض، تتخفى ولا تزول. فهي مرآة الإنسان وهو يفتش عن ذاته في التاريخ، ومادام الصراع قائماً، سيبقى للأيديولوجيا ألف قناع وألف حياة.