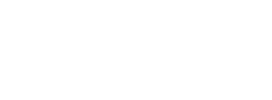قبل إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية في 5 نوفمبر المقبل، هناك ما يشير إلى أن هناك تطورات ستعلن عن نفسها في مسارات العلاقات الأميركية الإسرائيلية مع تصميم الإدارة الأميركية على أحداث اختراق في مسار ما يجري لأسباب تتعلق بالداخل الأميركي من جانب، والتخوف من استمرار المشهد برغم كل التطورات الجارية على ما هو عليه، أو الذهاب إلى تنفيذ بعض الاستحقاقات وتأجيل بعضها، أو تجميدها في ظل حال عدم الاستقرار في الحكومة الإسرائيلية الراهنة، والتي ستدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لتدوير حساباته السياسية في الفترة المقبلة بصرف النظر عما يجري في إطار الحرب على غزة.
وفي هذا الإطار سيتزايد الانقسام الإسرائيلي الآخذ بالاتساع من حالة الضغط بشكل كبير على نتنياهو، إذ باتت حكومته ومجلس الحرب محط الأنظار، إذ يبدو واضحاً، أن الخلاف ليس على الحرب نفسها، وإنما تصفية حسابات بين الخصوم في وقت السلم وشركاء في وقت الحرب، وسيتعرض رئيس الوزراء نتنياهو لضغوط متزايدة من حلفائه اليمينيين المتطرفين الذين هددوا بالاستقالة من الحكومة، إذا مضى قدماً في مقترح التهدئة، وقد شدد شريكا نتنياهو اليمينيان المتطرفان في الائتلاف، وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، على أنه لا ينبغي للحكومة إبرام أي اتفاق ومواصلة الحرب حتى يتم تحقيق الهدف النهائي المتمثل في تدمير «حماس» كما سيفتقد نتنياهو شركاءه الوسطيين الذين ساعدوه في تفادي سيناريو التصعيد، والذي من شأنه أن يؤدي إلى عزلة دولية أكبر من أي وقت مضى، وتعميق الأزمة غير المسبوقة بالفعل مع الولايات المتحدة. واقعياً يمتلك رئيس الوزراء نتنياهو بدائل للتصعيد، بالانفصال عن «اليمين المتطرف»، وقبول غطاء المعارضة لدعم حكومته مقابل وقف إطلاق النار، واتفاق لإطلاق سراح الرهائن، والخيار الآخر هو حل الكنيست والرهان على الانتخابات.
لكن حل الكنيست خطوة غير مأمونة العواقب، إذ تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن ثلاثة أرباع الإسرائيليين يؤيدون رحيل نتيناهو، إنْ لم يكن الآن، فبعد الحرب وسيتوقف الاستمرار في صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين على انعكاسها على استطلاعات الرأي، فلو وجد نتنياهو أن أسهمه ترتفع في حال الذهاب نحو انتخابات مبكرة سيكمل الصفقة، لكن لو توصل إلى قناعة أنها تراجعت، فسيعود للحرب من جديد، وليس بخاف أن ما يهدد تماسك الحكومة، فهو قانون التجنيد، والخاص بإرغام اليهود الحريديم (طائفة دينية ترفض التجنيد منذ تأسيس إسرائيل في 1948) على الخدمة داخل الجيش. والسبب في ذلك، أنه ما دام أن قانون التجنيد لم يحسم بعد في الكنيست، وتم تأجيل النظر في تفاصيله، فهذه الحكومة ستظل مستمرة. وعلى المستوى الأميركي، فإن إدارة بايدن ستعمل على استعادة جثث 3 أميركيين يعتقد أنهم قتلوا خلال هجوم السابع من أكتوبر، وهناك قناعة أميركية بأن «حماس» ربما يكون لديها حافز لعقد صفقة أحادية مع واشنطن، لأنها من المرجح أن تزيد التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وتضع ضغوطاً سياسية داخلية أكبر على نتنياهو، خاصة وأن الرئيس الأميركي بايدن يواجه ضغوطاً لإنهاء القتال في غزة.
وينقسم حزبه «الديمقراطي» حول دعمه للهجوم الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني، إذ هدد الناخبون في الولايات الرئيسة التي تمثل ساحة منافسة حامية بعدم دعمه في انتخابات نوفمبر المقبل في مواجهة مع المرشح «الجمهوري» الرئيس السابق ترامب، خاصة وأن قد يكون ما يجري من محاولات أميركية عربية للتوصل للتهدئة إذا تم التوافق على البدء في تنفيذ الاتفاق سيعزز فشل مبادرة بايدن، وتعطيل تنفيذه قرار مجلس الأمن بشأن غزة الحرب الإسرائيلية على القطاع وسيشجعها على دخول المناطق المكتظة بالسكان في رفح ومخيمات المحافظة الوسطى، وربما إعادة رسم خارطة «اليوم التالي» الذي ما زالت الولايات المتحدة تعتقد أنه يجب أن يكون دون تدخل إسرائيلي مباشر.
في المجمل، فإن خريطة الطريق لإنهاء الحرب في غزة التي قدمها الرئيس الأميركي على أساس اقتراح إسرائيلي تعكس الطريقة المختلفة التي يرى بها كل طرف أهدافه، حيث تستطيع «حماس» أن تؤكد أنها حققت إنجازاً مهماً، فقد نجحت في إقناع الإدارة الأميركية بمطالبة إسرائيل بوقف الحرب، وإبقاء «حماس» في السلطة في القطاع، وهو هدفها الرئيس منذ السابع من أكتوبر، كما أن فرص فرض ذلك على إسرائيل زادت بصورة لافتة، ومن ثم فإن المتغيرات تجعل من الممكن أن تكون الحكومة الإسرائيلية، وغالبية الإسرائيليين الجمهور الاسرائيل المؤيد والمعارض لاستمرار الحرب في قطاع غزة على استعداد للمضي قدماً في المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى، مع التكاليف الباهظة التي ينطوي عليها تنفيذها، وفتح مناقشات حول المرحلتين الثانية والثالثة، لكن هناك رفضاً واضحاً لقبول طلب إنهاء الحرب، واستمرار حكم «حماس». في هذا السياق، ستظل إذن سياسة الرئيس بايدن تتأرجح بين الثوابت التقليدية في دعم إسرائيل، وبين محاولة الضغط عليها من أجل استعادة دور الحليف الأكبر القادر على حث إسرائيل على تغيير بعض المواقف الراهنة.
نقلا عن “الاتحاد”