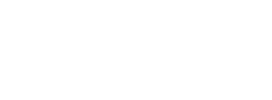عندما يصبح قبول الهزيمة أقل الخسائر، نستطيع القول بثقة إن الكيان الصهيوني في طريقه إلى الزوال. خلال 76 عاماً، هي تاريخ الصراع مع هذا الكيان، رددنا عبارات تشير إلى قرب زواله، ووصفناه بالكيان الموقت، أو الزائل، حتى أصبحت هذه العبارات مثاراً للتندر عند دعاة الاعتدال وقبول الأمر الواقع. اليوم، عادت هذه المصطلحات لتحتل موقع الصدارة في أدبياتنا بفضل الانتصارات الحاسمة التي يحققها محور المقاومة في كل جبهات القتال.
يعود مصطلح “المسألة اليهودية” إلى منتصف القرن الثامن عشر، وظهر في سياق مناقشات “مشروع القانون اليهودي” في إنكلترا عام 1753.
منذ ذلك التاريخ، تعددت الدراسات والحلول المقترحة لهذه المسألة، والتي يمكن اختصارها بثلاثة أطروحات رئيسة، هي:
1- دمج اليهود في المجتمعات الأوروبية بعد تخليهم عن التزمت الديني الملازم للديانة اليهودية وقبولهم المساواة والمواطنة في الدولة العلمانية الليبرالية، كما عبّر عنه برونو باور، أو الاندماج عبر التحرر الاجتماعي الاقتصادي، كما عبر عنه كارل ماركس في أطروحته “حول المسألة اليهودية”.
2- الحل النهائي للمسألة اليهودية، عبر إبادة أكبر عدد ممكن من اليهود وطردهم من أوروبا، وهو الحل الذي تبناه الحزب النازي الألماني، مع التأكيد أن معاداة السامية بدأت في اوروبا في زمن سابق بمئات الأعوام لظهور الحزب النازي
3- إقامة “الدولة اليهودية” كـ”وطن آمن ونهائي لليهود”، كما اقترحها ثيودور هرتزل، مع تفضيله أن تكون هذه الدولة في فلسطين، مع وجود مقترحات بإقامتها في مدغشقر، أو أوغندا.
التقت مصالح الحركة الصهيونية مع مصالح الدول الاستعمارية المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، فكان إنشاء الكيان الصهيوني في فلسطين عام 1948 دمجاً للحلين الثاني والثالث، إذ رحل جزء كبير من يهود أوروبا الغربية إلى الولايات المتحدة، في حين انتقل الجزء الأكبر من يهود شرقي أوروبا إلى فلسطين.
بإنشاء الكيان الصهيوني تخلصت اوروبا من مسألتين: العبء الأخلاقي الذي خلفته معاداة السامية والهولوكوست، اللتين أُلصقتا بهتلر منفرداً، وعبء الوجود اليهودي المرفوض في المجتمعات الأوروبية.
يضاف إلى ما سبق المهمات التي أناطها الاستعمار بالكيان الصهيوني في منطقتي آسيا وأفريقيا، والقائمة على حماية مصالح القوى الاستعمارية بصورة مباشرة وعلى الأرض. لهذه الأسباب، عملت القوى الاستعمارية مجتمعة، بكل قواها، على دعم الكيان الصهيوني، في محاولة لتأبيده في جغرافيا المنطقة، وجعله لاعباً أساسياً في سياستها واقتصادها.
لوهلة، بدت الأمور كأن الاستعمار نجح في مسعاه، وأن وجود هذا الكيان أصبح مقبولاً عالمياً وعربياً، على نطاق واسع، وسقط الفيتو الفلسطيني على مشاريع السلام، وذهبت الدول العربية، بمعيّة الولايات المتحدة، إلى اتفاقيات السلام، في كامب ديفيد، ووادي عربة، واوسلو، والسلام الإبراهيمي، وأصبح القبول النهائي للوضع القائم مرتبطاً بموافقة “إسرائيل” على التنازل عن 22% من مساحة فلسطين، وقبول حل الدولتين، على أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح، أو ملحقة بالأردن.
لو أغمضنا أعيننا قليلاً، وعدنا بالذاكرة ثمانية شهور، لوجدنا أن معظمنا قبل تلك النتيجة يأساً أو استسلاماً، باستثناء قلة حملت البندقية وقررت الذهاب في اتجاه ما كان يُعتقد أنه المستحيل. لنفتح أعيننا الآن، ونَستَعِدْ، في ذاكرتنا، وما حدث منذ فجر السابع من أكتوبر. في نهاية ذلك اليوم كانت المقاومة حققت النصر على رابع أقوى جيش في العالم، وأنهت إلى الأبد أسطورة “الوطن الآمن لليهود”. انتصرت المقاومة… وانتهت المعركة.
صباح اليوم التالي، بدأت حرب جديدة؛ حرب بين محور المقاومة والمركز الرأسمالي الاستعماري، الذي هرع لنجدة مشروعه في منطقتنا. كان حضور حاملة الطائرات جيرالد فورد إعلاناً لهذه الحرب، وتبعتها حاملات طائرات أوروبية، وأصبحت “تل أبيب” محجاً لزعماء الدول الغربية. الجميع يعلن تضامنه، ويؤكد التزامه حماية أمن “إسرائيل”.
في ظل هذا الحشد السياسي والحشد العسكري، كانت التقديرات تشير إلى معركة قصيرة الأجل، تذكّرنا بما حدث في العراق عام 2003. واعتقد المحتشدون أن تدخل محور المقاومة سيكون محدوداً ولن يؤثر في سير المعركة، وخصوصاً بعد تهديد الرئيس بايدن بالتعامل مع أي جهة خارجية تتدخل في المعركة.
على مدى أكثر من سبعة شهور، تلقى التحالف الغربي الهزيمة تلو الأخرى. قوى المقاومة صامدة على الأرض بصورة تناقض المنطق العسكري والمنطق الاستخباري، والجبهات المساندة اشتعلت فحولت المستوطنات والمدن المحتلة في شمالي فلسطين إلى مدن أشباح، والتجارة العالمية تعاني بعد إغلاق السبل في وجهها، وارتفاع تكاليف الشحن بصورة كبيرة. وبات الاقتصاد العالمي المترنح في مهب أزمة جديدة قد يعجز عن مواجهتها.
لم تكتفِ المقاومة بالنصر العسكري، فانطلقت من أجل تحقيق انتصارات سياسية وثقافية وقانونية. تحت ضغط الجماهير التي خرجت في شوارع الدول الغربية وجامعاتها ومهرجاناتها الفنية، مؤيدة للقضية الفلسطينية، اضطرت الدول الغربية إلى إلغاء قرارها وقف دعم وكالة الأونروا، فبدأت سلسلة الاعترافات بدولة فلسطين من دول غربية، في سابقة لم يستطع النضال، فلسطينياً وعربياً، تحقيقها على مدى أعوام الصراع. وارتقى وعي الغرب بالقضية الفلسطينية بصفتها قضية تحرر وطني لشعب يرزح تحت الاحتلال منذ 76 عاماً.
قانونياً، تتوالى قرارات المحكمة الجنائية. وإن كانت لا تملك صفة الإلزام في شقها المتعلق بوقف الحرب، فإنها ملزمة فيما يتعلق بمذكرات إلقاء القبض على المسؤولين الصهاينة، الأمر الذي دفع بعض المشرعين الأميركيين، وعلى رأسهم السيناتور ليندسي غراهام، إلى المطالبة بإيقاع عقوبات على هذه المحكمة، التي يمكن أن تتحرك مستقبلا في اتجاه الجرائم التي يرتكبها جنود بلاده.
انتقال هذه القرارات إلى مجلس الأمن، لتفعيلها أو رفضها، يضع الدول الغربية في مأزق كبير. الامتناع عن التصويت يعني صدور قرار تحت البند السابع من الميثاق الذي يعني إجبار “إسرائيل” على تنفيذ القرارات بالقوة. من ناحية أخرى، فإن استخدام حق النقض “الفيتو” يعني موافقة الدول الغربية ودعمها للإبادة والمجازر الجماعية التي تُرتكب في غزّة.
بين هذه الخيارات، يعيش النظام الرأسمالي تحت وطأة “المسألة الإسرائيلية”، التي تستنزفه عسكرياً، وسياسياً، واقتصادياً، وأخلاقياً.
لم يبقَ من حل لهذه المسألة سوى وقف إطلاق النار والاعتراف بالهزيمة، بصفتها أقل الخسائر، وبغير ذلك فإن هذا الكيان سيذهب إلى الزوال المحتّم، في المدى المنظور.