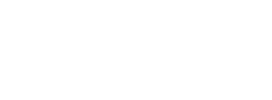منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023، انهالت على أَسماعنا وأَبصارنا كمياتٌ من المقالات والكتابات والأحاديث التلفزيونية والإذاعية التي لو شُقِعَ بعضُها فوق بعض لطاولت السحاب؛ وهذا طبيعيٌّ، نظراً إلى خطورة ما جرى في ذلك اليوم، وما حدث بعده. واللافت أن كثيراً من تلك الكتابات تخصّص بالكلام أن نهاية دولة إسرائيل قد بدأت، وأن اندثار الدولة الصهيونية بات قاب قوسين أو أدنى. وفي هذا الميدان، جرى استحضار مقولات وتقوّلات وأقاويل ذات طابعٍ قياميٍّ عن قرب تحرير القدس، علاوة على استخراج حكاياتٍ ثاويةٍ في مطموراتنا الغبراء وفي كتب الفتن والملاحم كالجفر وعلامات الظهور وأشراط الساعة وغيرها من المؤلفات العتيقة. وهذه الكتابات ليست جديدة قط، وإنما يُعاد إحياؤها بين الفينة والفينة بحسب مجريات الأحوال. ففي سنة 1999 توقّع الشيخ الراحل أحمد ياسين زوال إسرائيل في سنة 2027، أي بعد 40 سنة من اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى في 1987 (انتفاضة الحجارة). ونحتاج إلى أربع سنوات فقط لنختبر هذا التوقع.
لكن “الأكاديمي” الفلسطيني يوسف الأسطل توقّع في 2005 زوال الاحتلال الإسرائيلي عن الضفة الغربية كلياً في سنة 2010، وعن فلسطين كلها في 2017 (راجع: حوار مع يوسف الأسطل، القدس برس، مجلة “الأمان” اللبنانية في 2-9-2005 وصحيفة “الرأي العام” الكويتية في 8-9-2005)، وهو ما ثبت بطلانه. ولم تنجُ مدينة القدس من هذا الطراز من الكتابات المُشلّة للوعي والمعوِّقة للتفكير العلمي. فنقرأ هنا وهناك أن القدس بُنيت بإرادة سماوية، والربّ اختارها لتكون أرض المحشر والمنشر، وهي أرضُ الإسراء والمعراج التي فتحها عمر بن الخطاب وحرّرها صلاح الدين. لكن المغرمين بهذه العبارات الزجلية ينسون أن يضيفوا إليها أن يغئيل يادين احتلّ قسمها الغربي في سنة 1948، واحتل قسمها الشرقي إسحق رابين ومعه مردخاي غور في 1967، وضمّها موشي دايان إلى إسرائيل في السنة نفسها، وصارت عاصمة لإسرائيل في 1980.
مهما يكن الأمر، فإن ذلك النوع من الخطب التعبوية يُرضي عوامّ الناس الذين يتطلعون إلى نوع من الأمل في خضم أيامهم المدلهمة. لكن مخاطر تلك الخطب تكمن في التحوّل إلى نوع من “قدرية” التفكير، وأن كل شيء مرسومٌ سلفاً ومحفوظ كألواح القدر. وبهذا المعنى، لا يُعتدّ قط بالمدرسة القدرية في التحليل المستقبلي، لأنها لا ترى في الواقع غير سلسلة من الانتصارات الموعودة. وكم تمنّيتُ لو كنتُ قادراً على استدخال تلك “الثقافة” في أدواتي التحليلية، ولهذا لا أستطيع الاستخلاص من المعارك المحتدمة في غزّة منذ تسعة شهور أن إسرائيل هُزمت تماماً، وأننا انتصرنا نصراً مؤزراً؛ فتلك الخلاصة نتيجة قطعية لا تجوز على الإطلاق في الكتابات المسؤولة، لأنها لا ترى الواقع كما هو، بل ترى جوانب جزئية منه فحسب. وأستذكرُ هنا “تجربة” أبو حيان التوحيدي عن الحقّ (الواقع) حين حدّثنا عن عقلاء اختاروا مجموعة من العميان. وأحضروا لهم فيلاً، وتركوهم يتلمّسونه بأيديهم.
ثم طلبوا من كل واحد منهم أن يصف الفيل. فمن أمسك الخرطوم وصف الفيل وصفاً مختلفاً عمّن أمسك ذنبه. ومَن تحسّس بطن الفيل وصفه بطريقة مختلفة عمّن تحسّس قوائمه. لذلك قال أبو حيان: “إن الحق لم يُصبْه جميع الناس في جميع وجوهه، ولا أخطأوا في جميع وجوهه، بل أصاب كل واحدٍ جهةً”. وثمة مثال السمكة الذهبية الموضوعة في إناء مقعّر؛ فهي ترى الواقع غير ما نراه نحن مع أنه واحد، لكنه يخضع لزوايا نظر متعدّدة. ولهذا سأحلّ في محل أبو حيان التوحيدي عند النظر في الحرب الهمجية الدائرة في قطاع غزّة، ولا سيما بعد مجزرة مواصي خانيونس في 13 يوليو/ تموز الجاري.
حسابات النصر والهزيمة
يستعيد بعض المحلّلين والإعلاميين البيانات الإسرائيلية الأولى بعد عملية السابع من أكتوبر التي نصّت على استعادة الأسرى، وتدمير سلطة حركة حماس في قطاع غزّة، وقتل قادتها، وتأليف هيئة لإدارة شؤون غزّة بحيث لا يبقى القطاع مصدر تهديد لإسرائيل، وهو ما لم تحقّقه إسرائيل البتة. وهذا يعني، بحسب هؤلاء، أنها فشلت في تحقيق أهدافها، أي أنها هُزمت. وحساب المرابحة هذا يفتقر إلى العلمية، ويشبه حسابات “الدّكنجية”. فلو أن إسرائيل أعلنت في بياناتها الأولى أنها لا تريد غير احتلال قطاع غزّة وتدمير مدنه وقتل ما أمكن من الناس (وهو ما تحقّق بالفعل)، فهل تكون انتصرت، إذن؟ المسألة ليست لغوية أو براعة في صوغ البيانات. ومثل تلك الحسابات تبدو بمعايير العلم هراء، لأن عدم تحقيق الأهداف كلها لا يُعدّ هزيمة كاملة.
تعم التظاهرات العالم وتشهد انفكاك أعداد متزايدة من اليهود عن إسرائيل وانعطافها نحو تأييد الفلسطينيين
نعم، ثمّة إخفاقاتٌ إسرائيليةٌ شتّى تجلت في أن الأسرى ما زالوا في أيدي حركة حماس، وأن المقاومة لم تُهزم، على الرغم من خسائرها الكبيرة جدّاً، ولم يجر التوصل إلى حلٍّ لإبعاد حزب الله عن المستعمرات الإسرائيلية في شمال فلسطين المحتلة، وما زال عشرات ألوف الإسرائيليين مهجّرين هنا وهناك. وإسرائيل بهذه الصورة لم تحقق كل ما أرادته، لكنها حققت كثيراً مما أرادته، مُقتفيةً في ذلك أحطّ الطرائق الهمجية والانتقامية التي شهدتها عصور الاستعمار. فقد أعادت احتلال قطاع غزّة، ودمرت كل شيء فيه، وقتلت أعداداً غير محدّدة من المقاتلين والسكان (نتّجه إلى خمسين ألف شهيد بمن فيهم المفقودون، وإلى تسعين ألف جريح وبينهم عشرات ألوف المعوّقين المبتورة أطرافهم)، وهي تسعى بمساندة الولايات المتحدة إلى تقرير مصير قطاع غزّة ومستقبله بمعزل عن إرادة سكانه، بحيث تكون أزرار التحكّم بشؤون القطاع بين أيدي أجهزتها الأمنية.
نوايا إسرائيل المعلنة
ومنذ البداية، لم تُخفِ إسرائيل نيّاتها وغاياتها، فقد أعلن نتنياهو في 16-12-2023 أن إسرائيل لن تسلّم قطاع غزّة إلى أي جهة، وهي لا تريد إطلاقاً أن تكون السلطة الفلسطينية موجودة فيه. وحذا وزير الحرب يوآف غالانت حذوه بإعلانه أن اسرائيل ستحكم القطاع عسكرياً. واليوم يبدو بوضوح أن المفاوضات الدائرة بين القاهرة والدوحة وواشنطن وتل أبيب تشير إلى ملامح مستقبلية (ربما تتطوّر تلك الملامح إلى ما يشبه اتفاق الأمر الواقع)؛ اتفاق يقضي بأن السلطة الفلسطينية لن يكون لها أي شأن في تقرير مستقبل غزّة، وأن غزة ستكون منطقة يديرها آخرون غير إسرائيليين، لكن الإسرائيليين سيعملون فيها بحرية، أمنياً وعسكريّاً.
إسرائيل عالقة
إسرائيل عالقة، بلا شك، في حربٍ لم تستطع حسم نتائجها طوال تسعة شهور. وأصحاب القرار، أي نتنياهو ومجموعته، مرتبكون جدّاً: هل يوقفون الحرب عند هذا الحد؟ أم يستمرّون فيها بطرائق مختلفة؟ ومنشأ الإرباك أن إسرائيل ترفض بقوة، حتى اللحظة، أي وجود لحركة حماس في غزّة، ولا تريد أي وجود للسلطة الفلسطينية في الوقت نفسه. ولم تتمكّن من إيجاد جماعة محلية تتعاون معها في إدارة الشؤون اليومية لسكّان القطاع بعد أن يتوقف القتال، ولم تستطع الاستحصال على موافقة مصر والأردن والسعودية والإمارات على تشكيل قوة عسكرية مختلطة لفرض النظام على القطاع، في وقتٍ لا تريد فيه البقاء في جميع أنحائه، ولا تستطيع الانسحاب منه قبل التوصل إلى اتفاق ما في هذا الشأن.
إسرائيل اليوم دولة منبوذة، فهي تُحاكم أمام محكمتي العدل والجنايات الدوليتين، والاعترافات بالدولة الفلسطينية تتتالى حتى من دول صديقة لإسرائيل، والمقاطعة الاقتصادية والأكاديمية لإسرائيل تتّسع، والتظاهرات تعم العالم وتشهد انفكاك أعداد متزايدة من اليهود عن إسرائيل وانعطافها نحو تأييد الفلسطينيين. وعلى الرغم من ذلك، إسرائيل سادرة في غيّها؛ فما دامت الولايات المتحدة تسند قوائمها وتحمي ظهرها فهي لا تلتفت إلى أحد. وهي، فوق ذلك، مستعدّة للاستمرار في هذه الحرب شهوراً إضافية بذريعة أنها حرب وجود، وأن مصير إسرائيل ستقرّره خاتمة هذه الحرب. ولتعديل ذلك الإرباك، اقترح بعضهم على نتنياهو ما كان مستشارو الرئيس الأميركي ليندون جونسون قد اقترحوه عليه في ذروة حرب فيتنام: اخرج من فيتنام وأعلِن النصر. لكن نتنياهو لا يستطيع، حتى بعد مجزرة مواصي خانيونس، أن يُعلن النصر، ويوقف المعارك، ويخرُج من قطاع غزّة؛ ففي هذه الحال تكون الهزيمة قد حاقت به حقّاً في ما لو اتّخذنا معيار النتائج المتحققة في الحسبان، وهو ما لا يلوح في الأفق ألبتة.
كوارث غزة لا تُعد ولا تُحصى
كوارث غزّة على وجوه لا ينتهي عدّها، والثمن باهظٌ جدّاً جدّاً جدًاً، ومن غير الممكن تقدير عقابيلها على نحوٍ شامل، فالفتى الذي فقد والده ووالدته وإخوته وأخواته وأعمامه وأخواله، كيف سيواجه مصيره لاحقاً؟ والمرأة التي مات زوجها وأولادُها بين يديها، وخسرت والدها ووالدتها وإخوتها ومنزلها وكل ما كان من الممكن أن تستند إليه، كيف ستعيش بقية حياتها؟ ستُجنّ ربما أو تنتحر. والفتاة التي دُمرت أحلامها في التحصيل العلمي أو الحب أو العيش في كنف عائلتها، كيف ستواجه أيامها المقبلة مجرّدة من أي سند؟ هنا، في هذا الميدان، ثمّة كلام رائج يحتقر الناس وإنسانيتهم وحيواتهم، مضمونه أن الجزائريين قدّموا مليون شهيد ثمناً لحرية بلدهم، ومثل هذا العدد دفعه الفيتناميون أيضاً. هذا كلام سائب، ومَن يردّده يبرهن أنه إنسان خائب باع أسوأ ما فيه (عقله). فالدم لا يُكال بالكيلة، والخمسون ألف شهيد في غزة يعادلون، في حساب النسبة والتناسب، ستة ملايين أميركي وثلاثين مليوناً في الهند ومثلهم في الصين. وهذه حساباتٌ غير لائقة.
كيف ستكون أحوال الناس في القطاع بعد الحرب؟
لا مندوحة من التفكير منذ اليوم بمصير الناس والمجتمع الذي تفكّك بعد أن تتوقف المدافع والصواريخ. مَن سيدفع رواتب فورية لأُسر الشهداء والجرحى؟ ومَن سيدفع المساعدات الجارية لتأمين حياة السكان ودعم بقائهم في أرضهم؟ تحتاج غزّة، بحسب التقديرات المقبولة، خمسين مليار دولار لإعادة إعمارها. لكنّ أي جهةٍ مانحةٍ لن تدفع قرشاً واحداً ما دامت الأطراف المعنيّة لم تتفق على إنشاء هيئة لإدارة شؤون قطاع غزّة والإشراف على إعادة الإعمار، ولن تكون لحركة حماس، كما هو ظاهر في السياسات العالمية، أي سلطة، ولو غير مباشرة، على أموال الإعمار. وبطبيعة الحال، ستبقى “حماس” جزءاً من الحياة السياسية الفلسطينية، أَكان ذلك في الحكومات المقبلة أم في المجالس التشريعية المنتخبة، أو في ثنايا المجتمع. إذن، ستكون جزءاً من السلطة الفلسطينية، ولا مهرب من ذلك. أما الكلام اليومي المسموم بأن السلطة الفلسطينية هي حارسة أمن لإسرائيل، فلا قيمة له ولمن يلوكه، فالسلطة كانت خيار الفلسطينيين بعد اتفاق أوسلو لإدارة شؤونهم. وحتى “حماس” قبلت النظام السياسي الفلسطيني، وخاضت الانتخابات التشريعية في 2006 بناء على ذلك، وألّف إسماعيل هنية الحكومة آنذاك، وتولّى الحمساوي عزيز الدويك رئاسة المجلس التشريعي، قبل أن تحلّه المحكمة الدستورية.
لا مخرج للجميع (حماس وفتح ومنظمّة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية) من المأزقين السياسي والعسكري إلا بالانخراط في مؤسّسات المنظمة المقبلة بعد تفعيلها وتدعيمها وتحفيزها وإعادة بنائها، وهذه مهمّة وطنية عاجلة. وفي ما عدا ذلك، وإذا لم يحدُث ذلك، سنردد مع عبد الكريم الكرمي (أبو سلمى):
(كلما قلتُ أطلَّ الفجرُ غابا أَترى تغدو فلسطينُ سرابا).
إسرائيل سادرة في غيّها، فما دامت الولايات المتحدة تسند قوائمها وتحمي ظهرها فهي لا تلتفت إلى أحد. وهي، فوق ذلك، مستعدّةٌ للاستمرار في هذه الحرب شهوراً إضافية، بذريعة أنها حرب وجود، وأن مصير إسرائيل ستقرّره خاتمة هذه الحرب.