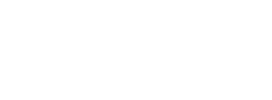لنبدأ من اجتياح المخيمات ومدن شمال الضفة الغربية، التي تعيد مشاهد غزة وتحقق نظرية الرّعب الإسرائيلي، أو لنبدأ من الطرقات التي تربط بين محافظات الضفة الغربية، والتي كانت آمنةً، نذرعها؛ نذهب ونعود، دون أن نخشى شيئاً! كان هذا خلال سنيّ الانتفاضة الأولى وحتى توقيع “أوسلو”، وكان المستوطنون المتطرّفون، الذين احتلوا ذُرى الجبال، وعبّروا، بدقّة وبراعة، عن أنهم يستخلصون العِبر، وأكّدوا أنّ “فوبيا مسّادا” ما زالت فيهم، هؤلاء المستوطنون كانوا لا يتجرؤون على المرور بمركباتهم وسياراتهم، من تلك الطرقات. أما اليوم، وخلال هذه الأحداث وما قبلها، فإن المعادلة انقلبت مئة وثمانين درجة، فأصبح المستوطنون في أمان واطمئنان، وأصبحنا نحن الذين نرهب المرور بها أو عبورها، حتى تكرّس السجن، وأصبح الفصل العنصري، أي إغلاق المدن والمخيمات والقرى، من قوات الاحتلال الإسرائيلي، فصلاً أكثر وحشيةً وعنصرية من “أبارتهايد” جنوب أفريقيا، وبذلك تفوّقت جنين أو طولكرم على “سويتو”، وأصبح مانديلا الإفريقي آلافاً مؤلفة في باستيلات الاحتلال، الذي استطاع، وبجدارة ساديّة عالية، أن يُعيد إنتاج أعتى أشكال القمع، على جلودنا وأرواحنا وبيوتنا وحقولنا.
وكردّ حاد وحاسم، جاءت بعض العمليات المسلحة الخاطفة، على كل أشكال الاحتلال الاسرائيلي في ظل ظروف مختلفة، الأمر الذي يجعل من هذه النتوءات الدامية، والارتجالية، حلقات لن تتوقّف، وستتواصل وتبقى، ما لم يحصل الفلسطينيون على أدنى حقوقهم الوطنية المتمثلة بالدولة والسيادة والقدس عاصمة لها، وعودة اللاجئين.
وبالرغم من أن الخطابات السياسية والإعلامية الصادرة عن الفلسطينيين، اتفقت، نسبياً، على مباركة أهداف هذه العمليات، إلى حدّ ما، فإن أحداً لم يعجم هذه الأهداف، ولم يفحص فيما إذا كانت “تحمل” جَنيناً لأحداث كبرى ممتدة وربما تكون انتفاضة جديدة! أم أنها ردّة فعل ميدانيّ، سيتواصل بشكل متباعد وفردي، تعبيراً عن حالة الإحباط العامة واليأس الآتي مما تقوم به دولة الاحتلال من محارق ومذابح وتدنيس للمقدسات، وبسبب عجز وغياب القوى والفصائل الوطنية الفلسطينية؟
وثمة اتفاق معلن، بين معظم أبناء الشعب، على مباركة هذه الوقائع، في ظل المذبحة المفتوحة المهولة والانغلاق السياسي وتعثّر المصالحة وتواصل الاستيطان والقمع الاحتلالي، ما يفسح المجال، عاطفياً، لهذا التجلّي الملموس للوحدة الوطنية.. لكننا لم نتأكد بعد من أن المصالحة ستتجلّى مساندة لهذه الروح الجامحة التي تعبّر عن نفسها بغير صورة وشكل، لأن شروط المصالحة مرتبطة بمفارق إقليمية وبالمصالح الحزبية والذاتية للأطراف الفلسطينية.
وإننا نلمس مسألتين: الأولى أن بعض الفصائل الفلسطينية لم تحسم أمرها كلياً للدخول أو لدفع عناصرها في أتون هذه التجلّيات المسلّحة، إلا بمقدار لفظيّ، لأسباب كثيرة، فيما تعلن الفصائل الأخرى دعمها، البعيد، وتهانيها للشهداء.
ولعل الأحداث تكشفت ضعف ثلاثة عناوين في الساحة الفلسطينية: أولها السلطة التي يستبيح الاحتلال الإسرائيلي “أراضيها”- ولن يتوقف، وسيعمل على قلب صورة الحياة بكيفية مهولة وشاملة-، وثانيها المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني، والثالث قوى المعارضة الفلسطينية، التي لم تثبت أن لديها أي تصوّر أو استراتيجية، موازية للردّ على استراتيجية الاحتلال التي تريد ابتلاع الضفة كلها، وعلى إجراءاته التي تندفع وتفرض واقعاً يؤسس لمعادلة جديدة للمستقبل، ولم تولّف هذه الفصائل، ولو نظرياً، لإجابات مطلوبة عن كل الأسئلة الحارقة والممضّة، عدا غياب جارح لمعظم النقابات والاتحادات والنّخب، التي لعبت في الانتفاضات السابقة دوراً مشرّفاً وعميقاً وواسعاً ومتقدماً.
أما غياب الإعلام أو مفرداته الخطيرة، فهذا ما يتحدّث عنه الكثيرون، ولن أخوض في مياهه الواسعة! بالرغم من أن هذا الغياب يؤدي إلى سيطرة موقف الآخر إقليمياً وعالمياً، ويشيع الشائعات السوداء في صفوفنا، ويشكّل خطورة بالغة كحرب نفسية مسلطة علينا، في ظل غياب المعلومة الصحيحة والمستندة إلى المعطيات والوقائع، وبلسان مبين. ولا أقصد هنا الإعلام المحلّي بل الإعلام الذي يجب أن يُخاطب العالَم بلغته وطرائقه الحداثية. بمعنى أن الاحتلال الذي يدّعي أن ثمة”كتائب فلسطينية مسلّحة في جنين أو طوباس أو مخيم طولكرم، فإنه يذرّ الرماد في العيون، ويعطي لنفسه مبرراً لهذا الاجتياح الدموي، وكأن ثمة جيشين يتصارعان على الأرض! وهذا غير صحيح.. فأرجو من بعض الفضائيات أن تتحرّى الدّقة، وأن لا تصبّ الزيت على النار، وتعطي الاحتلال ذريعة لفظاعاته.
ولعل الشباب والفتيان الجسورين، ودون مبالغة، هم القوة التي تقود ردّة الفعل، رغم أن الاحتلال الإسرائيلي حاول أن يستدرج ويضرب حركة الشباب، بغير أسلوب عنيف وغير مباشر. ولكن: هل هذه النتوءات والذئاب المنفردة، تمتلك القدرة على النفاذ والتصدّي؟
إن الانتماء الباسل، والاعتقاد الراسخ، والجسارة الفذّة، هي ما يدفع الشبان الفلسطينيين إلى توظيف أسلحتهم الأوتوماتيكية الخفيفة، لمناطحة جنود الاحتلال والمستوطنات المدجّجة بالسواتر الغليظة والمدافع المُهلكة، كردّ فعل طبيعي، على ما تقترفه دولة الاحتلال من قتل سافر، لم تصل مذبحة في التاريخ، ببشاعتها، إلى ما وصل إليه هذا الفتك الاحتلالي المتواصل، الأمر الذي يوقع هذا العدد الكبير والعزيز من الشهداء والجرحى، والذين تُبْرز جثامينُهم ما تفعله القنابل والصواريخ والمدافع، من تمثيل ممضّ ومرعب فيها، وصلت في أغلب الأحيان، إلى تقطيع الجسد إلى أشلاء، أو تهشيم الرأس، أو طحن الأطراف، أو تنخيل الصدر، أو تمزيق الجذع حتى الذوبان.
وهنا تبرز مسألة ينبغي التوقف أمامها مليّاً، وهي مدى إحاطة هؤلاء الشبان الأبطال بالمهنيّة، والتدريب الكافي، والتأهيل اللازم! بمعنى أنه ينبغي على كل مَن يْحمل السلاح ان يكون قادراً، تمام القدرة، ومؤهّلاً بما يكفي، وعالِماً بأحوال السلاح، وكيفية استخدامه، زمانياً ومكانياً، ومدركاً لما يتمتع به عدوّه من أسلحة، وماهية قدراتها وإمكاناتها، وأن يكون مُلمّاً بأشكال حرب العصابات وحرب الشوارع، وما إلى ذلك، حتى يكون سلاحه الرشيق مؤثراً وذا فائدة، وأن لا تكون كل رصاصة في المواقع الاحتلالية أشبه ما يكون بـ”الطخطخة العشائرية”، أو “الاستعراض”، أو “طخّ الأعراس”، وتصبح النتيجة وقوع عدد جديد غال من الجثث ومزق اللحم والأطراف المنخورة، ومن دون فائدة تذكَر!
وأعتقد أن ثمة مسؤولية كبيرة ومباشرة تتحمّلها الأجهزة المسؤولة التي تركت الحَبل على الغارب، وكذلك المؤسسات المعنيّة والتنظيمات والفصائل جميعها في هذا الشأن، بحيث ينبغي أن تضع، وبشكل ملزم، الضوابط المانعة أمام الحماسة والانفعال اللذين لا يكفيان في مثل هذه الحالات، على طريق وضع الأطر والخطط اللازمة، لتوظيف الأسلحة بعلمية ووعي ومسؤولية وإدراك، وأن لا يسمح، لأي كان، بالتمنطق بالسلاح، وإطلاق الرصاص على عواهنه، دون حساب دقيق، في المكان والزمان المناسبين.
إن رصاصة واحدة يقف خلفها فلسطيني ذو خبرة ودرْبة، يطلقها مستعيناً بتقنيات السلاح المعاصر والمتطور في الوقت المناسب ومن الزاوية المحددة ستكون، بالتأكيد، أفضل من إطلاق مليون رصاصة مجانية في الهواء!
وأعتقد أن لا خيار أمامنا، نحن الفلسطينيين، إلا الاستمرار في استحداث كافة أشكال المقاومة السلمية والممكنة حتى النهاة.
وعليه، ينبغي أن نحدد خطابنا ونعلنه واضحاً لا لبس فيه، وأن نعيد توظيف أوراقنا وإطلاق قدراتنا المعطلة واستنفارها، وأن نبحث عن آليات إضافية، ونطوّر الأساليب النافذة المؤثرة، في مواجهتنا للاحتلال وعدوانه الدموي، وأن ننتظم جميعنا في الناظم الوطني الذهبيّ، على قاعة أن الجميع في مواجهة الاحتلال، سلطةٌ وفصائل وجماهير، وأن نبتعد عن كل ما يثبّط عزائمنا واندفاعنا المقدس، لا لشيء، إلا لأن ألسنة مسؤولي الدولة الاحتلالية ما فتئت تؤكد أن هدفها تركيع فلسطين وأهلها وفصائلها، وفرض الرؤية الاسرائيلية، على الضفة والقطاع، فهل نضيّع المزيد من الوقت فيما هو غير مفيد، في حين تنتظرنا قضايا حيوية ومصيرية شديدة الخطورة والأهمية؟
………..
لعل الشباب والفتيان الجسورين، ودون مبالغة، هم القوة التي تقود ردّة الفعل، رغم أن الاحتلال الإسرائيلي حاول أن يستدرج ويضرب حركة الشباب، بغير أسلوب عنيف وغير مباشر.