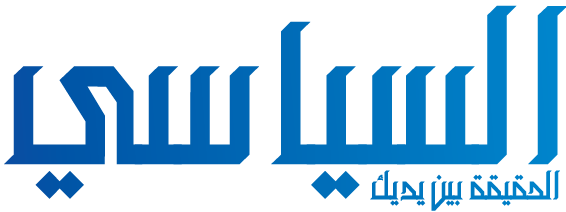على مدى عقود، كان العرب، وخاصة الفلسطينيين، وداعمو حقوق الفلسطينيين، الحلقة الأضعف في سلسلة الحريات المدنية بالولايات المتحدة الأميركية. وخلال هذه الفترة، عندما كان الرئيس الأميركي أو الكونجرس يسعيان لاتخاذ تدابير تقيد مجموعة من الحريات المدنية، كانا يستغلان الشعور بالخطر الذي يُشكّله العرب لتبرير هذه التدابير. وكانا يشعران بالراحة في القيام بذلك لأنهما يدركان أن الصور النمطية السلبية المرتبطة بالعرب تجعل هذه التدابير أكثر قبولاً وتقلل من احتمالية ظهور معارضة. والأمثلة على ذلك كثيرة:
في ثلاث مناسبات منفصلة في الثمانينيات، عندما سعت إدارة ريجان لتقليص الحريات المدنية، بدأت هجومها بهجوم على حقوق العرب. وبعد أن رسّخت هوية العربي/الفلسطيني باعتباره إرهابياً، افترضت أنه لن يكون هناك دعم شعبي للدفاع عن الحريات المدنية للعرب. وعلى الجانب الآخر، لو كانت أهدافهم تنتمي إلى عرق آخر، لكانت المعارضة أكثر احتمالاً.
في عام 1981، أصدرت إدارة ريجان أمراً تنفيذياً ألغى جميع الإصلاحات السابقة التي قامت بها إدارة كارتر لحظر التجسس المحلي من قبل وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، مستخدمةً العرب ككبش فداء لتبرير هذا الإجراء. ونتيجة لذلك، وعلى مدى خمس سنوات، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي باختراق وتعطيل مجموعات الطلبة الفلسطينيين في جميع أنحاء البلاد، لينتهي الأمر بإلغاء هذه الجهود دون تحقيق أي نتائج تُذكر، سوى إضاعة وقت العملاء وإنفاق ملايين الدولارات.
كما تمكنت وزارة العدل في عهد ريجان من إعادة صياغة قانون تسليم المجرمين الأميركي، مما سهّل تلبية طلبات الدول الأجنبية لتسليم الأفراد دون توفير ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة. وتم ذلك من خلال قضية حامل تأشيرة فلسطيني طلبت إسرائيل تسليمه. واستناداً إلى هذه القضية، أعاد الكونجرس صياغة القوانين التي تؤثر على جميع طلبات التسليم.
وفي عهد ريجان أيضاً، أصدرت دائرة الهجرة والتجنيس «خطتها الطارئة للتعامل مع الإرهابيين الأجانب وغير المرغوب فيهم»، والتي تُفصّل الخطوات المتخذة بموجب أحكام قانون «مكارين والتر» لسجن أعداد كبيرة من الأجانب ومحاكمتهم سراً وترحيلهم بناءً على عرقهم أو معتقداتهم السياسية أو ارتباطاتهم. وتماشياً مع النهج المُتبع، تُشير «الخطة» عدة مرات إلى المهاجرين العرب. وقد تم استخدام قضية اعتقال سبعة فلسطينيين وزوجة كينية لأحدهم – دون توجيه تهم سوى معتقداتهم السياسية وانتماءاتهم – كحالة اختبار لوضع أسس هذه الخطة»
وفي عام 1995، أصدر الرئيس كلينتون أمراً تنفيذياً «يحظر التعامل مع الإرهابيين الذين هددوا بتعطيل عملية السلام في الشرق الأوسط»، وأعقبه قانون مكافحة الإرهاب الشامل لعام 1995. وقد أدت هذه الإجراءات إلى إدخال تدابير صارمة تقوّض الحقوق المدنية والسياسية المكفولة للمواطنين والمقيمين في الولايات المتحدة بموجب الدستور والقانون الدولي. على سبيل الامثال، منح القانون سلطات واسعة لأجهزة إنفاذ القانون، وألغى افتراض البراءة لمن يخضعون للتحقيق، وسهّل على الحكومة مراقبة الأشخاص المشتبه في انتهاكهم قوانين التآمر، وسمح بحظر «الدعم المادي الذي يعتبره الرئيس مفيداً للمنظمات الإرهابية»، ووضع إجراءات تسمح للحكومة باحتجاز وترحيل الأفراد بناءً على أدلة سرية، دون إتاحة الفرصة لهم للدفاع عن أنفسهم، وسمح لوكالات إنفاذ القانون بمراقبة الأفراد أو الجماعات، بناءً على معتقداتهم وانتماءاتهم. وباستخدام هذا الأمر التنفيذي والتشريعات الجديدة، أطلقت إدارة كلينتون برنامجاً قومياً للتمييز في المطارات، استهدف المئات من الركاب العرب والعرب الأميركيين بالمضايقة والتحقيق حتى قبل وصولهم إلى مكاتب تسجيل الرحلات، فقط بسبب ملابسهم أو مظهرهم أو أسمائهم العربية.
وبعد أحداث 11 سبتمبر2001، صعدت إدارة بوش والكونجرس من الإجراءات. وعلى الرغم من أن الإخفاقات الاستخباراتية ومتطلبات السلامة الجوية المتساهلة كانت السبب الحقيقي في تمكين الإرهابيين من التدريب في الولايات المتحدة وتنفيذ هجماتهم المروعة، فقد أصدر بوش سلسلة من الأوامر التي أدت إلى اعتقال وترحيل آلاف الطلاب والعمال والزوار العرب الأبرياء. كما أمروا عشرات الآلاف من حاملي التأشيرات العربية والإسلامية بالتوجه إلى مكاتب الهجرة حيث احتُجز عدد أكبر منهم للترحيل. وسمح تشريع مكافحة الإرهاب الذي أقره الكونجرس بتوسيع نطاق المراقبة من قبل جهات إنفاذ القانون، بما في ذلك التنصت على المكالمات الهاتفية دون إذن قضائي، والتوسع في استخدام التنميط. وباستخدام الصلاحيات الموسعة الممنوحة لهم من قبل الإدارة، تسلل عملاء إنفاذ القانون إلى المساجد والنوادي الاجتماعية العربية، ووقعوا في فخ بعض الأفراد السذج في مؤامرات غالباً ما كانت تُدبّرها جهات إنفاذ القانون نفسها.
وهذا مجرد جزء من التاريخ، لكنه يضع الأساس للإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب: التهديدات للحريات المدنية مثل حرية التعبير، وحرية التجمع، والحرية الأكاديمية، وتوسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية لاستخدام تدابير غير دستورية لاحتجاز وترحيل الأفراد بناءً على عرقيتهم أو معتقداتهم السياسية، وتوسيع تفسير حجة «الدعم المادي»، التي استخدمتها إدارتا ريجان وكلينتون لانتهاك الحقوق المحمية للمواطنين والمقيمين.
لا شك أن هناك اختلافات. فبينما كانت الإجراءات التي اتُخذت في عهد ريجان وكلينتون وبوش تستند إلى مخاوف مبالغ فيها من الإرهاب في الولايات المتحدة، فمن المهم الإشارة إلى أن مراجعة برامج التمييز والمراقبة والهجرة التي أُسست خلال تلك الإدارات لم تُسفر عن كشف أو محاكمة حالات فعلية للإرهاب. وفي نهاية المطاف، وعلى الرغم من إنفاق مليارات الدولارات وإهدار موارد أمنية ثمينة، لم تسفر هذه البرامج عن شيء سوى توسيع سلطات إنفاذ القانون وتقويض الحقوق. أما في حالة أوامر ترامب، فلا يوجد حتى ذريعة لمكافحة الإرهاب – بل مجرد زرع الخوف وإجبار المؤسسات والأفراد على الخضوع.
وما تشترك فيه سياسات إدارة ترامب مع سابقاتها هو استخدام العرب، وخاصة الفلسطينيين، وداعميهم، ككبش فداء لتبرير تقويض الحقوق والحريات. يدرك ترامب أنه في خضم الحرب الإسرائيلية على غزة، فإن قاعدته المؤيدة له ستدعم جهوده بحماسة. كما يعلم أن الليبراليين في الكونجرس، الذين قد يعارضون سياساته في ظروف أخرى، سيترددون في الدفاع العلني عن العرب ضحايا هذه السياسات إذا بدا أنهم يدافعون عن الفلسطينيين أو المنتقدين لإسرائيل. بالنسبة لترامب، إنها العاصفة المثالية. أما بالنسبة لأولئك الذين يهتمون بالدفاع عن الحقوق والحريات، فهي مجرد مثال آخر على كون العرب، والفلسطينيين، ومن يدافع عنهم، هم الحلقة الأضعف في سلسلة الحريات المدنية.
نقلا عن “الاتحاد”