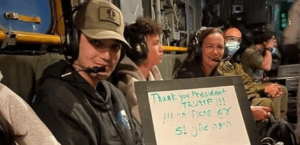إن حرب المساندة، التي تورط فيها حزب الله، تسببت بالكثير من الضرر للبنان عموماً، وللبيئة الشيعية خصوصاً. لكن حرب الستة وستين يوماً التي ردت بها إسرائيل بهمجية مطلقة، والتي لا تزال مستمرة حتى اليوم ولو بشكل أقل حدة، قد تسببت بدمار غير مسبوق، طال المناطق الشيعية بشكل خاص، ونتج عنها ردود فعل مختلفة. غالبية اللبنانيين انتقدوا الحزب وحمّلوه مسؤولية الضرر المستمر اللاحق بلبنان واللبنانيين. لكن الملفت ان البيئة الشيعية عموماً ظلت مراعية للحزب ولم تعلن الانفكاك عنه، ولا أدانته فعلياً.
فما الذي يفسر هذه الظاهرة؟
ان التعرض لتروما او “صدمة نفسية” شديدة على الصعيد الفردي، تجعل الشخص يمر عادة بعدد من الاضطرابات النفسية والسلوكية والعاطفية.
بالنسبة للعاطفية، لدينا ظاهرة القلق الشديد أو التعرض لنوبات هلعية. كما المعاناة من الاكتئاب أو الإحساس بالذنب.
وهذه علامات تظهرخصوصاً في حالات “الناجي من كارثة” (survivor).
ثم هناك الفراغ أو الخدر العاطفي، حيث يفقد الشخص القدرة على الشعور.
بالاضافة الى اضطرابات النوم: أرق، كوابيس، أو نوم متقطع. وأحياناً يخاف المصدوم من النوم، لأن الذكريات تعود اليه أثناءه.
ثم ان اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، يجعل المصدوم يسترجع الحدث باستمرار(flashbacks)، ويعاني من فرط في اليقظة ، ويتجنب أماكن أو أناس أو مواقف تذكّر بالحدث.
بالإضافة الى حدوث خلل في العلاقات الاجتماعية: من الانعزال وعدم الثقة بالآخرين، الى الغضب أو التهيج الزائد تجاه الأقرباء.
بالاضافة الى الصعوبة في إنشاء روابط جديدة.
ثم هناك العوارض النفس – جسدية
أوجاع غير مفسّرة طبياً (صداع، وجع معدة، تعب مزمن).
تكرار زيارة الأطباء دون سبب عضوي واضح.
تتغير عموماً نظرة الشخص للعالم، فيشعر أن العالم لم يعد آمناً.
فقدان الإيمان أو المعنى (existential crisis)، أحياناً العكس: يقظة روحية أو إعادة تعريف الذات.
أخيراً هناك آليات التكيف الضارة:
الإدمان (كحول، مخدرات، أكل مفرط).
إيذاء النفس أو السلوك التدميري.
الإنكار والتشتت الزائد (مواقع تواصل، عمل مفرط).
في حالة الشيعة من مناصري حزب الله، فهم يعانون من مزيج من آثار الصدمة الجماعية مضافاً اليها أزمة الهوية والانتماء؟
الصدمة الجماعية (Collective Trauma)
الحرب المتكررة تركت أثرًا نفسيًا جماعيًا:
الإحساس بالخطر الدائم وغياب الحماية من الدولة.
الاعتماد النفسي على الحزب كمصدر “أمان” أو “ردع”.
الشعور أن التخلي عنه يوازي التخلي عن أدوات البقاء.
آلية “التمسك بالهوية” كرد فعل نفسي
في حالات الصدمة، يتشبث الأفراد غالباً بهويتهم الجماعية أكثر من ذي قبل، كآلية دفاع ضد التهديد الخارجي.
الحزب لا يُقدَّم فقط كمقاومة، بل كهوية دينية وثقافية واجتماعية، وحتى طبقية أحيانًا.
النقد العلني للحزب يُشبه – في المخيال الجمعي – خيانة “العائلة” في لحظة خطر.
آثار الصدمة غير المعالجة
كثيرون قد يكونون في حالة “إنكار وظيفي”، أي يتجاهلون التناقضات لأن المواجهة تتطلب تفكيك منظومة الأمان النفسي.
كذلك، هناك ما يُعرف بالتماهي بالمعتدي، حيث يتماهى الفرد مع مصدر الأذى إذا اعتقد أنه يحميه من أذى أكبر (كما في متلازمة ستوكهولم).
الخوف من الفراغ أي بديل متوفر؟
الصدمة تجعل الناس يخافون الفراغ السياسي والأمني، لا سيما مع ضعف الدولة وانعدام ثقة تاريخي بها.
الحزب يَظهر لهم – نفسيًا – كـ”سقف متماسك”، حتى لو كان مسببًا للألم.
الإرهاق النفسي الجمعي
الناس مرهقون لدرجة تجعلهم غير قادرين على التخيل أو التخطيط لتغيير جذري. وهذا يشلّ التفكير النقدي الجماعي.
إلى متى سيستمر هذا التمسك بالحزب؟
إلى أن يحدث واحد أو أكثر مما يلي:انكشاف داخلي (من داخل جمهور الحزب نفسه) يعيد تعريف “الولاء” ويفكك الرابط بين الحزب والهوية، او بين الهوية والانتماء الديني – الطائفي. ويستحيل فك هذا الارتباط طالما ظل عاملاً مشتركاً عند جميع الطوائف والاديان.
بروز قيادة بديلة تحترم كرامتهم وتمنحهم أمانًا نفسيًا واجتماعيًا دون شعارات فارغة.
معالجة الصدمة جماعيًا، أو على الأقل فتح المساحات للتعبير عنها بحرية دون خوف من الوصم.
فعل رمزي كبير (مثل مبادرة إنقاذية أو موقف أخلاقي من شخصية ذات ثقل)، يوقظ الوعي ويكسر الانفصام بين المعاناة والواقع السياسي.
وهذا منوط بممارسات الدولة وقدرتها على ارساء قواعد عدالة انتقالية.
عن جنوبية