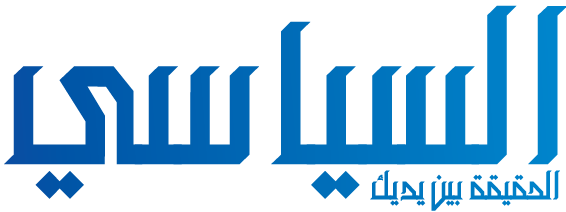تجار الحروب نوعان: الأول مادته ورأسماله السلاح وتوابعه لقتل الإنسان وتدمير بيئته الطبيعية اللازمة أساسا لحياته وديمومته على أرضه، أما الآخر فمادته الإنسان لقتل روح الإنسانية، ودفعه للسقوط في مصنف أدنى من طبيعة الكائنات الوحشية.
الأول يعتبر في القوانين والشرائع الإنسانية شريكا في الجرائم ضد الإنسانية، لأنه يبيع السلاح لطغاة، ظالمين، عدوانيين، مجرمين، ومطلوبين للعدالة والقانون وهو يعلم أنهم كذلك!
والآخر شريك أيضا، لأنه يقتل الإنسانية بسلاح استغلال المعاناة والمآسي والكوارث والنكبات التي يتسبب بها زبائن تاجر السلاح، المعني بمضاعفة أرباحه، حتى لو استخدم إنتاجه في حملات ومجازر إبادة دموية جماعية، فيما الشريك الآخر، فمعني بمضاعفة أرصدته الشعبوية والبنكية معا، حتى لو دمرت أعماله المقنعة بمصطلحات دينية وخيرية وإنسانية، نظام القيم الأخلاقية الإنسانية، حتى الوطنية لا يوفرون فرصة دعسها وهرسها بماكينة وآلات (الاستغلال) الحادة للحروب، والواقع والقضايا والأزمات.
تنظم شبكة مصالح خفية، العلاقة المباشرة، أو غير المباشرة بين النوعين، فالأول يتكسب من الصراعات الداخلية، كلما زاد الانهيار الأخلاقي، والآخر يتكسب كلما زادت الحرب مساحة المآسي والمعاناة شكلا ومضمونا، ذلك أن تجارته تعتمد على تكثيف عمليات تفعيل انفعالات الناس العاطفية بعد استدرارها بمشاهد تحض أصحاب الأيادي البيضاء –بدون تردد- على عمل الخير، فيما هذا (المستغل) الشريك بالجريمة وكل صنوف أعمال الشر، يعمل لاشتقاق الدولار الحرام، من حليب الأطفال، ومن المغذيات الخاصة بالوالدات المرضعات، ومن (جالون الماء) ووجبة غذاء، لا ينوب الطفل المستغل في هذه الجريمة أكثر من لمسها مغلفة لمدة ثوان فقط، ثم يسحبها من يده، بعد فراغ (المجرم) من استكمال مشهد الخداع المزدوج، للضحية (الطفل المسكين)، ولفاعل الخير أيضا (المتبرع) القائم في قلب الوطن، رغم وجوده على بعد آلاف الأميال منه! وأعمى بصيرة، وثقافة إنسانية ووطنية، من لا يرى ولا يسمع الطفل المسكين اليتيم، الذي قتل الغزاة والديه بسلاح الإبادة، يحدث نفسه بمرارة، لماذا يحاصرني هؤلاء أيضا؟! فقد سلبوني لقمة عيش وقطرات ماء نقية، دفع ثمنها أهل الخير المشبعون بالإنسانية، فكيف لي أن أشد خيمة نزوحي وأصمد، فوق ركام منزل عائلتي في غزة، كما يطلبون مني دائما! ثم يفجر السؤال الأصعب، هل هؤلاء منا؟!
ما زال المشهد مستمرا في جانب آخر لصيق، فالذين استغلوا شعار المقاومة، وأشهروا السلاح للاستعراض والتباهي الشخصي، وإعلان الولاء، والاستعداد للعمل كوكيل تنفيذي لأجندات خارجية، فئوية، عصبوية، لا وطنية، وبعد أن وجدوا ضالتهم لدى محترفي (استغلال سياسي) مقيت، أظهروا مخزونهم من الثرثرة المخصبة، وقدرة عالية على صف الكلام المشحون بالشعارات، وبثه مجردا من المنطق والحكمة والواقعية والعقلانية، عبر المرئيات، وبعد أن أفرغ الجميع الاستعراضيون مخازن اسلحتهم النارية والكلامية، على أجهزة إنفاذ القانون والعدالة، تواروا، اختفوا، كأن الأرض انشقت وابتلعتهم، عندما دخل جنود الغزاة مخيمات في الضفة الفلسطينية، وعملوا فيها تدميرا وإحراقا وتهجيراً، فهل كان هؤلاء منا؟!
يتكاثر تجار هذا النوع من الحروب “الاستغلال” كالبكتيريا السامة، ويجدون في بيئة المناكفة والخصومة، والتحول المتسارع من الاختلاف إلى الخلاف أرضية خصبة لتنمية مشاريعهم ورفع وتيرة (جرائمهم)، فيتخذون مبدأ الحرص على حقوق ومصالح شريحة من الشعب سلاحا، ثم يرمون به الشرعية التي تمثل الشعب، ولسان حالهم يقر ناطقا بالحقيقة: “أن دماغ وفعل الاحتلال، السبب والمتسبب بالأزمات والمشاكل والقضايا الأساسية والفرعية والأمنية والاقتصادية، ورغم ذلك يستسهلون استخدام سلاح الاستغلال الفتاك، بإطلاق (مسيرات) ألسنتهم الانقضاضية على الشرعية! ولا يهمهم إن كان الهدف في موقع رأس الهرم، أو في قاعدته الشعبية، فالأهم عندهم الشماتة بسقوطها! فهل هؤلاء منا؟!