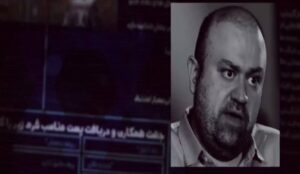— “خاطِبوا الناسَ على قدرِ عُقولِهم”… هكذا شاعت الحكمة، حتى أصبحت قاعدة يُستند إليها في التعليم والدعوة والإرشاد والفكر. لكنها ـ على وجاهتها الظاهرية ـ قد تنطوي على اختزالٍ للآخر، واختناقٍ للحقيقة، ومراوغةٍ تُسقِط الخطاب في التسطيح أو النفاق. من هنا تنشأ الدعوة المعاكسة:
“لا تُخاطبوا الناس على قدرِ عقولهم، بل على قدر ما يجب أن تكون عليه عقولهم.”
إن الخطاب الذي ينزل إلى مستوى وعي الناس دون أن يحاول رفعه، يقتل الفكر، ويصادر المستقبل، ويعيد إنتاج الجهل في ثوب الواقعية. فما القيمة إذن من أن تخاطب العقول بما ترضى، لا بما ترتقي؟ وهل مهمّة الفكر أن يهادن، أم أن يوقظ، ويصدم، ويزعزع ما استقرّ؟ وهل وظيفتنا أن نُبقي العقل الجمعي نائمًا، أم أن نحفر له طريق اليقظة، حتى لو بالمطرقة لا باللّحن؟
— بين البلاغة والتبليغ: هل نسكت مراعاةً للوعي العام؟
إنّ الانحياز إلى “تبسيط الخطاب” تبريرًا لضعف الوعي، قد يتحوّل إلى استهزاء ضمنيّ بالناس لا احترام لهم. فكما يقول فريدريك نيتشه:
“إن من يحتقر الإنسان، يخاطبه كما لو كان طفلاً لا يَفهم.”
ومع أن المقولة المنسوبة للإمام علي بن أبي طالب:
“خاطبوا الناس على قدر عقولهم، أتحبون أن يُكذّب الله ورسوله؟”
تحثّ على الحكمة والحنكة في تبليغ الحقائق،
فإنها لا تُفهم على أنها دعوة للتنازل عن المعاني العميقة، بل لضبط الأسلوب دون المساس بجوهر الفكرة.
فالفرق كبير بين التبليغ المتدرج، والتضليل المباشر، بين الشفقة على العقول، والاستخفاف بها.
— حين يصبح الخطاب مرآة للقطيع
في كتابه الشهير “الإنسان المتمرّد”, ينتقد ألبير كامو بشدّة المجتمعات التي تُخاطَب دائمًا بما تحبّ أن تسمع، لا بما يجب أن تفهم.
“من يُسلّي الشعب ليبقى نائمًا، ليس أقلّ استبدادًا ممن يُرغمه على الصمت.”
وحين ينزل الخطاب الثقافي إلى أدنى درجات الذوق العام، تحت ذريعة “مراعاة الناس”، فإنّه لا يُراعيهم، بل يُدجّنهم. وحين يتجنّب المفكّر الصدق مع الناس، لأنه يخاف من “صدمة وعيهم”، فإنه في الحقيقة يخاف من مسؤوليته الأخلاقية.
لقد عبّر ميشال فوكو عن ذلك حين قال:
“كل سلطة تبدأ من اللغة، وكل مقاومة تبدأ من خطابٍ مختلف.”
فإذا كان الخطاب أسيرًا للعقل الكسول، فلن يولد فيه وعيٌ جديد.
— لا تَخفضْ الصوت… فارفع المعنى
منذ زمن سقراط، كانت وظيفة الفيلسوف أن يُزعج المدينة بأسئلته، لا أن يُغنّي لها على مقاس رغبتها.
سقراط لم يُخاطب أهل أثينا على قدر عقولهم، بل على قدر ما أراد أن يُشعل فيهم من نار الفكر والشك والتمحيص. ولذلك سقوه السمّ.
بينما اختار أفلاطون في محاوراته أن يُقدّم المعرفة على مراحل، لكنه لم يتنازل عن عمقها. فالعقل ليس قالبًا جامدًا نُسايره، بل عضلة قابلة للشدّ إن نحن درّبناها على الفهم.
ويقول جورج أورويل في هذا السياق:
“الحقائق تصبح ثورية، حين تكون الأكاذيب هي العرف.”
فأن تقول الحقيقة الكاملة، حتى إن لم تُفهَم في حينها، هو موقف فكري نبيل، لا تهوّر.
— الفكر لا يُقاس بالاستيعاب اللحظي
مالك بن نبي، المفكر الجزائري الكبير، دعا إلى خطابٍ نهضويّ لا يركن إلى تخلّف الجماهير، بل يُؤسِّس لتجاوز تخلفها.
فقال: “إن مسؤولية المفكر ليست أن يُجاري، بل أن يُغيّر، لا أن يُرضي، بل أن يُوجّه.”
وقد دعا عبد الوهاب المسيري أيضًا إلى ضرورة “تأديب الذوق العام” من خلال خطابٍ معرفي لا يُجامل.
فليس المطلوب من الكاتب أن “يبسّط” الحقائق حتى تفقد معناها، بل أن يُبقي على عمقها، ويجد الطريقة المناسبة لجعلها ممكنة الفهم.
— بين عقل الفقير ووعي المفكّر
حتى الفقراء — أولئك الذين يُتخذون ذريعةً لمجاراة الجهل — ليسوا عاجزين عن الفهم، بل عن الوصول إلى الأدوات.
وقد كتب دوستويفسكي عن بساطة الوعي الشعبي في روسيا، وأظهر أن الفلاح البسيط يمكنه أن يُدرك ببصيرته ما لا يدركه المثقف بتعقيده.
ليس من العدل أن نقول: “هؤلاء لا يفهمون، فلنُخاطبهم بما يفهمون”، بل الأجدر أن نمنحهم خطابًا يحفز الفهم، لا يهرب منه.
— خاتمة: مسؤولية الخطاب لا تقع على العقل وحده:
أن تُخاطب الناسَ بما يفهمونه فقط، قد يكون أريح لك، لكنه خيانة للفكر.
وأن تُخاطبهم بما يجب أن يكونوا عليه، فهذه مغامرة، لكنها الوحيدة التي تُنتج التغيير.
فالفكر إن لم يُربك، لن يُحرّك.
والخطاب إن لم يُزعج، لن يُوقظ.
ولعلّ أعظم ما يُمكن أن يقال هنا هو ما عبّر عنه جبران خليل جبران:
“ويلٌ لأمةٍ تلبسُ مما لا تنسج، وتأكلُ مما لا تزرع، وتؤمنُ بما لا تفهم.”
فلتكن دعوتنا إذن:
لا تُخاطِبوا الناسَ على قدرِ عقولهم… بل على قدر ما يجب أن تصيرَ إليه تلك العقول