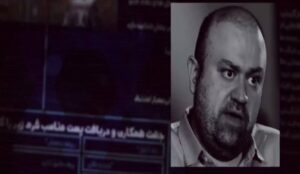لم يعد سؤال “من نحن؟” يُطرح بوصفه استجلاءً للهوية، بل صار انعكاسًا لفراغها. ليس لأنّ الإنسان فقد ذاته فحسب، بل لأنّ البنية التي كانت تزوّده بهذه الذات – الدولة، الأمة، الدين، السرد – قد تهاوت أو انكشفت كإنشاءات هشّة، زمنية، بل وربما خادعة. أصبح سؤال الهوية مرآة تتكسر كلما حدّقنا فيها، وتتحوّل إلى سؤال أكثر جذرية: “ما نحن؟” – لا بوصفنا كيانات ثابتة، بل كذوات سائبة في محيط مائع، تبحث عن شكلٍ دون أن تُمسك بجوهر.
1. الدولة – الأمة: انفجار المركز وبداية الشك
كانت الدولة – الأمة لحظة تأسيس كبرى في تاريخ الإنسان الحديث. وعدت بالتكامل بين السياسي والثقافي، بين الأرض واللغة، بين السيادة والانتماء. لكنها، كما يشير بنديكت أندرسون في الجماعات المتخيلة، لم تكن سوى بناء تخييلي، يعمل السرد والتاريخ والتعليم على تثبيته، أكثر مما يعكس “حقيقة جوهرية” في الإنسان.
ومع العولمة، تصدّعت هذه البنية؛ لم تعد الدولة قادرة على احتواء انتماءات مواطنيها، ولم تعد الأمة تحمل مشروعًا كونيًا، بل تحوّلت إلى جهاز إداري هش، يشتغل تحت وطأة السوق والهوية والآلة الإعلامية.
يقول زيغمونت باومان: “المجتمعات الحديثة أصبحت سائبة مثل السوائل، لا تحتفظ بشكلها طويلًا”. ونحن نرى اليوم دولة بلا سرد، وأمة بلا طموح، وهويات تبحث عن قوالب تعيد إنتاجها لكنها لا تجد إلا رماد الأساطير القديمة.
2. الهويات: من الانتماء إلى المغامرة
إذا كانت الهوية في السابق تُمنح، أو تُورَّث، فإنها اليوم تُغامَر بها. لم يعد الانتماء مستقرًا، بل صار اختيارًا معلّقًا، أو رد فعل على الخوف. “الهويّات الرئيسية والفرعية” – كما في نصك – تحوّلت إلى مشاريع ذات طابع روائي، تُكتب وتُعاد كتابتها، دون مؤلف واحد، في زمن لا توقيع فيه ولا قراءة متأنية.
في هذا السياق، يمكن فهم نكوص الأديان – لا كأفول للإيمان – بل كأزمة في طريقة تمثيل المقدّس داخل جهاز الدولة والهوية. لقد أُعيد تسييس الدين، كما أُعيد تدنيس السياسة، ليصبحا مجرد أدوات صراع في سوق المصالح، لا روافع للمعنى.
لقد أصبحنا قراءً لنص لم يكتبه أحد، كما كتب بلانشو ذات مرة، وأيّ إنسان قد يكون كاتبه، لكن ليس بصفته كاتبًا بل ككائن غارق في التجربة والهاوية معًا.
3. الإنسان الأخير: من نيتشه إلى الإنسان العاري
في هذا الزمن المقلوب، يتقدم سؤال الإنسان نفسه بوصفه كائنًا منزوع الهوية والغطاء. يطلّ علينا “الإنسان الأخير” الذي تحدّث عنه نيتشه في هكذا تكلّم زرادشت: كائنٌ بلا تطلّع، بلا جراح، بلا خطر، يطلب الرفاه لا المعنى، ويعيش الاستهلاك بوصفه خلاصًا وهميًا. هو نقيض الإنسان التراجيدي، لأنّه تخلى عن قدرته على السؤال والمقاومة.
وإن كان نيتشه قد كشف نهاية الإنسان الفلسفي، فإن جيل دولوز دعا إلى “تفكيك الذات” لا من أجل ضياعها، بل من أجل تحريرها من أوهام الانغلاق والهوية الجامدة. أما هيدغر، فكان يربط الكينونة بالانفتاح على “العدم” بوصفه مساحة للانكشاف، حيث لا كينونة بدون قلق، ولا إنسانية بدون طرح السؤال: “لماذا هناك شيء بدلًا من لا شيء؟”.
4. إلى أين؟: تفكير الذات في عصر ما بعد الإمبراطوريات
إذا كان هذا هو مشهدنا – انهيار للسرد، تيه في الهوية، تفكك في الدولة – فهل ثمة إمكانٌ للفكر؟ هل لا يزال الإنسان قادرًا على التأمل في مصيره؟
نعم، لكن بشرط. كما في نصّك، علينا ألّا نفكر بأنفسنا بمعزل عن العالم، ولا أن نحمل مشكلاتنا بوصفها أعباء محلية، بل باعتبارها كثافات وجودية ترتبط بتجربة الكائن المعاصر في كل مكان: في آسيا، وأوروبا، وفي الذات.
من هنا، فإن استعادة الفلسفة، ليست ترفًا، بل ضرورة. علينا أن نفكر لا فقط في ما نفقده، بل فيما يمكننا أن نكونه. أن نعيد تشكيل المعنى في ضوء هشاشتنا، لا رغماً عنها. أن نجعل من شظايا الدولة والهوية مادة بناء جديدة، لا أطلالًا نرثيها.
خاتمة: جمهور بلا توقيع… ولكن؟
نعم، نحن “جمهور بلا توقيع”، لكن هذا لا يعني الفناء. بل ربما هي دعوة لولادة معنى جديد، غير مؤطَّر، غير موروث، غير موقّع.
قد يكون كاتب هذا المعنى أي إنسان… أو كل إنسان.
إنها مهمة العقول التي أخذت عصرنا بقوة، كما قلت: من كانط الذي حرّر العقل، إلى نيتشه الذي عراه، ومن هيدغر الذي أنذر، إلى المسلم الأخير الذي يحمل عبء العبور.
—
مراجع وإحالات:
1. بنديكت أندرسون، الجماعات المتخيلة، ترجمة ثائر ديب.
2. زيغمونت باومان، الحداثة السائلة، ترجمة فواز طرابلسي.
3. فريدريك نيتشه، هكذا تكلّم زرادشت، ترجمة فليكس فارس.
4. جيل دولوز، الفرق والتكرار.
5. مارتن هيدغر، الكينونة والزمان.
6. موريس بلانشو، الكتابة والكائن.
7. ميشيل فوكو، نظام الخطاب.
8. طه عبد الرحمن، روح الحداثة.