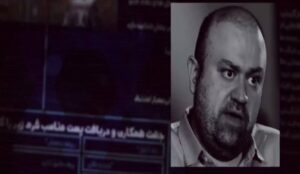في الزمن الذي تتسارع فيه التحولات وتتراكم فيه الأسئلة أكثر مما تتضح فيه الإجابات، تبدو دعوة “عقلنة الواقع” لا ترفاً فلسفياً ولا تمريناً ذهنيًا على الورق، بل ضرورة وجودية ومنهجية، لئلا يظل الفكر العربي – في غالبه – حبيس دوائر الانفعال، وردود الأفعال، والهروب إلى استيهامات ماضوية تواسيه أكثر مما تهديه.
فالعقل، بما هو ملكة إدراكية وفضاء معرفي إبستمولوجي، لا يعد مجرد أداة لتفسير ما هو كائن، بل هو طاقة كامنة على الإبداع وإعادة بناء الفهم، وخلق ما ينبغي أن يكون. وقد بيّنت التجربة الإنسانية – منذ بزوغ فجر الحداثة – أن لا تحديث بلا معقولية، ولا معقولية بلا ثقة بالعقل، ولا عقل بلا حرية تفكير، ومسؤولية نقد، وجرأة على الانفكاك من أسر المرجعيات الجامدة.
_ العقلُ كشرط أوليّ للحداثة:
في السياق الغربي، مثلاً، لم تنطلق الحداثة إلا بعد أن أُعيد تعريف العقل بوصفه الحكم الأعلى، وليس مجرد تابع لما تمليه السلطات الدينية أو الإرث الفقهي أو الكهنوت السياسي. كان “ديكارت” إذ يعلن “أنا أفكر إذن أنا موجود” لا يمارس تمريناً رياضياً في الاستنباط، بل كان يضع أسساً لتحرير الذات من التبعية للعقائد الجامدة، وليؤسس لأرضية إبستمولوجية جديدة قوامها الشك المنهجي والعقل الواضح المتميز.
أما في العالم العربي، فإن غياب مشروع عقلاني راسخ لا يُعزى فقط إلى نقص المعرفة أو أدوات التفكير، بل إلى تردد بنيوي في خوض مغامرة العقل، وإلى بقاء الفكر – في أغلب الأحيان – أسير “مرجعيات مرتهنة”، تأبى أن تُستبدل، وتُخضع الواقع لمنطقها، لا أن تُخضع ذاتها لمنطق الواقع.
_ أزمة غياب العقلانية:
إن أخطر ما يواجه الفكر العربي الحديث هو أنه لا يزال يتعامل مع الواقع بوصفه كتلة صلبة من المسلّمات، لا بوصفه مجالاً متحولًا، يمكن إخضاعه للدرس، والتحليل، والتفكيك، والتركيب، عبر أدوات العقل الناقد.
فالخطاب السائد – سواء على المستويين السياسي أو الديني أو الثقافي – ما يزال في كثير من الأحيان يُحيل إلى تصوّرات ميثولوجية عن “الماضي المجيد”، دون أن يُقدّم آليات عقلية لتحليل الحاضر أو بناء المستقبل.
إننا أمام خطاب يعاني من “الصدمة المعرفية”، لأنه لم يستوعب بعد حجم التحوّلات التي تعصف بالعالم، ويقف مرتبكاً أمام “الصدمة الحضارية” الناتجة عن تصدّع أنساق القيم التقليدية، في ظل عالم يتحوّل بوتيرة جنونية.
_ وهم المركزية وغياب الصيرورة:
لا يمكن لعقلنة الواقع أن تتم إلا عبر تبنّي صيرورة واضحة، منفتحة، لا تدّعي امتلاك مركزية مطلقة، بل تقبل بالتعدد، والتجريب، والجدل الخلاق.
لكن المعضلة تكمن في غياب هذه الصيرورة، أو في تحوّلها إلى شعارات سطحية، أو مشاريع مؤقتة لم يكتب لها أن تتجذر، لأنها غالباً ما تصطدم بجدار صلب من “المقدس الثقافي”، أو من النزعات الشعبوية التي تهوى الحنين إلى الماضي، وتخشى من “اللايقين” الذي يفرضه التفكير العقلاني الحر.
_ في نقد الميثولوجيا الثقافية:
العقلُ لا يعمل في الفراغ، بل في وسط تحكمه بنى معرفية، وأساطير جمعية، ومفاهيم موروثة. ومن هنا، فإن التحديث لا يبدأ فقط بترسيخ قيم العلم والتجريب، بل بإجراء قطيعة نقدية مع “ثقافة الوهم” التي جعلت من العقل تابعًا للرغبة، ومن الدين أداة لتسكين الأسئلة، لا لتفجيرها.
وهذه القطيعة لا تعني القطيعة مع التراث، بل مع أنماط قراءته القديمة، التي ترسّخ الإخضاع لا الحرية، وتحتمي بسلطة السلف لا بنور الفهم. وما لم يُتح للعقل أن يشتبك مع هذا التراث اشتباكًا نقديًا منتجًا، فستظل كل محاولة لـ”عقلنة الواقع” مجرد مراوحة في المكان.
_ الخاتمة: العقل طريق لا بديل عنه.
لقد صار من اللازم اليوم – أكثر من أي وقت مضى – أن نستردّ ثقتنا بالعقل، لا بوصفه خصمًا للإيمان، بل شريكًا فيه، ولا بوصفه خطرًا على الهوية، بل ضامنًا لتجدّدها. فالتفكير العقلاني ليس ترفًا، بل ضرورة لإنقاذنا من السقوط في هاوية الشعبوية واللايقين.
فما بين العقل والحداثة علاقة جوهرية، قوامها التحرر من الأوهام، والانفتاح على النقد، واستبدال السكون بالحركة، واليقين الموروث بالتجريب المستنير. وما لم نؤمن بذلك، ونبدأ فعلاً لا قولًا بتفكيك مرجعياتنا اللاعقلانية، فستظل “محاولة عقلنة الواقع” مجرّد حُلم مؤجّل، وسيرورة متدحرجة نحو القاع، لا النهوض.