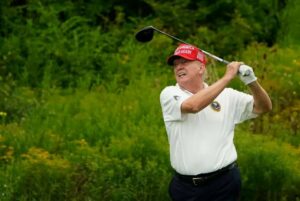من أكثر التجارب قسوة في حياة الإنسان أن يشعر بالغربة والاغتراب معًا؛ فذلك يشكّل عبئًا نفسيًا قاسيًا على الفرد والذات الإنسانية. وعند التأمل في مفهوم الاغتراب، نجد أن الإنسان قد يفقد ذاته وشخصيته، مما يدفعه إلى الثورة لاستعادة وجوده وكيانه الإنساني من جديد. ولا يتوقف الاغتراب عند الأزمات البنيوية الظاهرة، بل يتعداها إلى القضايا الداخلية النفسية، خاصة عند من يعانون من الاغتراب الذهني؛ وهو اضطراب نفسي يغيّر سلوك الفرد وحياته، فيشعر بأنه غريب عن مجتمعه ومحيطه القريب. فيلجأ –طوعًا– إلى العزلة، وهي عزلة قسرية غير منظورة تدفعه إلى الخضوع لقوى طاغية تتحكم في حياته بدلًا من أن يتحكم هو فيها.
والاغتراب ليس حالة فردية وحسب، بل إن الاغتراب الجمعي يعدّ من أشد أنواعه قسوة، خاصة ما يُعرف بـ الاغتراب الاجتماعي (Social alienation)، الذي يمس العلاقات بين الأفراد، ويتأثر بدرجة التكامل الاجتماعي والأخلاق والقيم السائدة، إضافةً إلى المسافة أو العزلة الاجتماعية التي قد تفصل الفرد عن الآخرين أو عن مجموعات بعينها.
لقد مرّ مفهوم الاغتراب عبر التاريخ بمعانٍ متعددة ومتناقضة أحيانًا. ففي الفلسفة القديمة ارتبط بمفهوم الإحساس الميتافيزيقي أو السمو التأملي كما في فلسفة “الزن”، بينما عند النيوبلاتونيين مثل بلوتينوس ارتبط بالانفصال عن العالم الحسي لصالح الارتقاء الروحي. وقد وجدنا أيضًا من ربطه بالدين، كأوغسطين الذي اعتبره انفصالًا عن الله، أو مارتن لوثر الذي استخدم الفعل الألماني entfremden لترجمة abalienare بمعنى الابتعاد عن الله.
أما عند الفلاسفة الكبار، فقد تنوعت الرؤى:
عند أفلاطون، الاغتراب يغيب في مدينته الفاضلة التي يحكمها الفلاسفة.
عند أرسطو، ورد بمعنى إقصاء الفرد عن ممارسة حقوقه في المدينة.
عند هيغل، الاغتراب مرحلة ضرورية لوعي الروح بذاتها، حيث يعيش الإنسان بين التبعية للدولة أو المجتمع وبين البحث عن فرديته.
عند لودفيغ فويرباخ، الاغتراب فصل بين ماهية الإنسان ونسبها إلى أصل فوق طبيعي.
عند كارل ماركس، بلغ المفهوم ذروة التحليل، إذ اعتبر أن النظام الرأسمالي يجعل الإنسان مغتربًا عن ذاته، وعن عمله، وعن الآخرين. فهو لا يؤكد وجوده بل ينكره، ويعيش التعاسة بدل الرضى.
وقد صنّف كوستاس أكسيلوس الاغتراب لدى ماركس إلى أربعة أنماط: اجتماعي–اقتصادي، سياسي، إنساني، وأيديولوجي. ورأى أن الرأسمالية تحوّل العامل إلى مجرد آلة، وتحرم الإنسان من إمكانية تحقيق ذاته.
في المقابل، اهتم فلاسفة آخرون مثل ماكس شتيرنر الذي رأى أن حتى “الإنسانية” نفسها شكل من أشكال الاغتراب، مما جعله من آباء العدمية والوجودية. كما نجد عند جورج زيمل وفرديناند تونيز اهتمامًا بآثار التحديث والتحضر على العلاقات الاجتماعية، حيث يصبح المال الوسيط الأبرز بين البشر، ويُفاقم شعور الفرد بالعزلة.
إجمالًا، يظل الاغتراب أحد المفاهيم الأكثر تعقيدًا في الفكر الإنساني، لأنه يجمع بين البعد النفسي والفلسفي والاجتماعي والاقتصادي. وهو سؤال مفتوح على الدوام: كيف يمكن للإنسان أن يستعيد ذاته ويمارس حريته في عالم يُعيد إنتاج آليات اغترابه باستمرار؟