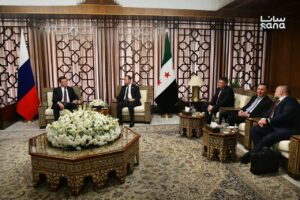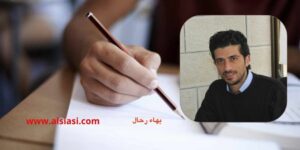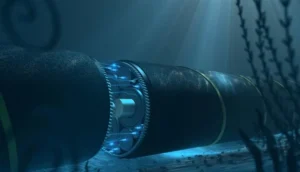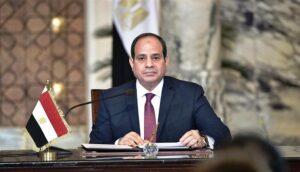لا يمكن الحديث عن العنف السياسي من دون التطرّق إلى مفهوم العنف بشكلٍ عام، إذ يُعرّف العنف بأنه الاستخدام غير الشرعي للقوة بكل أشكالها، أو التهديد باستخدامها لإلحاق الضرر والأذى بالآخرين. ويُعدّ بذلك انتهاكاً للشخصية الإنسانية، بمعنى أنه اعتداء سافر على الآخر، أو إنكار له، أو تهميش، أو تجاهل مادي، أو غير ذلك من صور الانتهاك. فمخاطبة الشخصية الفردية تعني وصفاً كلياً وشاملاً للعنف بوصفه أكثر من مجرد مساس بالجسد أو الروح؛ إذ يقرّ بأن الأعمال القهرية والانتهاكات التي تسلب الكرامة الإنسانية هي أشكال للعنف على مختلف مستوياته.
وأي سلوك شخصي أو مؤسساتي يتسم بطابع تدميري مادياً أو رمزياً ضد الآخر يُعد عملاً عنيفاً. ونحن ندرك تماماً أن هناك عنفاً شخصياً خفياً يؤذي الآخر نفسياً، وعنفاً مؤسساتياً خفياً تمارسه البُنى الاجتماعية بما تحمله من أفكار وعادات وتقاليد وثقافات، وصولاً إلى انتهاك هويّة مجموعات بشرية كاملة كما يحدث في المناطق المهمّشة والعشوائيات. وقد شهدت كثير من البلدان العربية احتجاجات ومظاهرات اتسمت بالعنف الشعبي والاجتماعي، وانطلقت في معظمها من هذه المناطق.
وللعنف منابع أخرى، تبدأ من الفرد (جسداً وروحاً)، ثم تمتد إلى العنف الناتج عن علاقات مؤذية وظالمة قائمة على القهر والإجبار بين الأشخاص. ومن هنا يتضمّن العنف السياسي جميع الممارسات القمعية، التي تشمل الاستخدام الفعلي للقوة المفرطة أو التهديد بها، وإرهاب الآخرين لتحقيق أهداف سياسية تتعلق بشكل نظام الحكم وتوجهاته الأيديولوجية والعقائدية واستراتيجياته الاقتصادية والاجتماعية. وقد يكون هذا العنف منظماً وممنهجاً أو عشوائياً، فردياً أو جماعياً، علنياً أو سرياً، مستمراً أو مؤقتاً، تبعاً لحجم الصراع وأدواته.
وقد اعتبر كثير من المفكرين والمثقفين وخبراء السياسة والاجتماع أنّ التمرد المسلّح، واستخدام القوة ضد الحكومات ومؤسساتها، وكذلك استخدام الحكومات للعنف المفرط ضد المتمرّدين، من أبرز صور العنف السياسي. ويشمل المفهوم أيضاً الحروب بين الدول، والنزاعات الأهلية الداخلية، والصراعات القبلية والعشائرية التي يُستخدم فيها السلاح الناري أو الأبيض، مخلفاً ضحايا من الطرفين.
عادةً ما ترتبط عمليات التمرد واستخدام العنف ضد السلطة بمجموعة من المطالب السياسية أو الاجتماعية أو بمظالم تتعرض لها أقليات أو مجموعات سكانية داخل حدود الدولة. وقد يكون الهدف مجرد الاستيلاء على الحكم بالقوة بعيداً عن التداول السلمي للسلطة، الأمر الذي يحوّلها إلى حروب أهلية دموية مدمّرة طويلة الأمد، يصعب التخلّص من آثارها بسهولة. وغالباً ما تُستخدم فيها جميع أنواع الأسلحة، وتنتهي إما بقمع المتمردين بالقوة المسلحة وما ينتج عن ذلك من خسائر فادحة كما حدث في سورية واليمن وليبيا والعراق ولبنان، أو – في حالات نادرة – بانتصار المتمردين وإحلال سلطة بديلة، كما جرى في دول إفريقية مثل ليبيريا وإثيوبيا وأوغندا في عهد مانغستو هيلا مريام، ومؤخراً في غينيا.
أما النزاعات العشائرية والقبلية فترجع إلى أسباب متنوّعة، منها مشاعر الاستعلاء العرقي أو التمييز العنصري، أو التنافس على الأراضي الزراعية والمراعي أو على الموارد الطبيعية كالذهب والألماس، وقد تنشب أحياناً بسبب دوافع فردية تافهة تتطور إلى مواجهات مسلحة بين عشيرتين، كما في حرب داحس والغبراء التي استمرت نحو أربعين عاماً.
كما شهدت بلدان عربية عديدة حروباً دامية ذات جذور عشائرية وقبلية، مثل سورية ولبنان وليبيا والعراق. ففي سورية مثلاً يشكل الانتماء العشائري جزءاً من النسيج الاجتماعي والتاريخي، وقد كان لبعض العشائر دور سلبي في الانخراط بأعمال مسلّحة ضد الدولة، بينما ساندت عشائر أخرى الجيش في مواجهة الجماعات الإرهابية.
ومنذ أزمنة بعيدة لعبت التغيّرات المناخية دوراً في اندلاع صراعات دامية، كما في دارفور بالسودان، حيث أدى الجفاف إلى نزاعات عنيفة على الأراضي الخصبة ومصادر المياه.
ولا يتوقف العنف عند هذا الحد، إذ نشهد نوعاً آخر أشد خطورة تمارسه جماعات الإرهاب الديني العابر للحدود، وهو عنف دموي يستهدف السلطة الشرعية والمواطنين على السواء، ويسعى لإحلال نفسه بديلاً عن جميع النظم والقوانين والثقافات. هذا العنف مطلق لا يعرف حدوداً لمطالبه، ولا يستجيب لدعوات الحوار أو تدخلات الوسطاء، ويرى في الجميع أعداءً يجب القضاء عليهم بأبشع الوسائل، ومنها الحرق حتى الموت كما حدث مع الطيار الأردني الشهيد معاذ الكساسبة. لذا يُطلق على هذا النمط من العنف وصف “العنف الأسود”.