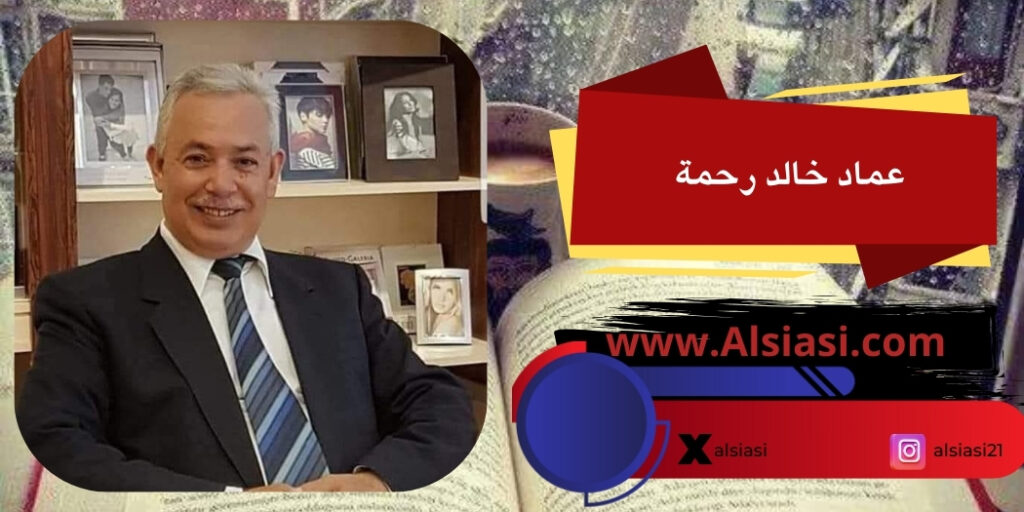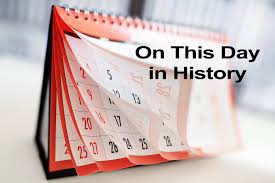في عصر تتشابك فيه الأزمات الثقافية والسياسية والاجتماعية، تتجلى الحاجة إلى حوار حضاري يعوض صراع السيوف بصخب الأقلام. إن العلاقات بين الحضارات، وعلى وجه الخصوص بين العالم العربي والغرب، لم تقتصر تاريخيًا على التبادل السلمي أو على التعلم المتبادل، بل شابتها أحيانًا النزعة الاستعلائية، التي جسدها ما يُعرف بالاستشراق، كما تناول إدوارد سعيد، موضحًا كيف صاغ الغرب صورة “الآخر الشرقي” وفق مركزية أوروبية، منحازة ومعوّقة للحوار البنّاء.
إلا أن الإشكالية ليست في الاختلاف ذاته، بل في غياب المقابسة الحقيقية، وهو المصطلح الذي استلهمناه من فكر أبي حيّان التوحيدي ليحلّ محل المثاقفة في سياق عربي، بمعنى حوار متبادل، قائم على الاحترام والفهم المتعمق للآخر، لا على الهيمنة أو الامتصاص الثقافي. فالمقابسة والمثاقفة ليستا مجرد مصطلحات أكاديمية، بل نهج وجودي وروحي ونفسي واجتماعي، يتيح لكل ثقافة أن تقدم قبسًا من نورها وتستقي من الآخر ما يعزز المعرفة والوعي الإنساني.
ففي التاريخ العربي، كان ابن رشد نموذجًا رائدًا لهذه المقابسة: جمع بين الفلسفة اليونانية والفكر الإسلامي، وفتح آفاقًا جديدة للتفكير العقلاني، مؤكدًا أن فهم الذات لا يتحقق إلا من خلال فهم الآخر. كذلك جسّد جبران خليل جبران هذا التلاقي بين الشرق والغرب عبر أعماله الأدبية، حيث امتزجت الروحانية العربية بالخيال والرؤية الغربية، ليخلق نصوصًا تنقل الإنسان من حدود المألوف إلى فضاءات الحرية الفكرية والإبداعية. وفي العصر الحديث، سعَى محمد عابد الجابري لإعادة قراءة التراث العربي ضمن مشروع حداثي عقلاني، مؤكدًا على أن النقد الذاتي والانفتاح على الآخر هما الطريق إلى تحديث الفكر والمجتمع.
ومن الجانب الغربي، نجد أنجان جاك روسو، بصفته مفكرًا توجيهيًا للفكر التربوي والسياسي، قدّر التراث العربي والفلسفي، بينما أكد إيمانويل كانط على أخلاق الحوار العالمي المبني على العقل والاحترام المتبادل. كما أن أعمال سيغموند فرويد، من خلال تحليل النفس واللاشعور، تمنحنا فهمًا نفسيًا عميقًا لمدى تأثير تبادل الثقافات على الهوية الفردية والجماعية، موضحةً أن إدراك الذات يتجسد عبر مواجهة الآخر، ليس لإخضاعه بل لفهمه والتعلم منه.
في المجال الأدبي والفني، يمكن أن نجد آثار المقابسة والمثاقفة في النصوص الروائية والشعرية والموسيقى والفنون التشكيلية. أعمال طه حسين مثل الأيام تمثل تجربة مثاقفة معرفية بين التراث العربي الكلاسيكي والمنهج الغربي النقدي، بينما أعمال ميشيل عفلق وحركة النهضة الثقافية حاولت قراءة الحداثة الغربية ضمن سياق عربي، لتخلق أرضية مشتركة للتجديد الفكري. وحتى في الموسيقى، شهد القرن العشرون تلاقحًا بين المقامات الشرقية واللحن الغربي، من موسيقى أم كلثوم وصولًا إلى أعمال الموسيقار الفرنسي أوليفييه ميسيان، الذي استلهم الأنغام الشرقية لإثراء إيقاعاته الكلاسيكية الحديثة، مما يبرز أن الفن أيضًا هو منابر المقابسة والمثاقفة الحية.
إن المقابسة والمثاقفة، بهذا المعنى، ليستا ترفًا فكريًا بل ضرورة وجودية واجتماعية وسياسية. فهي تمنح الأجيال القدرة على إعادة بناء جسور التفاهم، وتخلق فضاءات لإبداع حضاري جديد، يحترم التنوع الثقافي ويعلي شأن المعرفة الإنسانية. كما أنها تسهم في مواجهة النزعات الاستهلاكية والتسطحية الفكرية التي تغرق المجتمعات العربية والغربية على حد سواء، مستبدلةً الإشباع اللحظي بالفهم العميق، والسطحية بالعمق، والغلبة بالقوة بالوعي والمعرفة.
ولعل السؤال الأهم الذي يفرض نفسه في عصرنا الحالي: هل يمكن للعالم العربي والغربي أن يتحول من منطق القوة والتسلط إلى منطق المقابسة البنّاءة والمثاقفة الواعية؟ وهل يمكن للقلم، بفعل هذا الحوار المتبادل، أن يصبح جسرًا دائمًا بين الثقافات، يعلو على نزعة الهيمنة والتسلط؟ التاريخ، الأدب، والفلسفة، مع كل ما أنتجته البشرية من إرث معرفي وإنساني، تشير إلى أن الإجابة تكمن في القدرة على الجمع بين أصالة الذات واحتضان الآخر بروح نقدية متسامحة، تخلق حضارة مشتركة تقوم على الحوار والإبداع والاحترام المتبادل.
في هذا المسعى، يصبح القلم أداة للتحرر الفكري والارتقاء المعرفي، والسيف مجرد رمز لماضٍ تجاوزته الإنسانية بالوعي والحوار، لنفتح آفاقًا جديدة حيث يصبح الآخر شريكًا في البناء، لا خصمًا في الصراع.