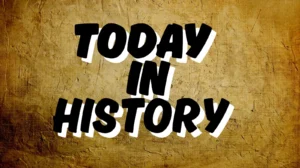إنّ الفكر الثقافي العربي، منذ انكساراته المتتالية، لم يزل يتدحرج في هاويةٍ متشظية، كأنّه يعيد إنتاج محنته بوعيٍ ناقص، أو بوعيٍ مغترب عن شروط وجوده التاريخي. هذه المحنة، التي يمكن توصيفها – استعارةً – بـ محنة عدمية الحوار مع الآخر، لم تكن مجرد أزمة تواصل أو تعثّر في الانفتاح، بل كانت انهياراً في البنية العميقة للجدل الثقافي، وانغلاقاً على الذات، بل وتبريراً لهذا الانغلاق بمقولات متكلّسة تحتمي بالمقدّس أو بالهوية المجرّدة.
1. الثقافي والسياسي: القطيعة الزائفة:
لقد جرّد المثقف العربي نفسه – وفق ما يشير مطاع الصفدي – من قدرته على مواجهة قلق الأنطولوجيا، حين تبرأ من السياسي، معتبراً إياه براغماتياً نفعيّاً “منخفضاً إلى مستوى نقابي”، لا يحمل هماً وجودياً أو مشروعاً تاريخياً. هذه القطيعة لم تُحرر الثقافي من ابتذال السياسة، بل زادت من عطالته، إذ صار حبيس دائرة نظرية تردّد صدى ذاتها، أشبه بما سماه أنطونيو غرامشي “الحزب الذي يسمع رنين صوته فقط”. هكذا تحوّل الفكر الثقافي العربي من فضاء مفتوح للجدل إلى جماعة نقابية مغلقة، منشغلة بمصالحها الضيقة على حساب المشروع الكوني للتحرر والعدالة.
2. النص والفقه والهيمنة:
ما يزيد هذه المحنة تعقيداً، أنّ الفكر العربي ظلّ أسيراً لـ أيديولوجيا النصوص وفقهويتها التطهيرية، حيث هبطت النصوص من علياء المعنى إلى أرض العصاب الديني، ومن ثم تحوّلت إلى أدوات قمع رمزي وهيمنة. هنا يحضر مفهوم بيير بورديو عن العنف الرمزي ليصف كيف صارت النصوص تُستعمل كآليات لإنتاج الخضوع لا لتحرير الوعي، وكيف استحالت المدن العربية – بما تحمله من تاريخ سرانيّ مطموس – إلى فضاءات مغلقة على ذاكرة السلطة، لا على ذاكرة المجتمع.
3. ما بعد الصدمة: غياب التأسيس.
لم يُنتج العقل العربي – في بعده السوسيولوجي والسياسي – مقدماتٍ إجرائية لمرحلة ما بعد الصدمة. المرحلة التي يُفترض أن تكون مساحة للتعافي وبناء الميكانيزمات المؤسسية والشرعية لإدارة الخلاف، ظلّت مدفونة تحت التراب، لم يُكتب لها أن تتحوّل إلى مشروع تاريخي ملموس. بدلاً من ذلك، استُعيدت آليات العنف الرمزي والطقوسي، وأُعيد إنتاج الموقف التاريخي ذاته، كأنّ الثقافة العربية غير قادرة على تجاوز الطقس إلى الفكر، ولا من الإيهام إلى الفعل.
4. السلطة والتماثل الثقافي:
لقد صار الصراع على التماهي مع ثقافة السلطة هو المهيمن، فيما وجدت الثقافات الهامشية نفسها تخوض حرب مواقع ضد الثقافة السائدة. هنا تبرز الإشكالية الغرامشية مجدداً: هل الثقافة أداة هيمنة أم أداة تحرر؟ ما يحدث عربياً يُظهر أن الهيمنة انتصرت، لكن على حساب ضمور المشروع الحضاري. فالفكر العربي، وهو يسعى للتماهي مع السلطة، فقد قدرته على مقاومة سلطتها الرمزية، ولم يعد يملك سوى خطابٍ انعكاسيّ يعيد إنتاج وهم القوة.
_ 5. بين الثورة والمقدس والعيش،:
لقد فقد الفكر الثقافي العربي، نتيجة هذه الأزمة، معاييره القياسية في التعامل مع مفهومات الثورة، والقداسة، والأهلية، والمعيش، والسلطة، والرفاهية، والإيديولوجيا. لم تعد هذه المفاهيم قادرة على أن تُشكّل أفقاً نقدياً، بل تحوّلت إلى أدواتٍ صورية يلوّح بها الخطاب دون أن يمتلك القدرة على تحويلها إلى ممارسة تاريخية أو اجتماعية فاعلة. وهنا نستحضر مقولة هابرماس عن “التواصل المشوّه”، حيث تغيب العقلانية الحوارية لصالح منطق الإقصاء والتسطيح.
_ خاتمة: الحاجة إلى استعادة الحوار.
إنّ محنة عدمية الحوار مع الآخر ليست مجرّد أزمة في الخطاب، بل هي تعبير عن أزمة أعمق في بنية العقل العربي ذاته: عقل فقد ثقته بذاته كما فقد ثقته بقدرة الآخر على أن يكون شريكاً في مشروع المعنى. النتيجة كانت فكراً متشظياً، أسير النصوص، عاجزاً عن تأسيس مرحلة ما بعد الصدمة. الخروج من هذه المحنة لا يكون إلا باستعادة السؤال الفلسفي-الأنطولوجي، أي إعادة بناء العلاقة بين الثقافي والسياسي على قاعدة العقلانية الحوارية والتداولية، والانفتاح على الآخر لا بوصفه تهديداً، بل بوصفه شرطاً لوجود الذات نفسها.