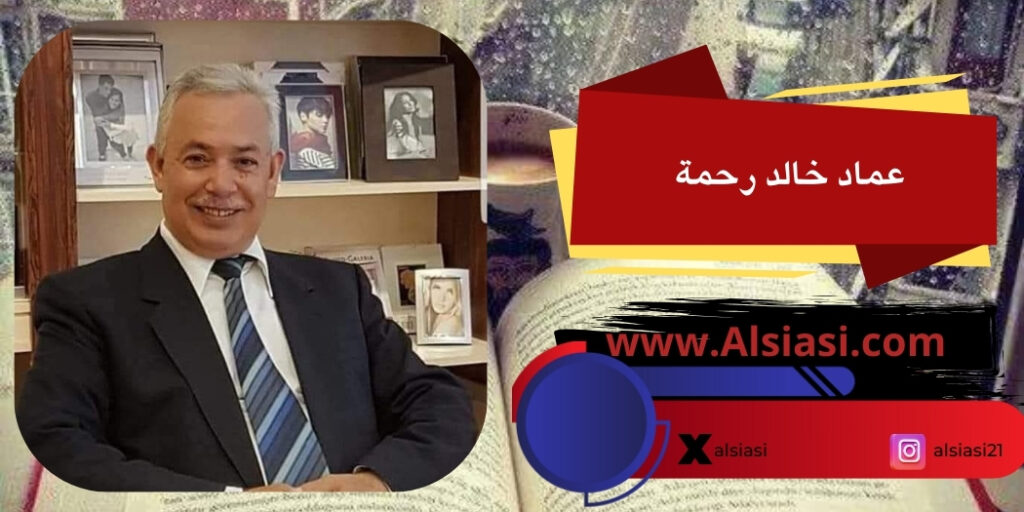ما تزال الأمة العربية ترزح تحت أثقال أزمة الدولة الوطنية، تلك الدولة التي بدت – في ظاهر بنيتها – مكتملة الأركان: دستور مكتوب، وسلطات قائمة، وهياكل سياسية وقانونية وإدارية. غير أنّ هذا الكيان، في جوهره، يفتقر إلى المقومات الجوهرية التي قامت عليها الدولة الوطنية في التجارب الحديثة والمعاصرة. فهي في الغالب سلطة أمر واقع، تفتقر إلى الشرعية الشعبية الحقيقية، وتستمد بقاءها من القهر أو العصبية أو الطائفية، أكثر مما تستمده من عقد اجتماعي جامع.
إنّ مؤسسات هذه الدول، على كثرة مسمياتها، ليست سوى حبر على ورق، ووجودها الفعلي يتناقض مع إرادة شعوبها وتطلعات مواطنيها إلى حرية الوجود، وحرية الرأي والتعبير، والمشاركة الفعلية في السلطة. أما مصادر السلطة فيها فتتوزع بين الانقلاب العسكري، والتسلط العشائري، والتغوّل الطائفي. وفي ممارساتها السياسية، تتنقل هذه الدول بين إرث الاستعمار القديم القائم على مبدأ “فرّق تسُد”، وبين سطوة الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تمارس القهر بأبشع صوره، أو بين التقسيم الأيديولوجي للمجال السياسي، بل وتجمع بين هذه الأساليب جميعاً.
ولادة الدولة الوطنية في المشرق العربي والمغرب العربي جاءت في أعقاب الحربين العالميتين، على أنقاض تقسيمات فرضتها الإمبراطوريات الأوروبية الكبرى. لكن هذه الولادة كانت مشوهة، إذ نشأت كيانات تحمل اسم “الدولة الوطنية” من غير أن تحمل جوهرها، وسرعان ما وقعت فريسة سلطات ضيقة الأفق: عسكرية، عشائرية، وطائفية، صادرت الحريات، وأقصت العدالة الاجتماعية، وتنكّرت للمساواة بين المواطنين.
بل إنّ بعض هذه الدول قدّمت نفسها ككيانات مؤقتة، ريثما تتحقق الوحدة العربية المنشودة، لكنّها سرعان ما تحولت إلى مراكز قوة، ونظرت إلى ما حولها كهوامش تابعة، حتى غدا كل زعيم فيها يزعم أنه “زعيم الأمة كلها”، فيما كان الواقع أن لا السلطات ولا الشعوب آمنت حقاً بالدولة الوطنية أو بالدولة القومية، بل تعامل كل طرف مع الأمر وفق حساباته ومصالحه.
واليوم، تواجه دول المشرق العربي أزمة بنيوية غير مسبوقة، تمس جوهر وجودها، حتى كادت بعض الكيانات – كالعراق وسورية ولبنان – أن تبلغ حدود الاضمحلال الكياني. لم يعد الخطر مقتصراً على التدخلات الأجنبية المباشرة التي أفرغت السيادة من مضمونها، بل تجاوزه إلى هشاشة داخلية في بنى الدولة ومؤسساتها، حتى بات غياب الدولة الفعلية هو الملمح الأبرز في المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
هذا الواقع كشف انحدار مستوى الخدمات الأساسية، وأبرز عجز القوى السياسية، على اختلاف مشاربها، عن بناء أي توافق وطني يحمي الدولة من التفتت. فالسياسة، كما ينبغي أن تكون، ليست مجرد صراع على السلطة، بل هي – في معناها الحديث – ممارسة عقلانية لإدارة المصالح الوطنية بما يحقق الصالح العام. غير أنّ غياب الحدود الوطنية والأخلاقية في هذا الصراع، حوّله في منطقتنا إلى صراع عدمي دموي، أشبه بما وصفه الفيلسوف الإنكليزي توماس هوبز بـ”حرب الكل ضد الكل”، حيث يصبح الهدف إلغاء الآخر ومحوه من الوجود، بلا وازع وطني أو أخلاقي.
العراق، على سبيل المثال، منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003، لم ينجح في بناء إطار وطني جامع أو مؤسسات سيادية مستقرة، بل تحوّل إلى ساحة مفتوحة للسلاح المنفلت بأيدي الفصائل والطوائف، في ظل غياب أي سلطة مركزية قادرة على احتكاره أو ضبطه. وهكذا غدت قوة السلاح هي الضمانة الوحيدة للنفوذ الطائفي أو المذهبي أو العرقي، على حساب فكرة الدولة الجامعة لكل مواطنيها.
إنّ الدولة الوطنية الحقيقية تقوم على مبدأ المساواة الكاملة بين المواطنين، بلا تمييز ديني أو مذهبي أو عرقي أو اجتماعي أو ثقافي. وهي كيان لا غنى عنه لحياة الشعوب، شرط أن تُبنى على الشرعية الشعبية، والعدالة، وحكم القانون. أما في واقعنا العربي الراهن، فنحن ندفع أثماناً باهظة نتيجة سياسات داخلية قاسية، واضطرابات إقليمية ودولية، بل ونعيش في ظل غياب نظام عالمي متوافق يمكن أن يشكّل مرجعية عادلة لحل الأزمات، كما حدث – ولو نسبياً – في زمن الحرب الباردة.
وهكذا، فإنّ إعادة تأصيل مفهوم الدولة الوطنية في عالمنا العربي باتت ضرورة تاريخية لا مفر منها، إذا أردنا أن نحفظ أوطاننا من التفتت، ونؤسس لشرعية سياسية تستمد قوتها من إرادة الشعب لا من فوهة البندقية.