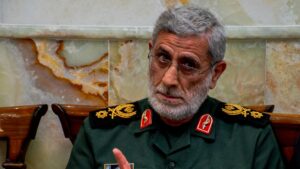في التاريخ اليمني المعاصر، يشكّل يوم 26 سبتمبر 1962 محطة مهمة في حياة اليمنيين بجميع مكوناتهم واتجاهاتهم السياسية. فهو ليس مجرد يوم الثورة أو الانتقال السياسي الذي أزاح نظام الحكم الملكي الوراثي القائم على احتكار السلطة لطبقة دينية–إثنية معينة ، بل لأنه اليوم الذي شكل المسار الأول لليمنيين لفتح آفاق عديدة ومعرفة صور جديدة في الحياة توزعت بين مفاهيم الحداثة التي انتهجتها دول كثيرة في العالم منتصف القرن التاسع عشر، إضافة إلى قيم أخرى كالمساواة والعدالة الاجتماعية ومكافحة التمييز وتذويب الطبقية، التي بلغت ذروتها في عهد الإمامة وكانت علامة تميز شكل ذلك الحكم الملكي الذي سيطر على اليمن لعقود طويلة. لقد كان يوم ثورة سبتمبر بمثابة نقطة تحول أنتجت أول نظام جمهوري في شبه الجزيرة العربية، وهو نظام حكم حمل رؤية متكاملة لفهم الواقع اليمني بعمق، وقدم أساساً للدولة المستقبلية التي نشأت كمضاد للملكية العقائدية وكإطار مؤسسي يجمع بين الحرية والمواطنة، ورسم الملامح الأولية للبناء الدولتي الذي مهّد لاحقًا للنظام الديمقراطي الناشئ في البلاد.
ويمكن تمثيل حالة الانتقال بين عصر الإمامة وعصر الجمهورية في اليمن بفكرة طالما تكررت في مؤلفات العديد من الفلاسفة، الكلاسيكيون والمعاصرون، وأبرزها أسطورة الكهف لأفلاطون التي صورها في كتابة «الجمهورية» بمجموعة من الأشخاص المقيّدين منذ ولادتهم داخل كهف، ويوجد أمام أعينهم حائط من الصخور، وخلفهم نار مشتعلة تمكنهم فقط من رؤية انعكاس الظلال على الحائط الناتجة من الأشياء التي تمر أمام النار. في هذه الصورة يعتقد سجناء الكهف أن الظلال التي يرونه هي الحياة بأكملها وهي الواقع بأكمله، ولا يدركون أن هناك عالما حقيقيا يقع خارج الكهف. انها صورة بليغة تعبر تجريديا عن الأسباب التي تؤدي إلى انعدام الإدراك الجمعي للواقع , ولا يمكن عزلها عن مشهد حكم الإمامة في اليمن الذي عرف بسيطرته الصارمة على المجتمع، وفرضه للكثير من القيود وجعل غالبية المواطنين يعيشون في دائرة كبيرة من التجهيل والموروثات العقائدية دون السماح لهم بالاطلاع على الفضاء المليء بالحقائق التي لم يسبق لهم رؤيتها.
– العبور الى وراء الحائط
ظلت دولة الإمامة بمثابة جدار الكهف، تحجب اليمنيين عن فهم واقعهم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي, حتى اقتنعوا بأن القيود والفرضيات اللاهوتية والواجبات اليومية وقرابين الطاعة المقدمة لشخص الإمام آنذاك هي الحقيقة الوحيدة الممكنة والمصير المشترك الذي لا فرار منه. لكن ذلك لم يدوم ابديا حيث خرج اليمنيين من هذا الكهف في يوم ثورة سبتمبر وكان ذلك بمثابة رحلة السجين الهارب نحو الضوء والتحرر من القهر والسعي لبناء نظام اجتماعي جديد بعيد عن السيطرة المطلقة والهيمنة الطبقية. من هنا، يمكن طرح فكرة ان النظام الجمهوري أتاح للمجتمع اليمني بعد ثورة سبتمبر إعادة تعريف الحرية والمساواة بصور متعددة وكان بمثابة دعوة للمجتمع أن يكون شريكا في الحياة العامة، لا مجرد متلقٍ للتعليمات والشعارات من قلة وراثية تحتكر السلطة.
بعد أن أتاح النظام الجمهوري لليمنيين آفاقا جديدة، برزت مع مرور الوقت نقاشات عديدة حول طبيعة هذا النظام وقدرته على الاستمرارية. وكان أبرز ما طُرح مؤخرًا في الفضاء العام التشكيك بفعالية النظام الجمهوري نفسه ومسألة الخلط بين القيمة السياسية للنظام الجمهوري وبين الممارسات العبثية التي أضعفته عبر العقود. إذ يذهب البعض إلى القول إن الجمهورية مجرد نموذج مستورد لم يتناسب مع المجتمع اليمني بتركيبته القبلية، وأنها اصطدمت بالواقع وأدت إلى أزمات متلاحقة. غير أن هذا الطرح متواضع على كافة الأصعدة، لأنه ينظر بشكل منحاز إلى قشور المشكلة لا إلى جذورها. فالمشكلة لم تكن في البنية الفكرية أو التنظيمية للنظام الجمهوري، بل في فشل القدرة على إدارته، وهذه معضلة عانت منها أنظمة حديثة في دول عدة حول العالم، لا في اليمن وحده.
وفقا لمعطيات الواقع السياسي في اليمن بعد الثورة يمكن الاستنتاج ان النظام الجمهوري ليس مجرد نسخة من نموذج تم استيراده بلا رؤية ، بل إطار سمح للبنية الاجتماعية بالتحول دون فقدان التكتلات الاجتماعية هويتها. بمعنى أن المكونات الاجتماعية المتعددة في البلاد ظل لها وجودها حتى بعد قيام النظام الجمهوري وهو ما عكس التوازن بين أفكار الحداثة ومتطلبات المواطنة والحفاظ على الأشكال أو الموروثات الاجتماعية.
– الشراكة في السلطة والقرار
لقد أظهرت التجربة اليمنية بعد ثورة سبتمبر ضرورة إشراك مختلف مكونات المجتمع، ومنها القبلية، في السلطة وفي شتى جوانب الدولة الوليدة في عهد الرئيس السلال وفي الفترات التي تلت حكمه، وذلك رغم التباينات التي رافقت تلك التحولات. فقد كانت القوات القبلية، مثلًا، عنصرًا مؤثرًا داخل الجيش الجمهوري بعد ثورة سبتمبر، وفقا لمذكرات القاضي الإرياني. كما كان للقبائل حضور في إبرام اتفاقيات وعقد مؤتمرات عديدة. ولم تُفضِ هذه المؤتمرات إلى إنهاء الصراعات البينية بعد الثورة فحسب، بل عززت أيضًا دور قادة القبائل في السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأسهمت في صياغة دستور الجمهورية عام 1965، وهو ما ضمن فعليًا مشاركة مختلف مكونات المجتمع بشكل رسمي في مؤسسات الدولة، بحسب دراسة أكاديمية بعنوان «القصر والديوان» لمجموعة من الأكاديميين والباحثين اليمنيين.
سياسيا كسر النظام الجمهوري فترات احتكار السلطة وفتح افق للشراكة السياسية، ما أوجد وعيا جديدا حوّل المواطن اليمني من تابع منقاد إلى شريك مسؤول. بينما اجتماعيا، أعاد النظام الجمهوري صياغة المجتمع على أسس المساواة والمواطنة. وجعل التعليم والصحة والمشاركة السياسية حقوقًا عامة. أما اقتصاديا، فقد تحولت موارد الدولة من غنيمة للحاكم إلى مشروع جماعي تم ربطة بمفاهيم العدالة الاجتماعية، من خلال إعادة توزيع الموارد وتكريس مؤسسات تشريعية ورقابية تحد من مطلقية السلطة.
من الضروري التأكيد أخيرًا أنه لا يمكن اختزال النظام الجمهوري في سردية مثالية أو في لحظات تعثر بسبب الحروب والفساد. بل ينبغي تقييمه في ضوء ما كان عليه عصر الإمامة، والنظر إليه كبنية فكرية وواقعية أعادت تعريف العلاقة بين المواطن والدولة والسلطة.
صحفي وباحث سياسي*