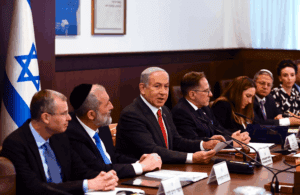يُعَدُّ الفساد الفكري أخطرَ أنواع الفساد لأنّه يسبق كلّ انحرافٍ أخلاقيٍ وسلوكيّ؛ هو التربة الحاضنةُ للبذور المسمومة التي ستنبت لاحقًا فسادًا مادّياً وسياسياً واجتماعيًا. حين يتراجع العقل النقديّ، وتَغِبُ الثقافةُ الحرّةُ، وتتحوّل القيم إلى سِلعٍ تُباعُ وتُشترى عبر شاشاتٍ زرقاءٍ وصفحاتٍ صفراء، يصبح المجتمعُ سهلَ الاستغلال: تُدمَّرُ ثقة الناس في مؤسساتهم، وتتهشَّم أخلاقيات العمل العام، وتُستبدَلُ أسئلةُ الوجود والعدالة بمقاطعٍ تلقينيةٍ من الخطاب التجاريّ والسياسيّ.
هذا الفساد لا يقتصر على محتوىٍ فكريٍّ منحرفٍ أو على أدبياتٍ أقلّ ما يُقال فيها إنها رديئة؛ إنّه آفةٌ هندسية للذهن، منظومةُ إجهاضٍ للقدرة على التفكير النقديّ، وبناءٍ ممنهجٍ للذوق العام على مقاييسٍ سوقيةٍ فارغة. ليس أدلّ على ذلك من ظاهرة تسلّط ثقافة “الفضيحة” ومقاييس الانتباه الهابطة، حيث يختزل الإنسانُ إلى خبرٍ يستهلكهُ الجمهورُ ثم يسيرُ في طريقه، دون أن تترك في ضميره حسًّا بالمسؤولية أو سؤالًا عن العواقب.
لقد بيّن الفلاسفة والمفكّرون أن للثقافة دورًا جوهريًا في صيانة النفس الجماعية. فالفيلسوف السياسي يرى أن شبكة الفاعلين الثقافيين تساهم في إنتاج المشروعية وتشكيل الوعي (كما لاحظ أنطونيو غرامشي في مفهومه عن الهيمنة الثقافية)، ومن ثمَّ فإن احتلال المجال الفكري بواسطة منظوماتٍ أميرالية ــ نيوليبرالية أو محلية زبائنية ــ يحوّل الثقافة إلى آليةٍ لإنتاج الطاعة والتواطؤ. أما ميشيل فوكو فكان ليشدّد على أن السلطة تنتج المعرفة بقدر ما تنتج قوانينَ السلوك؛ فحين تستولي منظوماتُ السلطة على قنوات الخطاب تصبح المعرفةُ نفسها مُهيأةً لخدمة مشاريعها. ولا يخفى هنا ما قاله أدرْنو وهوركهايمر عن “صناعة الثقافة” التي تحول الفنّ إلى بضاعة وتُضعِف قدرة الجماهير على مقاومة التلقين الثقافي. وفي السياق المعاصر، أشارت كتاباتُ نعوم تشومسكي ونقدُه لآليات “صناعة الموافقة” إلى دور وسائل الإعلام في توجيه الرأي العام وطمس البدائل.
على مستوىنا العربي، تجلّت خطورة الفساد الفكري في ثلاثة مسارات متداخلة: أولًا، تآكلُ التعليم العام وطغيانُ مناهجٍ تحفظُ دون أن تُعلّم التفكير؛ ثانيًا، اختراقُ فضاءات الإعلام واحتلالها من قبل مصالحٍ اقتصادية وسياسية؛ ثالثًا، اندثارُ المثقف المستقلّ لصالح “مثقفٍ بطانةٍ” يعمل أحيانًا كوسيطٍ لتلطيف سياسات النّخبة الحاكمة. ولقد تناغم هذا بعنوان “الفساد الزبوني” حيث تتكاثر شبكات المصالح وتُستغلّ المؤسسات لتحقيق مكاسبٍ فئويةٍ على حساب الصالح العام، فتتمخّض هرمِيةٌ موازيةٌ تُضعف مناعة المجتمع وتحوّله إلى ملعبٍ للتقاسم. هنا يستحضرنا ابن خلدون إذ بيّـن أن التماسك الاجتماعي أو “العصبيّة” إذا انتُقِصت تنتكس الأمة؛ وأن تآكلُ الضوابط الأخلاقية يولّدُ تهافتًا على المنافع الخاصة.
النفايات الفكرية التي تفيض بها قنواتُنا وفضاءاتُنا الرقمية ليست محض صدفة؛ بل هي نتيجة سياساتٍ ثقافيةٍ واقتصاديةٍ تُريد أن تُبقيَ المجتمعَ في حالةٍ من التشتت والانهماك. فالخطاب الذي يعمل على تفخيخ الثقة بالذات الوطنية، أو يحوّل الدين إلى أداةٍ للتقسيم، أو يروّجُ لقيمٍ استهلاكيةٍ تُذيبُ الصلة بين الفرد والمجتمع، هو فسادٌ فكريٌّ قبل أن يكون سلوكًا مرفوضًا. وفي هذا المعنى يصبح الفساد الفكري آلةً لتدمير المواطنة، والهدفُ منه ليس فقط السيطرة على موارد البلد، بل إجهاضُ قدرة المجتمع على المطالبة بحقوقه وفهم مصالحه.
_ أمثلة عملية تظهر مدى الخطر:
برامجٌ ترفيهيةٌ تتقلّص فيها المسافة بين الجدية والتافهة، حتى تختفي البرامج الثقافية الجديرة؛
صفحاتُ إلكترونيةٌ تُروّج للأخبار المفبركة والتضليل، ما يؤدي إلى تفشي الشائعات وزعزعة الثقة بالمعلومات المؤكّدة؛
_ مناهجٌ تعليميةٌ لا تُعلّم النقد، بل تحفظُ تفاصيلَ دون فهمٍ أو قدرةٍ على التطبيق.
_ العواقب المباشرة تتجلّى في: تجذر الفساد المادي، تراجع الالتزام بالقوانين، استشراء الرشوة، هروبُ الكفاءات، وتفكّك النسيج الاجتماعي. أما على المدى البعيد، فالنهاية هي فقدان السيادة الثقافية والاقتصادية والسياسية.
ولأن المعالجة تتطلّب فهمًا ممنهجًا، فإني أقترحُ منظومةً من الإجراءات المتكاملة:
1. إصلاح منظومة التعليم: إدراج مقررات في التفكير النقدي، مناهج تُعلّم منطق الجدال وأدوات التحقق من المعلومات، وتطوير تدريب المدرّسين ليصبحوا محفّزين على السُّؤال لا ناسخين للمعلومة. (في روح هابرماس الذي اعتبر الفضاء العمومي مكانًا للتداول العقلاني).
2. تعزيز استقلال وسائل الإعلام: قوانين تحمي الصحافة المستقلة، ودعم منصات إعلامية غير ربحية، وتشريع ينظم التمويل الإعلامي ويُجري رقابةً شفافة على مصادر الإعلانات والعلاقات مع السلطات.
3. محاربة الفساد البنيوي: تشريعات شفافة لمراقبة الصفقات العامة، ومؤسسات رقابية مستقلة قادرة على متابعة الأموال وفضح شبكات الزبونية، مع معاقبةٍ رادعةٍ للمتآمرين على المال العام.
4. تعزيز الثقافة المدنية: برامجٌ مجتمعيةٌ تزرع قيم المواطنة، التعليم في التاريخ المحلي والوطني بموضوعية، ودعم المبادرات الثقافية المحلية التي تبني ذائقةً نقديةً ومستقلة.
5. تنمية المناخ الفكري الحر: حماية حرية التعبير مع حدودٍ قانونية واضحة ضد التحريض والعنف، وتشجيع منابرٍ فكرية وأكاديمية تمنح مستقلّي الفكر منابر نشر وتبادل أفكار.
6. تفعيل دور المثقف العام: تشجيع المثقفين على العودة إلى فضاء الجدل المدني، وتحفيز المؤسسات الأكاديمية والبحثية لإنتاج دراساتٍ تفضح آليات الفساد الفكري وتقدّم بدائلَ معرفية.
7. التعليم الرقمي ومحو الأمية الإعلامية: تعليمُ كلّ فئات المجتمع مهاراتَ التثبت من الأخبار، والتمييز بين المصدر الموثوق والزائف، وفهم آليات الخوارزميات التي تعمل على تضخيم الانطباعات السلبية.
إنّ مقاومة الفساد الفكري ليست مهمّةً جيوسياسية فحسب، بل مشروعُ استعادة كرامة الأمة ووجودها الحر. كما شدّد المفكّرون عبر التاريخ: لا إصلاح حقيقي دون بناء عقلي وفكري متين. لقد أكّد هيجل على دور الروح في تشكيل المجتمع، وذكر شومسكي أن السيطرة على وسائل الإعلام تعني السيطرة على المجتمع نفسه؛ ومن ثمّ فإن استعادة العقل العام هو استردادُ السلطة الأولى في أي مجتمعٍ يريد الحياة.
_ ختاماً: إبعادُ النفايات الفكرية عن الحياة العامة ليس ترفًا، بل شرط بقاء. لا يسقط الفساد المادي وحده إذا بقي الفكر مُلوَّثًا؛ ولا تنهض المؤسساتُ إذا ظلّت ذهنيةُ الفساد تتربّص بها من داخلها. مكافحة الفساد الفكري هي معركة حضارية أولى، وبغيرها ستصبح جميعُ المعارك الأخرى معاركَ تفويضٍ للزمن ليحكمَه من لا يحمل ضميرًا ولا تاريخًا ولا رؤيا وطنية. علينا أن نغذّي عقولنا بالمعرفة الصافية، ونحصّن شبكاتنا بالقيم الصالحة، لنُعيد للدولة هيبتَها وللمجتمع قوّته، وللفكرِ حريته التي تمهد لكل إصلاحٍ حقيقيّ.