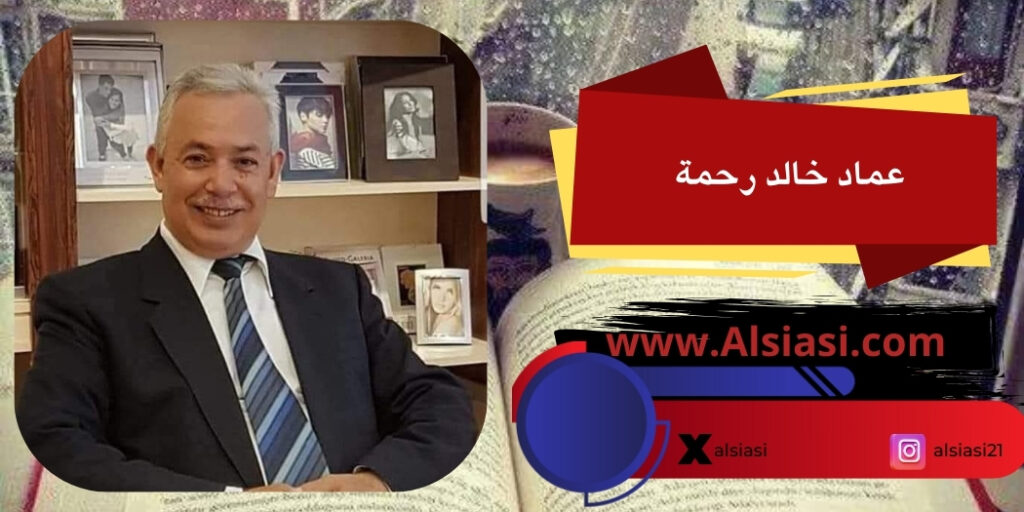الذات ليست كياناً بسيطاً يُختصر في حدود الجسد أو انعكاسات الوعي، بل هي معمارٌ أنطولوجي متعدّد الطبقات، يتداخل فيه ما هو وجودي بما هو تاريخي، وما هو داخلي بما هو كوني. إن الحديث عن انطولوجيا الذات يعني الولوج إلى أعمق طبقات الكينونة الإنسانية، حيث يصبح الإنسان سؤالاً مفتوحاً لا على معنى وجوده فقط، بل على شرعية حضوره في العالم.
لقد رأى مارتن هايدغر أن الكائن الإنساني ليس مجرد موجود بين الموجودات، بل هو “الدازاين”، الكائن-هنا، الذي يُعرّف نفسه عبر إمكانية أن يكون. هذا الإمكان هو ما يجعل الذات مشروعاً لا ينتهي، إذ لا تُستنفد حقيقتها إلا في انفتاحها على المستقبل، وعلى القلق الوجودي الذي يفتح أمامها أفق الحرية. وفي المقابل، يذكرنا جان بول سارتر أن الإنسان “محكوم عليه بالحرية”، فالذات ليست جوهراً ثابتاً، بل فعل اختيار دائم يخطّ مصيره بيديه، ولا يملك ترف الاختباء وراء قوالب جاهزة أو أعذار حتمية.
هناك عدد من المفكرين والفلاسفة العرب الذين خاضوا في سؤال أنطولوجيا الذات أو مقاربات قريبة منه، سواء من منظور فلسفي وجودي، أو صوفي، أو فكري–معرفي حديث. ومن أبرزهم:
1. ابن عربي (1165–1240م): تناول الذات في إطار “الإنسان الكامل” بوصفه مرآة للتجلّي الإلهي، حيث تصبح الذات فضاءً جامعًا للأسماء والصفات.
2. أبو حامد الغزالي (1058–1111م): أكد على معرفة الذات كمدخل لمعرفة الله، وجعل من باطن الإنسان مجالاً أنطولوجيًا للتجلي والمعرفة.
3. عبد الرحمن بدوي (1917–2002م): من أبرز الفلاسفة العرب الوجوديين، كتب عن الحرية والقلق والذات بوصفها مشروعًا وجوديًا مفتوحًا، خاصة في كتابه الزمان الوجودي.
4. حسن حنفي (1935–2021م): تناول مفهوم الذات ضمن مشروعه “التراث والتجديد” و”الوعي التاريخي”، مؤكدًا على ضرورة استعادة الذات العربية في مواجهة الاستلاب الثقافي.
5. طه عبد الرحمن (1944– ): ركّز على البعد الأخلاقي والروحي للذات، واعتبر أن الكينونة الإنسانية لا تُفهم إلا من خلال تفاعلها مع القيم والمعنى.
6. محمد عابد الجابري (1935–2010م): وإن لم يستخدم مصطلح “أنطولوجيا الذات” صراحة، إلا أنه انشغل في نقد العقل العربي بمسألة تشكّل الوعي والهوية الذاتية العربية في علاقتها بالتراث والعقلانية.
7. عبد الكبير الخطيبي (1938–2009م): قدّم أطروحة حول “ازدواجية الذات” و”الهوية المتعددة”، محاولًا مقاربة الذات العربية بين الأصالة والاختلاف.
8. جورج طرابيشي (1939–2016م): في سياق قراءاته النقدية، لاسيما في مشروعه نقد نقد العقل العربي، اشتبك مع سؤال الذات والعقل والحرية في أفق الحداثة.
9. أنور عبد الملك (1924–2012م): في أعماله عن الفكر القومي والهوية، تناول الذات العربية ككينونة تاريخية–حضارية تسعى للتحرر.
10_ أحمد نسيم برقاوي
تحدث في أعمالهالفكرية والفلسفية عن انطولوجيا الذات، مؤكد أنها ليست بحثاً في الجوهر الفردي وحسب، بل هي دعوة إلى التحرّر من الأقنعة، وإلى مواجهة الوجود بشجاعة، حيث يصبح الإنسان مشروعاً يكتب ذاته باستمرار، ويصوغ حريته بوعي يتخطى حدود الخوف والتقليد. فالذات ليست ما نملك، بل ما نصبحه في كل لحظة، وما نتركه أثرًا في العالم.
باختصار يمكننا القول إن مقاربة أنطولوجيا الذات عند العرب تمازجت بين:
_البعد الصوفي (ابن عربي، الغزالي).
_البعد الوجودي الحديث (عبد الرحمن بدوي).
_البعد النقدي–المعرفي (الجابري، طرابيشي، حنفي، الخطيبي).
_البعد الأخلاقي–الروحي (طه عبد الرحمن).
انطولوجيا الذات عند هنري برغسون يؤكد أنه نفذ إلى جوهر الذات من زاوية الزمن الداخلي، رأى أن الذات كيان يتدفق في “المدّة” ، حيث لا تنفصل لحظة عن أخرى، بل تنسج الوعي نسيجاً واحداً متواصلاً، يجعل الفرد تاريخاً حيّاً لا ينقطع. بينما أضاء بول ريكور فكرة “الهوية السردية”، مؤكّداً أن الذات لا تُبنى إلا عبر قصتها، أي عبر تأويل مستمر لذاكرتها وتجاربها، ومن ثمّ فإن الإنسان لا يُعرَف بما هو عليه فحسب، بل بما يرويه عن نفسه وما يشكّله من سردية تعطي لحياته معنى.
وعند النظر مرة أخرى إلى التراث العربي–الإسلامي، نجد أن ابن عربي صاغ الذات بوصفها مرآة للتجلّي الإلهي؛ فالإنسان الكامل عنده هو الكائن الذي يحتضن في جوهره جميع الأسماء الإلهية، ويصبح وجوده رحلة دائمة بين العدم والامتلاء. بينما اعتبر الغزالي أن معرفة الذات هي السبيل لمعرفة الله: “من عرف نفسه فقد عرف ربه”، ليجعل من الذات فضاءً أنطولوجيًا يتجاوز المحدود إلى المطلق.
هنا تبرز إشكالية عميقة: هل الذات معطى جاهز نكتشفه، أم مشروع نبنيه؟ هل هي حقيقة تُصان في الأعماق، أم هوية تتجدّد مع كل فعل واختيار؟ لقد حاول فوكو أن يقارب الذات باعتبارها نتاج علاقات السلطة والمعرفة، فهي ليست بريئة، بل تتشكل عبر الخطابات التي تحدّد شروط إمكانها، ومن ثمّ فإن انطولوجيا الذات لا تنفصل عن نقد أنظمة الهيمنة.
الذات إذاً ليست “أنا” مغلقة في حدودها، بل هي أفق مفتوح، ساحة صراع بين الذاكرة والنسيان، بين الحتمية والحرية، بين الانتماء إلى التاريخ والرغبة في تجاوزه. إنها سؤال متجدد يُعيدنا دائماً إلى جوهر الكينونة: كيف أكون ذاتي دون أن أفقد علاقتي بالآخر، وكيف أظلّ آخراً دون أن أذوب في الجماعة؟