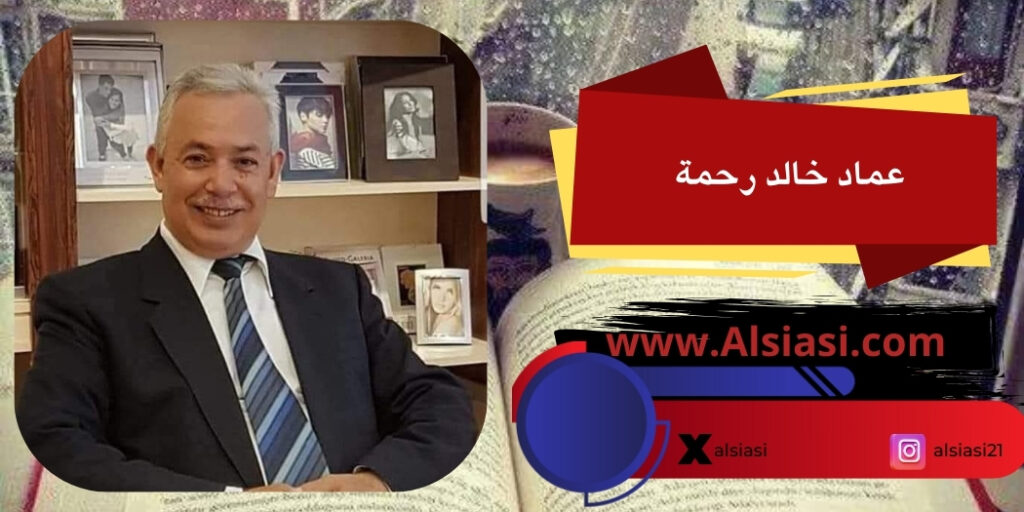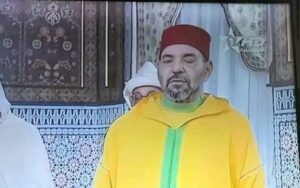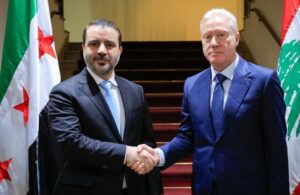يبدو أن الفكر الثقافي العربي التقليدي يقف اليوم على أرضية رخوة تتخللها منعطفات إشكالية خطيرة؛ تبدأ من أعراض الصدمة المعرفية الناتجة عن محنة الحوار المجهض مع الآخر، ولا تنتهي عند حدود عطالة السؤال الثقافي في قدرته على إنتاج عوامل حراكه الداخلي وخوض جدله التأويلي مع الواقع والتاريخ. فالمشهد الثقافي العربي، كما يكشفه هذا التوصيف، لا يعاني من غياب المعنى فحسب، بل من تعطّل جهازه الأنطولوجي في مواجهة قلق الوجود، وانسداد أفقه في التدوين التاريخي، بعدما استحال النص إلى أداة هيمنة أكثر منه إلى فضاء للحرية.
لقد تحوّلت النصوص ــ في كثير من القراءات الفقهية والإيديولوجية ــ إلى آلية تطهيرية ذات نزعة لاهوتية مغلقة، تمارس حضورها بوصفها “هبوطًا غير مقدس” على أرضٍ مثقلة بالعصاب الديني والتاريخ السراني للمدن. هذا التوصيف يعيدنا إلى ما أشار إليه محمد أركون حين حذّر من “القراءة الدوغمائية للنصوص” التي تحجب المعنى وتغلق باب الاجتهاد، بحيث تصبح النصوص سجناً للخيال بدلاً من أن تكون فضاءً لإعادة إنتاج المعنى. وفي هذا السياق، لم يعد الفكر الثقافي العربي الجديد سوى ضحية لتلك القراءة الإشكالية للتاريخ وتداول النصوص، إذ فقد بوصلة العقلانية، وخسر كثيراً من اطمئنانه إلى نمط قياسي في التعاطي مع مفاهيم الثورة والأهلية والحاكمية والمقدّس والمعيش.
إنّ مرحلة ما بعد الصدمة – صدمة الاستعمار، صدمة الحداثة، بل وصدمة العجز عن نقد الذات – لم تزل غائمة ومطمورة، لم يؤسَّس لها عقلٌ عربي سوسيولوجي-سياسي قادر على صياغة مقدمات وميكانزمات إجرائية وشرعية لبناء توافق بين البنى المعرفية والاجتماعية. لقد ظلّ المشهد محكوماً بآليات العنف الرمزي والطقوسية التي تحدث عنها بيير بورديو، حيث تتحوّل الهيمنة إلى نظام خفي يتسلّل عبر الطقوس والممارسات ليعيد إنتاج السيطرة لا عبر القوة المباشرة، بل عبر التطبيع الثقافي. وهو ما نشهده في الخطاب العربي المعاصر: إذ تتوارى الحقيقة خلف آليات رمزية تفرضها السلطة، فيخسر العقل الثقافي وقائع تجربته الحية عبر وهم إنتاج القوة والحكم.
من هنا، فإن الأزمة ليست أزمة وعي طارئة، بل أزمة بنية حضارية ممتدة، انكشفت مع فشل مشروع النهضة العربية في القرن التاسع عشر، ومع كل إخفاق لاحق في تأسيس عقل نقدي متجاوز. لقد نبّه محمد عابد الجابري إلى هذه المعضلة حين كشف عن “البنية التراثية للعقل العربي” التي ما زالت تهيمن على أنماط التفكير، وتعيق إمكانية القطع المعرفي الحقيقي. وما لم يتمكّن الفكر الثقافي العربي من إعادة مساءلة ذاته خارج هواجس التبرير والوصاية النصوصية، فسيظلّ أسيراً لإعادة إنتاج ذاته في دوائر مغلقة من الطقوسية الفكرية.
إنّ الفكر الثقافي العربي الراهن مطالب اليوم بما يمكن أن نسميه “تفكيكاً تأسيسياً”، على غرار ما اقترحه جاك دريدا في مشروعه التفكيكي، ولكن من داخل السياق العربي ذاته: أي إعادة مساءلة أنظمة الخطاب، وأشكال الهيمنة الرمزية، وعلاقات القوة التي تحكم النصوص والذاكرة والتاريخ. فالتأسيس لا يمكن أن يتم عبر استنساخ منجز الآخر، بل عبر تحرير العلاقة مع الذات أولاً، وفتح باب الحوار على قاعدة نقدية جديدة، لا على قاعدة العصاب الإيديولوجي.
بهذا المعنى، يقف العقل الثقافي العربي بين خيارين:
إمّا أن يظلّ سجين الطقوس والأنساق المغلقة، يراوح في عطالة السؤال، غارقاً في إعادة إنتاج أزماته،
وإمّا أن يدخل مغامرة التأسيس من جديد، عبر تحرير النص من فقهويته، وإعادة وصل الفكر العربي بحيوية السؤال الكوني الذي يجعل الثقافة فعلاً للوجود لا خطاباً للوصاية.
إنّ تجاوز المرحلة الغائمة لما بعد الصدمة لن يتم إلا بجرأة مواجهة الذات، وبناء عقل نقدي جدلي، يوازن بين التراث والمعاصرة، ويؤسس لحوار مع الآخر لا يقوم على التماهي أو الانبهار، بل على الندية والتفكيك والإبداع. فكما قال طه حسين ذات مرة: “التجديد الحق لا يكون في المظاهر، بل في طرائق التفكير.”