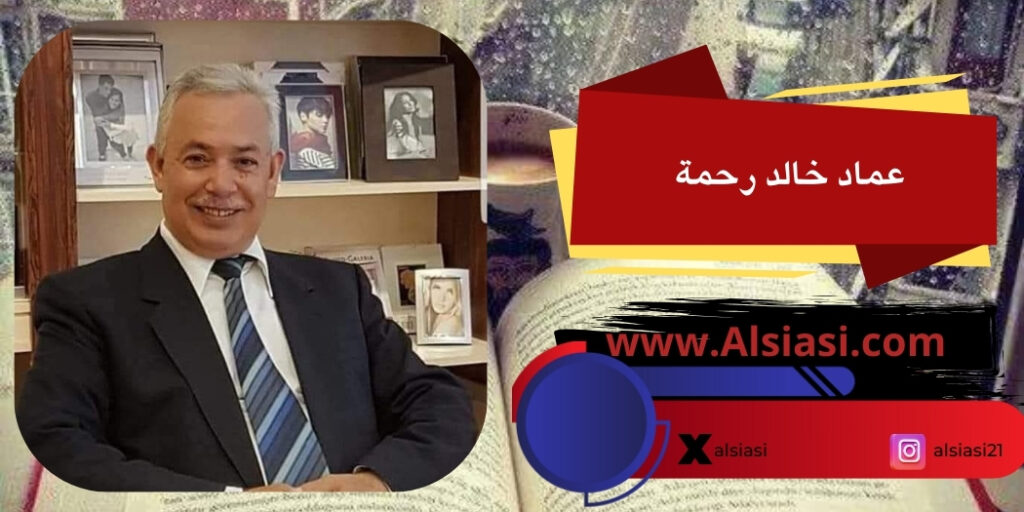في لحظةٍ تاريخيةٍ بدا فيها الوطن العربي كمن يطلّ على فجرٍ جديدٍ من النهوض والحرية، كانت جذور دولةٍ أخرى، خفيّةٍ ومترصّدة، تُعيد ترتيب المشهد من وراء الستار. هذه هي “الدولة العميقة”، ذلك الكيان السرطاني الذي يتغذّى على مؤسسات الدولة الرسمية، ويحوّلها إلى أدواتٍ لحماية مصالحه، لا لخدمة المواطن. لم تكن الثورات العربية في عمقها سوى صدامٍ بين إرادة الحياة لدى الشعوب، وبين شبكةٍ متجذّرةٍ من النفوذ السياسي والأمني والاقتصادي، أُحكم نسجها عبر عقودٍ من الاستبداد.
يصف نعوم تشومسكي هذا النوع من البنى بأنه “تحالفٌ غير معلنٍ بين السلطة والمال، يفرغ السياسة من معناها ويحوّل الدولة إلى شركةٍ كبرى لإدارة الامتيازات”. وهكذا وجدت الشعوب العربية نفسها، بعد عقودٍ من الاستبداد، أمام نسخةٍ جديدةٍ من القمع، تُمارس باسم الحرية. فالدولة العميقة لم تمت بسقوط أنظمتها، بل استعادت أنفاسها في فوضى ما بعد الربيع، متستّرةً هذه المرة بثياب الثورة المضادة أو الشعارات الوطنية أو حتى الخطاب الديني.
لقد أدركت الدولة العميقة، بذكاءٍ سياسيٍ خبيث، أنّ السيطرة لا تُمارس فقط من القصور الرئاسية، بل من مفاصل الدولة نفسها: القضاء، الجيش، الأجهزة الأمنية، الإعلام، الاقتصاد. إنها تعيش في “المؤسسات”، لا في “الوجوه”. ولذلك لم تسقط بسقوط الطغاة، لأنها كانت هي الطاغية الحقيقية. يقول أنطونيو غرامشي: “الهيمنة ليست في القوة فحسب، بل في القدرة على جعل الآخرين يعتقدون أن ما تريده هو ما يريدونه هم أيضًا”. ومن هنا مارست الدولة العميقة أقصى درجات الخداع: إذ حوّلت الثورات إلى مسرحٍ للدم، ثم ادّعت حراسة الوطن من الفوضى التي كانت هي صانعتها.
تغوّلها الاقتصادي كان الوجه الآخر لفسادها السياسي. فبعد أن انهارت الأنظمة التقليدية، تمدّدت شبكات المال والسلطة لتحتكر الموارد الوطنية، وتعيد توزيعها عبر منظومات المحسوبية والولاء. وهكذا تحوّلت الدولة إلى ما يشبه “الغنيمة الجماعية” التي يتقاسمها من تولّوا المناصب بعد الثورة، تحت شعاراتٍ براقة كالديمقراطية أو التعددية أو إعادة الإعمار. إنّ حنة أرندت كانت صادقة حين قالت: “الفساد هو أن يُدار الشأن العام بعقلية المصلحة الخاصة”. وفي هذا السياق، لم يعد الفساد انحرافاً في السلوك، بل منظومة حكمٍ موازية.
لقد أضعفت الدولة العميقة مفهوم الدولة ذاته، فاستبدلت شرعية القانون بشرعية القوة، وشرعية الشعب بشرعية الشبكة. صار المواطن غريباً في وطنه، محروماً من الأمن والعدالة والتمثيل الحقيقي، فيما تحكمه تحالفات أمنية واقتصادية تتقاسم المنافع مع الخارج، حتى مع القوى التي كانت تستعمره بالأمس. فالمستعمر القديم وجد في الدولة العميقة شريكاً موثوقاً، يضمن له استمرار نهب الموارد بغطاءٍ محلي.
إنّ أخطر ما فعله هذا الكيان المتوحّش أنه أفرغ فكرة “الدولة الوطنية” من مضمونها، فحوّلها إلى هيكلٍ مفرغ من المعنى. لم تعد الدولة كياناً سيادياً، بل واجهةً شكليةً لإدارة شبكةٍ معقّدة من المصالح. وبهذا المعنى، صارت الديمقراطية مشهداً تجميلياً يُدار من خلف الكواليس، كما لو أنّ الشعوب تمارس “وهم الاختيار”، بينما القرار الحقيقي يُصاغ في دهاليز المال والسلاح.
في هذا المشهد القاتم، تبدو مقولة جان بودريار ذات راهنية لافتة حين يقول: “نحن لا نعيش الحقيقة، بل نحيا محاكاتها”. فالدولة الحديثة في عالمنا العربي لم تعد حقيقة سياسية، بل نسخة مزيّفة من فكرة الدولة، يحكمها الوهم وتغذّيها المصالح.
لقد نجحت الدولة العميقة في أن تجعل من “الفساد” أسلوب حكم، ومن “النهب” نظام إدارة، ومن “الولاء” بديلاً عن الكفاءة. فهي لا تعيش على الإنتاج، بل على التهام ما ينتجه الآخرون. ومن هنا، فإنها ترى في كل إصلاحٍ تهديداً لوجودها، وفي كل وعيٍ خطرًا على ديمومتها. إنها ضد التعليم الحر، ضد الصحافة المستقلة، ضد العدالة النزيهة، وضد كلّ ما يجعل الإنسان قادراً على التفكير.
ولكن رغم سطوتها، ثمة ما لا تستطيع هذه البنية العميقة السيطرة عليه: الوعي. فحين يستيقظ العقل الجمعي، يسقط الخداع. ولعلّ ما يُقلق الدولة العميقة اليوم ليس الحركات الاحتجاجية ولا الصراعات المسلحة، بل هذا الوعي الجديد الذي بدأ يتشكّل في الضمائر، والذي يُدرك أن بناء الدولة لا يتم بإسقاط الوجوه، بل بهدم البنية الفاسدة التي أنتجتها.
وكما قال عبد الرحمن الكواكبي في طبائع الاستبداد: “الاستبداد ينهار حين تتعلّم الأمة كيف تُفكّر”. فكل دولةٍ عميقة، مهما بلغت من القوة، لا تصمد أمام شعبٍ يستعيد وعيه، لأن الوعي هو السلطة الوحيدة التي لا يمكن اغتيالها.
إنّ معركة التحرّر العربي اليوم لم تعد بين شعبٍ وطاغية، بل بين أمةٍ تحاول النهوض، وكيانٍ خفيّ يتقن فنّ البقاء في الظل. وبين النور والظلّ، لا بدّ أن يأتي وقتٌ ينجلي فيه الغبار، وتظهر الدولة الحقيقية: دولة العدالة، والكرامة، والعقل.
فمن لم يُدرك بعد أن أخطر أعداء الدولة هو “الدولة داخل الدولة”، فليستعد لأن يُحكم من حيث لا يدري.