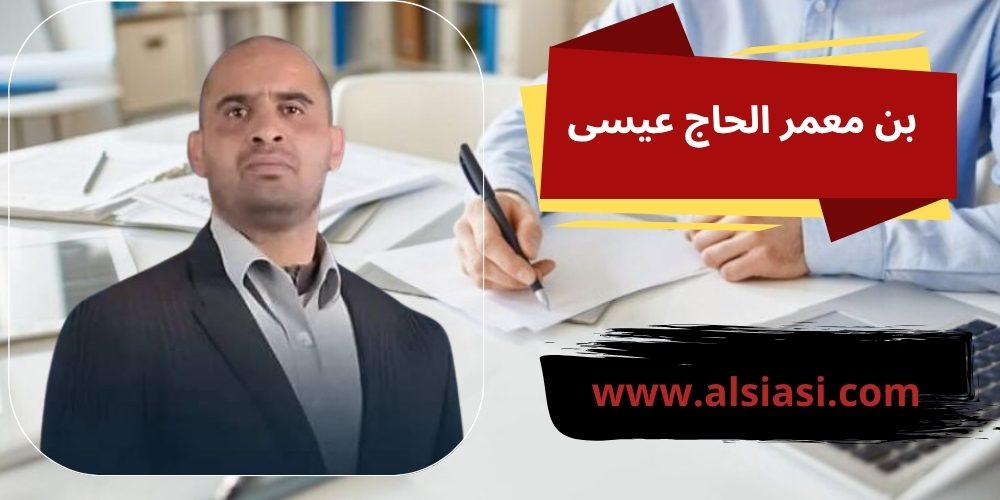منذ بدء العدوان على غزة في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، أصبحت مدينة الركام هي المشهد الثابت، والشعب الفلسطيني هو العنوان الوحيد المتغيّر في خريطة الألم. وما بعد وقف إطلاق النار ليست عودة إلى ما كان، بل دخول في فصل جديد من الصراع الخفي — صراع على السلطة، على الموارد، على النفوذ، على من يتولّى مهمة “إعمار الوطن” بصفته منقذًا أو بائعًا أو وصيًا. في هذا العالَم الجديد، لم تُعد الحرب فقط بنادق ودبابات، بل أصبحت الخطة الأمنية، التمويل، الإدارة، مقوّمات الحياة اليومية، حقوق الأرض، هي ساحة المعركة الفعلية. في هذا السياق، أُحاول أن أسقط لك صورةً بانورامية مركّبة، وربّما قاسية، لما ينتظر الشعب الفلسطيني من كلفة باهظة، وما تُخفيه كواليس “إعادة الإعمار” من صفقات مضمرة، تنازلات مفروضة، استثمارات مشروطّة، وتقسيم نفوذ داخلي وخارجي.
غزة — الركام، الأشلاء، الدمار — ليست عادلة أن تُقرأ كخسارة عابرة أو هزيمة عسكرية محضة، بل هي بداية مرحلة تعاد فيها كتابة فلسطين، ليس بدم الشهداء وحده، بل بكلفة سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية مدوّية. وفق تقارير الأمم المتحدة والهيئات الدولية، تقدر التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار في غزة ومناطق الضفة المتضررة بأكثر من 53.2 مليار دولار على مدى العقد المقبل، منها نحو 20 مليار دولار تُحتاج في السنوات الثلاث الأولى وحدها. وقدّرت الجهات المختصة أن الضرر في البنى التحتية فقط وصل إلى نحو 18.5 مليار دولار حتى أوائل 2024. وفي بعض التقديرات الأكثر تشاؤمًا، يُشير خبراء إلى أن المبلغ قد يصل إلى 80 مليار دولار عند احتساب التكاليف الخفية مثل فقدان الإنتاج، الإعاقة الاجتماعية، استنزاف الموارد البشرية، وتكاليف البيئة والبنى التحتية.
الدمار المادي هائل: أكثر من 370 ألف وحدة سكنية تضرّرت — بعضها دُمّر كليًا… تقريبًا 60 إلى 70٪ من المساكن في غزة تجاوزت حدود الإصلاح السطحي. يُضاف إلى ذلك: أكثر من 40 مليون طن من الأنقاض والركام يجب رفعها ومعالجتها — عملية قد تستغرق عقدًا ونصف العقد أو أكثر، بتكلفة قد تفوق نصف مليار دولار فقط لجهد التهيئة الأولية. وبحسب تقرير الأمم المتحدة، قد يستغرق إزالة الأنقاض فقط حتى 20 سنة في بعض المواقع إذا لم تتوفر الإمكانيات الكافية بوتيرة تسريعية.
هذا كله قبل أن نفتح باب “من سيُدير ما بعد الحرب؟” فالحرب توقّفت، لكن المعركة الأخرى — المعركة الإدارية والعقود والهيمنة — بدأت للتو. فمَن سيمتلك السلطة الفعلية؟ مَن سيمتلك القرار هو من سيحوز على قطعة الأرض، وقطعة النفوذ، وقطعة المال؟ السلطة الفلسطينية في الضفة تُحاول استعادة دورها في غزة، لكنها تواجه تحديات داخلية وإقليمية؛ حماس تُصر على أنها الضامن الأصلي للمقاومة وحاضنة الجماهير؛ والدول المانحة تُريد أن تشترط المساعدات بمراجعة أمنية، إشراف دولي، التزام بالحكم الرشيد، وربما التنسيق مع إسرائيل في بعض القطاعات.
إحدى السيناريوهات التي تُطرح في الأوساط السياسية تقول إن الإدارة الإقليمية والدول الكبرى سترفع يدها بشكل مباشر أو غير مباشر على الإدارة في القطاع: جزء بإشراف دولي، جزء بكوادر محلية تُشترط قبولًا من إسرائيل أو المجتمع الدولي، جزء تُترك لحماس أو فصائل مرتبطة بها لتطبيق ما يُسمّى “الأمن المحلي”. بهذا الشكل، تُباع السلطةُ قطعةً قطعة — قطعة لمن يقبل الشروط، قطعة لمن يطمح النفوذ، قطعة لمن يُفضّل “السلام المشروط”.
في مقابلات أجريت مع خبراء فلسطينيين مستقلين في الضفة وغزة، عبّر البعض عن خشيتهم من أن مشاريع “إعادة الإعمار” ستكون بوابة لتدخل غير مسبوق في الشأن الفلسطيني الداخلي، وأن التمويل سيُكمَّل بشروط “الشفافية” التي تُغدي التدخّل الخارجي، بحيث يُصبح القائمون على إعادة الإعمار هم من يختار من يُوظّف، من يوزّع المعونات، من يُقرّ الإنفاق، من يُحدد المشاريع. قال أحد المهندسين في غزة، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إنّ أول ما سيُطرح هو “من سيسلّم حسابات المشاريع، من سيراقب الصرف، من يوقع العقود، ومن يختار المقاولين” — وهي تفاصيل صغيرة تبدو تقنية، لكنها في جوهرها تتحوّل إلى عقد سياسي كبير.
من منظور اقتصادي، الوضع أكثر هشاشة: القطاع الخاص في غزة تقريبًا انهار تمامًا، ملايين العائلات بلا مصدر دخل منتظم، والنشاط الزراعي والصناعي تضرّر بشدة. نحو 86٪ من أراضي الزراعة في غزة تلفّت أو تأثرت بشكل جذري بسبب القصف والدمار، مما ألحق أضرارًا جسيمة بالأمن الغذائي ومستقبل الإنتاج الزراعي. البنية التحتية للمياه والصرف الصحي تأثّرت أيضًا بقوة: نحو 63٪ من محطات المياه والمرافق الصحية في القطاع تعرضت لأضرار كبيرة، والطاقة اللازمة لضخ المياه أو معالجة الصرف أصبحت شحيحًا، في ظل حصار مستمر وغياب الوقود.
ومع هذا كله، يبقى التشريد الداخلي والخارجي عاملًا معطِّلًا: أكثر من 1.9 مليون شخص نزحوا داخليًا، والعودة إلى الشمال بعد وقف إطلاق النار لم تُمكِّنهم من العثور على منازل صالحة للسكن، بل ركامًا وأراضي مدمّرة. وما يزيد الطين بلة، وتيرة الأضرار لا تتوقف — فتصعيدات عسكرية مؤقتة تأخذ بعض المناطق إلى دوائر اشتداد مؤقتة، تُعطّل الجهود المنهكة.
من الجهة الأمنية، لا يوجد فراغ بل صراع خفي: حماس تسعى إلى الاستمرار في لعب دور الحارس على غزة، محافظةً على مناعة سياسية في الشارع والغلاف، وتُريد أن تظهر باعتبارها القوة التي أحبطت الاحتلال، لكن إسرائيل ووسطاء دوليون يُصرّون أن لا يكون لحماس الدور المباشر في الإدارة المدنية في الخطوط الأساسية — ولا تُمنح الشرعية الرسمية دون شروط. حسب تقرير حديث من رويترز، السلطة الفلسطينية تقدّمت رسمياً بإعلان أنها تنوي امتلاك دور رئيسي في إدارة ما بعد الحرب في غزة، رغم أن الخطة الأمريكية المقترحة تُهمّشها أحيانًا. كما رفضت حماس وأطراف أخرى أي “وصاية أجنبية” على غزة، مُصرّة أن يكون كلُ إدارة القطاع فلسطينية بالكامل.
بمعنى أن ما بعد الحرب ليس تفكيكًا عسكريًا فحسب، بل إعادة بناء لسلطة حول من يملك “ملف غزة” — من ينفّذ المشاريع، من يختار المقوّمات الأمنية، من يوزّع المعونات، من يُوقع العقود، ومن يُقرّ السياسات. أي سلطةٍ تتمكّن من ضمان “الأمن المحلي” ستكون لديها اليد العليا في ما تبقى من القرار. وهنا يظهر الخطر: تُباع المكونات الحيوية للسيادة — الأمن، الموارد، الحوكمة المحلية، المشاريع الكبرى — كمقوّمات لا بد من منحه لمن يُوافَق عليه، أو حتى يُفتعل له ولاء.
وفي أحد التحليلات التي أعدّها معهد بروكينغز، يُشير الباحثون إلى أن إعادة الإعمار لا يمكن فصلها عن مسألة من يحكم غزة، وأن هناك علاقة تبادلية بين استقرار الوضع الأمني وصلاحية التنفيذ السياسي والتنظيمي. أي أن الجهة التي تستطيع أن تؤمِّن شرطة، حصار حدودي، أمن معابر، قد تُمنح صلاحيات تنفيذية أكبر لإعادة البناء، بل قد تُصبح السلطة المدنية الأقوى بحكم الواقع.
على صعيد المعيشة، المواطن الفلسطيني في قطاع غزة داخله الآن على باب مفترق: سيُعرض عليه “الحماية مقابل التنازل”، و“الاحتواء مقابل التبعية”، و“العيش مقابل القبول بالمراقبة”. ماذا يعني هذا؟ يعني أن من يُوفّر المياه والكهرباء والاستقرار الأمني يُعتبر أنقذًا، قد يُمنح امتيازات تنفيذية، قد يُوظّف أطرافًا موالية، قد يُحقّق نفوذًا على مشاريع الإسكان والتعليم والصحة. وهنا يصبح المواطن سلعة، يُباع له الأمن والمعيشة مقابل التنازل عن بعض الحقوق، أو قبول سلطات مشروطة، أو التزام شروط دولية أو إقليمية.
في هذا السياق، يقول أحد الناشطين الاجتماعيين في الضفة، مطّلع على ما يُخطط لغزة: “قد لا يُطرح على الناس خيار رفض العقد؛ فحين تُقدّم لهم الخبز والماء والأمان، يُصبح السؤال ليس هل أوافق؟ بل كم على أن أدفع مقابل كل قطعة من هذا الأمان؟” — وهي رؤية تخترق العلاقة بين المواطن والدولة كعلاقة تجارية مفروضة، حيث يُبتاع جزء من الكرامة مقابل جزء من الحياة.
لكن ليس كل شيء يُباع بسهولة: هناك مقاومات — فصائلٌ صغيرة، حركات مدنية، شباب يقاومون العقود المشبوهة، منظمات تُراقب الأداء المالي، جهات تُطالب بالمساءلة الوطنية والإقليمية. من المحلل الأمني إلى الخبير القانوني، يُحمّلون الجهات المانحة والمخططين مسؤولية عدم فرض وصاية مشوّهة. يقول خبير قانوني في رام الله إن أي صفقة إعادة إعمار تُعرض على الفلسطينيين يجب أن تمر عبر آليات شفافة وطنية — لا أن تُمرر في أروقة المانحين أو الكواليس الدولية. وإذا لم تفعل ذلك، فإنها لن تكون مشاريع إعمار، بل مشاريع استيطان سياسي بغطاء إنساني.
إذا لم تتوحد الجبهة الفلسطينية، إذا لم تفرض شروطًا قوية على عملية الإعمار، وإذا لم تُحفظ الكرامة الوطنية في مبدأ “القرار الفلسطيني المُستقل”، فإن الأسوأ ليس الحرب في حدّ ذاتها، بل ما تتركه من نسخة مشوّهة من الوطن، حيث يُباع القرار، تُقسم النفوذ، يُقوَّض جوهر السيادة، ويُسلم الحقوق إلى قوى خارجية أو مشروطة. في النهاية، الشعب هو من سيدفع الثمن — ليس فقط بقذائف الاحتلال، بل بثمن ما بعد الحرب: أي قطعة من الوطن يُمنح لمن، بأي شروط، مقابل أي التزام، ولأي أسباب.